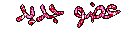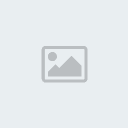نحو فهم شرط الوجود:
عندما أقرأ كتاباً ما إنما يدفعني لذلك مدى ما سمعت من حديث الناس بين مؤيد ومعارض للأفكار التي يعرضها، وككثير مثلي أحاول أن أستوضح من نفسي التشارك والتنافر في المقولات التي يسوقها الكاتب مبعداً عن ذهني أي تصور مسبق عن الكاتب وعن حياته وأخلاقه وعلومه.
عنوان الكتاب الذي أنا بصدده هو "وهم الإله" ويكشف منذ فصوله الأولى عن غايته التي بدت وكأن الكاتب خصص مؤلفه ليتوجه به قبلياً لقراءٍ لا يؤمنون بالإله أصلاً، وذلك بغية تقوية إيمانهم الخاص ذلك وتدعيمه بحجج علمية بحيث يصبحون أكثر قدرةً على محاورة المؤمنين وكسر حججهم الإيمانية.
وأول ملاحظةٍ أسجلها على الكتاب أنه امتلأ بالحجج التي تناقش المفاهيم الدينية عن الإله، وهي مجموعات من المفاهيم تقترب وتختلف مع إختلاف دين عن آخر وتباين مذهب عن آخر، وما تعدد هذه الأديان والمذاهب وخصوصية عقائدهم في الإله إلّا البرهان على أن أغلب هذه العقائد هي في ظاهرها غير صحيحة ومشوشة ومشوهة، وهذه الحجة كانت أكثر من كافية ليضحد فيها أدياناً قائمة، ولكن هل يكفي أن أُبطل مجموعةً من الأديان لكي أستنتج بطلان الإله؟
مع أن الكاتب قد خصص الفصل الرابع من كتابه ليوضح فكرةً مستقاة من العلوم ومستقلةً عن نقد الأديان بحيث يصل منها إلى وهم الإله حسب ما رأى! إلّا أن ما كتبه عن وهم الأديان أكثر بكثير مما كتبه عن وهم الإله.
هذا عدا أن فهمه للأديان كما أورده يستند إلى آراء وتصرفات بعض رجال الدين ولا يستند إلى دراسة الأديان نفسها دراسةً جدِّيةً تنفذ إلى حقائقها. وأنا هنا أشير إلى أنه يوجد تباين كبير بين مفاهيم الأديان من حيث هي رسالات وكتب وبين مفاهيم رجال الدين الذي صادروا معاني الكتب واستغلوا نفوذاً مصطنعاً فألحقوا بهم عوام الناس الكثر. وهذا أمرٌ تنبأت به أمهات الكتب الدينية من جميع الحضارات والثقافات.
فإن أخذ الباحث بالآراء الأكثر إنتشاراً لن يقع على الحقيقة الكامنة في الكتب والتي لا يستطيع أن يمسها إلّا قلّةٌ من العلماء. أقول أنني أشير لهذا ولكن لن تكون هذه الرسالة مكاناً لنقد الأديان وتبيان حقائقها فهذا أمرٌ جدُّ مختلف. أما هنا فأنا بصدد ما يخص عنوان الكتاب وموضوعه الأساس فقط.
ولأعد الآن إلى قول الكاتب أنه لا يهاجم إلهاً خاصأ بدين ما أو فلسفة معينة بل هو يستهدف الله كمفهوم محدد، وهو قد حدد هذا المفهوم بأنه "يوجد هناك قدرة متوحدة خارقة للقدرات تعمدت خلق الكون وكل شيء فيه بما فيه نحن". والحقيقةً أنني لم أفهم هذا المفهوم لكي أعرف ما الذي يستهدفه الكاتب!
ماذا يعني قدرة متوحدة؟ أيعني أنها كانت أجزاءً ثم توحدت؟ ولكنني لم أعثر حتى على أي مفهوم إلهي على هذا النحو في أيٍّ من الأديان أو الفلسفات أو حتى ضمن آراء ومفاهيم رجال الدين! أو تكون الكلمة فقط خطأ في الترجمة؟ قد يكون! ولكي أحسن النية قدر ما يمكنني سأقول أن الكاتب كان يقصد "قدرة واحدة".
ولكن ما معنى خارقة للقدرات؟ وما هي هذه القدرات الأخرى لكي يخرقها، إن كان يقصد مفهوم بعض الديانات عن أنه يوجد أرباب متعددون، ففي هذه الحالة هذا المفهوم المحدد ليس عاماً لله كما كنا نتوقع من إنسان عالم، وإنما هو ما يزال حبيس حلقة ضيقة من مفاهيم ملتبسة.
وأيضاً لا أرى أن جملة "وكل شيء فيه بما فيه نحن" لها أيُّ معنى فالواضح أن الكون هو كل شيء ولم أقرأ قبل الآن لأيٍّ من الدينييين أو المفكرين ما يعتبر أن الكون وعاء للأشياء وهو في هذا المعنى الأخير إن وُجِدَ عند أحدهم يصبح كوناً غامضاً يحتاج للتفسير والفهم قبل البدء بالبحث عن الله.
وعليه أقول أن المفهوم عن الله الذي يهاجمه الكاتب هو بدايةً غير مفهوم وكان الأحرى به أن يحدده بدقةٍ أكبر وبدون حتى إستخدام لكلمة "هناك"، كالآتي: "توجد قدرةٌ واحدة تعمدت خلق الكون"، ها قد بسطنا المفهوم قدر ما نستطيع كي يتضح لنا بمعناه.
وبعد هل هو يكفي لنقول أن هذا المفهوم يعبر فعلاً عن الإله؟ ولكن أين هي قوامته على الكون؟ فكل الأديان كذلك الفلسفات المتديّنة عبّرت أن الإله قائمٌ على تدبير الكون ولا أفهم لما تمَّ إسقاط هذا في التعريف المقترح، على كل حال لنحسن النيّة أيضاً ونحاول ترميم هذا التعريف بأن نقول " توجد قدرةٌ واحدة تعمدت خلق الكون وهي قائمةٌ على أمره". والآن هل أصبح التعريف واضحاً؟ في الحقيقة أنني ما زلت أرى أنه بحاجة للتوضيح أكثر، لأنني لا أرى خلق الكون إلّا من حيث قوامة الإله عليه، وأيضاً كلهم أجمعوا أن الله أزلي ومن ثم فليس من خلقٍ أول لم يكن قبله أيُّ خلق، وإنما نفهم وصف الخلق كما أتى في الكتب المقدسة ورسائل الفلاسفة أنه وصف للتراتبية الوجودية ولم يكن يعبر عن تراتبيةً زمنيةً.
وعليه فإن جملة "تعمدت خلق الكون" ستكون تعميةً لا معنى لها إن تم أخذها أنه حدثٌ قد حدث في الماضي الزمني ولم يكن مسبوقاً، كما أن كلمة "تعمدت" نفسها أيضاً ليس لها محل فهم لا يقولون "الله يتعمد" بل "الله يريد" أو "الله أراد" بصيغة الماضي فقط للدلالة على أزلية الله (أيضاً يمكن أن يكون خطأً من المترجم) أو تقول "الله يشاء" أو "الله شاء".
وقد يقول قائل: وما الفرق بين هذه الأفعال "تعمد، أراد وشاء" ؟ وهل القضية هي قضية لعب بالكلمات؟ لا ليس هذا ولكن أيضاً ليست الكلمات لتعطي نفس المعنى، فإذا ما فهمنا مدلولاتها سوف يتبين الفرق واضحاً وجلياً.
أما الإرادة فقد عنت الإرادة الأزلية لله، ومن مدلولها نفهم أنها لا تحول ولا تغيير فيها وهي ليست في نطاقٍ ما غير ما هي عليه في أي نطاقٍ آخر، فإذن هي القانون الإلهي وهي الحقُّ كاملاً وتاماً لا يتحوّل ولا يتبدّل.
وأما المشيئة الإلهية فقد قصدوا بها ما يكون من التبدل والتحول الدائم للخلق بموجب الإرادة الإلهية، ففي كل لحظة يتغير الكون ليكون في وضع مختلف، فيقولون أن الله شاء أن يصير الكون إلى ما صار إليه.
وأما التعمد فما هو مدلوله؟ هل يصح أن نقول أن "الله تعمّد"؟ وماذا يمكن أن يكون معناها ما دامت إرادته كاملة وثابتة وهي هي في كل نطاقٍ وكل مكان وكل زمان، وبموجبها يتحرك الكون ليصير في كل لحظة ما يجب أن يكون عليه؟.
وبعد، ربما يأتي من يقول "قد سئمت هذا العرض اللغوي و لتنبأنا الآن هل تعتقد أن الله أو إرادته وإن شئت أيضاً مشيئته يعون ما يفعلون؟ ألم يكن واضحاً أن الكاتب إستخدم كلمة "تعمّد" فقط لأنه يتصدى لمقولة أنه يوجد إله واعٍ لما يفعل، فإن كنت ستقول أن الله لا يعي ما يفعل بإعتراضك على معنى التعمّد، فمن الواضح أنك تتكلم فقط عن الطبيعة والقانون الطبيعي أو الكون والقانون الكوني، وأنت تسميهم الإله والقانون الإلهي، وأخيراً تكون كمن فسّر الماءَ بعد جهدٍ بالماءِ".
وأرد على ذلك أنني شخصياً أعتقد بالله العارف ولا شك عندي في هذا أبداً، وأتحفظ على إستخدام كلمة "وعي" في هذا الموضع، وأؤجل الكلام عن الفرق بين المعرفة من جهة وبين الوعي من جهة أخرى إلى موضع متأخر ضمن هذه الرسالة.
وأخيراً أجد أن التعريف المحدد للإله والذي ينبغي أن يتصدى له الكاتب هو:
"توجد قدرةٌ واحدةٌ وعارفةٌ وقائمةٌ على خلق الكون".
في مقابل هذا التحديد للإله، يقول الكاتب أنه سيثبت ما يلي: "أي قدرات على الخلق بتعقيد كاف لتصميم أي شيء لا تأتي إلّا كنتيجة تراكم تدريجي طويل الأمد لعملية تطورية" وهو بهذه المقولة يريد أن يقول أنه إذا أثبتها فإن مفهوم الإله يكون زائداً وليس من داع لإضافته في قصة الخلق.
ويتضح معنى المقولة بأنها تربط بين الخلق المعقّد (التصاميم حسب تعبير الكاتب) عبر عمليات طبيعية طويلة زمنياً وبين التأكّد أنه لا يوجد من كان يعرف أين ستؤدي هذه العمليات، أو بتعبير آخر هو يقول أنه لا يوجد من كان يقصد وينوي خلق الكون لنقل كما نعرفه الآن!
وعند هذه المرحلة، يجب أن أُذكّر أن الإنسان عندما بحث عن إله فإنما هو كان يبحث عن سببه هو نفسه وإنطلاقاً من إيمانه إبتداءً بنفسه، والبحث هذا إنما إنطلق من وعيه بوجوده وليس من وعيه بجسده وتعقيد تصميمه، فإن كنا الآن لا نرى فرقاً بين الوعيين فهذا قفزٌ فوق المشكلة الوجودية وليس إجابةً عليها.
وقد واكبت المؤلف في عرضه للداروينية بحثاً بين سطوره عن أيِّ تحليلٍ أو إضاءةٍ على مسألة وعي الإنسان فلم أجد ما أبحث عنه ولو طرفاً في الحديث، وتبقى الأسئلة الرئيسية التي يطرحها كلُّ فردٍ على نفسه غير مجابٍ عليها أي "من أنا؟ وكيف يجب أن تكون علاقتي مع سبب وجودي؟" فالداروينية وإن صحّت (فأنا لست عالماً بالبيولوجيا ولا الأنثروبولوجيا، وإنما نترك هذه العلوم لأصحابها ونحن ممتنون لهم ولجهدهم) على ما يبدو لا تجيب عن هذه الأسئلة وهي حتى لا تريح النفس في سعيها، وهذا ليس لعيبٍ في هذه العلوم ولكن العيب يقع في تحميل النتائج شططاً لا يعتمد إلّا على الظنون المسبقة.
في الفصل الثالث من الكتاب يفند المؤلف الحجج التي أُقيمت للبرهنة عن وجود الإله، وقد رافقته فعلاً من واحدة إلى أخرى، والواقع وكما قال أنه فعلاً من الخطأ أن نبحث عن برهان بمعنى البرهان الرياضي أو الإستدلالي فكيف إذن بالبراهين الإيمانية والإحصائية وهذه الأخيرة تكاد تكون الأكثر طرافةً، إن هذه الحجج حتى لا ترقى إلى مستوى الحقيقة الخاصة بنا نحن، أي لا تستطيع أن تصف حقيقة وجودنا نحن فهل ستستطيع أن تدلنا على الله؟
ما أفادني به الفصل الرابع خاصةً والفصول التي تلته هو أنني أصبحت مطلعاً تماماً على رأي الملحد الذي سيقول لي: "أنت لا تزال تبحث عن نفسك ولم تعرف بعد ما هو تفسير منشأك، ومن ثم تأتي لتناقش في وجود الإله، أنت جسدٌ بثّت الطبيعة اللاواعية فيه وعياً!"، وما يتبين لي أنه بهذا التصريح لن يكون بعيداً عما يتصوره المتدين المتوهم فالفريقان في هذا الأمر سيان، ولو أن التعبيرالبنيوي للأنا سيكون مغايراً من أحدهم للآخر!، فالمتدين أيضاً يقول لي "أنت جسدٌ بثّ الله فيه روحاً"، وهم يظنون فعلاً أنهم راضون عما وصلت معرفتهم عن أنفسهم وأن هذا يكفي وأنهم مستعدون لخوض الجدل في وجود الإله أو عدم وجوده، لهذا السبب سوف أختصر وأدخل مباشرة في ما أريد قوله في شكله النهائي.
إن قول المتديّن "أنت جسدٌ بثّ الله فيه روحاً" وكما يشرحه، يبرِّد القليل من النار التي تستعر في صدورنا ولكنه ليس كافياً للتيقن ويبقى الشكُّ الزائر الطارئ حتى عند أشدِّ الناس إيماناً، والذي ينتصر على شكِّه في الوجود الإلهي يدخل في شرك الشك عن مصيره وهذا طبيعي لأنه لم يعرف نفسه.
أما قول الملحد ""أنت جسدٌ بثّت الطبيعة اللاواعية فيه وعياً" ففي الواقع يحمل من الغموض الكثير مما لا تتحمله أذهاننا، ولكي لا أطيل أقول له مجدداً: "من أنا؟"، سيقول لي "أنت لست الجسد كله، لا تفهمنا خطأً، أنت بعض الخلايا الرمادية أو خلافها فاللون لا يهمنا هنا"، نعم اللون لا يهمنا هنا وربما أيضاً أين تأخذ هذه الخلايا المركزية مكانها من الدماغ البشري أيضاً أمرٌ غير مهم في هذا النقاش، ولكن السؤال لماذا هذه الخلايا والمتجددة بشكل دائم بضرورة الكيمياء الحيوية هي بذاتها تُحِسُّ؟
وهذه الخلايا هي في النتيجة تجمع عضوي لتنوع من المادة والطاقة وهما حسب الفيزياء التي بتنا نعرفها وجهان لعملة واحدة. قد إختصرت كل مظاهر الوعي بكلمة الإحساس وأؤكد أنني لا أنوي إختزال ما نسميه الإدراك العقلي والتخيل والتذكر وحتى التفكير وغيرها من أنشطة الوعي، ولكن فقط لتبسيط الفكرة.
سيقول لي العالم الملحد "أنت ما زلت تسأل؟ خذ هذا المثل: عندما تعي أنك ترى دائرةً فهذا ليس إلّا إحساساً بصرياً مناسباً لنموذجٍ ركِّبَه دماغك أو الجزء المختص بهذا من دماغك، وحتى عندما تقول أنك تشعر بالحب أو بالجوع أو بطعم تفاحة أو تشم رائحة عطر أو تفكر حتى، فإن هذا كله عبارة عن حالات يعيشها الدماغ من حيث المواد والطاقات التي تتغير لتعطيك هذا الإحساس أو غيره."
هذا يبين أننا تقاربنا بخطوةٍ مهمة، ولكي أدفع هذا التقارب أكثر سأطرح السؤال التالي: "لو أن كل ما قاله العالم الملحد حصل وأنا أصدقه في واقع الأمر وهذا من قبل أن أتعرف على الداروينية، أي لو أن كل الإستشعارات الخارجية المتلقاة عبر الجسد وكذلك العمليات الحيوية التي تحصل في الدماغ والجسد كله عملت وفق مقتضاها الطبيعي وهذا صحيح تماماً حسب ما نعرفه، ما الذي يجعل الإحساس ضروريَّ الوجود لتفسير هذه الظواهر؟ أما كان يمكن لهذا الجسد أن يقوم بكل ما يقوم به من الإستشعارات وكل عمليات التفكير والتخيل والتذكر وما إليه وذلك بدون أن توجد جهةٌ ما تعي كل هذا؟ ألسنا نعرف ان هذا الجسد وما فيه إنما هو جزءٌ من الطبيعة وهو من مادة ويخضع أولاً وأخيراً للفعل الفيزيائي؟ لما وجب على جهةٍ ما أن تعيش هذه التفاعلات الطبيعية أحاسيساً؟
ربما سيقول أن المادة عندما تتحد بشكل معقد لتعطي ما يكاد يشبه التصميم الذكي تصبح ذات وعي، وربما سيبرهن العلم في المستقبل عن أن عنصراً أو أكثر من المادة هو ذو وعي، أي أنه ذات، وأن المادة تكشف عن وعيها وذاتيتها حالما تستقبل الإشارات الفيزيائية المناسبة، إن كان هذا جوابه فالقضية تنتهي هنا، طبعاً نحن لا نؤمن بمادة واعية ولكن إعترافه هذا على خطأه يناقض كل الطرح الإلحادي برمته.
لماذا لا نؤمن بمادة واعية؟ بكل بساطة لأن المادة لا تفتأ تتغير، ولا تستقر على حال فمن أين يكون لها الوحدة، الوحدة للمادة لا تنوجد إلا على مستوى الكون كاملاً أو على الأجزاء التي لا تتجزأ منها أي المكونات الأولية، فمن أين لمجموعة أجزاء أي يكون لها الوحدة، ومن ثم كيف لها أن تكون صاحبة ذات محسّة؟
أعود الآن لمناقشة الفكرة بجديّةً أكبر، فبغض النظر عن دراسة من ينشأ أولاً المادة أم الوعي، يجب أن نثبت أن وعينا بالوعي ذاته يسبق وعينا بالمادة وإذن فالثابت عندنا هو الوعي، إن أبطلناه نكون قد أبطلنا أي شيء يأتينا عبره.
كما أن كل ما يمكن أن نعرفه عن الطبيعة هو فقط صورة عنها مرسومة بالأحاسيس التي نستطيع كوعي أن ندركها، لكي أفسر أكثر أقول: عندما تلتقط حاسة البصر في جسدنا صورة قرصٍ دائريٍ لونه أحمر عندما يكون معرضاً لنور الشمس، لا يعني ذلك أننا إذا شرّحنا الدماغ في هذه اللحظة فسوف نجد فيه شكل القرص تماماً وأيضاً بلون أحمر بحيث أن تفترضوا وجود صبغات في الخلايا الدماغية.
لكن الأمر أن إبصار اللون سيمثُل بطريقةٍ كيميوحيوية بناءً على مقدار تأثير الذبذبة الحاملة للون كما وللأبعاد الأخرى، الوعي فقط هو من يرى صوراً.
أيضاً التأثير الذي سيعقب هذا الإبصار سوف يحدث في خلايا الدماغ كإستحضار ذاكرة ما أو إنفعال ما أو أي تأثر وسيكون هذا التأثر مبنياً على الوظائف الراقية التي تتمتع بها الوحدات الدماغية المختلفة ولكن لن تجدوا هناك أيَّ مبرر لتكون هذه العمليات مرئية فعلاً كوعي لأيِّ ذاتٍ كانت!
وإن كنتم تعتقدون عكس ذلك، مثلاً أن يكون إحساسٌ ما منظوراً إليه من خارج كيميوحيوية الجسد ومن محيطه المادي يستطيع أن يتدخل في هذه العمليات نفسها ويحرفها عن مسارها الحتمي، يكون حينئذ قد قذفنا العلم كلّه في أيدي جنّيّين يدفع السعي لبرهان وجودهم أو عدمه قروناً من الجدل العقيم.
ويقول قائل: "أنت قلت أن وعيك مسلَّمٌ به فلم تطلب الآن البرهان؟" أقول نعم إنّ وعيي مسلَّمٌ به، ولكن تدخلَ وعيي في الواقع الفيزيائي ليس صحيحاً وليس مبرراً! ولا يمكن للإحساس من منظور أنه وعي أن يزيد أو ينقص أو يحرك أو يحول ما حدث في الطبيعة ولو لموضع إلكترون واحد!
وعلى هذا أقول أن العلم الفيزيائي لن يجد لهذا برهاناً ولن يستطيع أن يفسر لنا سبب وعينا ومصدر ذواتنا، لن يستطيع أن يجيبنا عن السؤال "من نحن"؟ ومن الذي اتى بنا إلى ما نحن عليه؟
والآن لنفند الردود المحتملة هنا، فقد يعود البعض ليقول بكل بساطةٍ "نعم ما تقوله صحيح وهذا الوعي لا يعني شيئاً، ونحن نستطيع فعلاً أن نفسر كل الظواهر الحيوية عن طريق متابعة الصيرورة الفيزيائية، وربما سيصل العلم فيما بعد إلى ماهيته ونحن لا ندري عنه شيئاً اليوم!" ونحن نرى أن هذا القول إنْ صدر يؤيّد ما ذهبنا إليه وما سنعالجه لاحقاً بعد هذا التفنيد.
وقد يقول البعض أن المادة والوعي عالمان متوازيان يسيران مع بعضهما بتوافقٍ كامل، وأن هذا الوعي إنما يظهر حسب توضُّع المادة في الوحدات الطبيعية فيكون بسيطاً في الذرة كمثل ما تمثل الذرة وفي الجزيئة كمثل ما تمثله وهكذا في الكائن ذي الخلية الواحدة والفيروسات ويبدأ الوعي بالتعقد مع تعقد النظام المركّب طبيعياً وصولاً للإنسان، وبالتالي فكما تطورت الكائنات الحية تدريجياً حسب نموذج الإنتخاب الطبيعي فكذلك تطور وعيها تدريجياً بما يناسب. وهذا المذهب في الحقيقة ليس جديداً فقد قال الحكماء القدماء أن كلَّ شيئٍ في هذا الكون منفوسٌ، بمعنى أنَّ له نفساً يتمثّل فيها وتعبيرهم هذا عن النفس ليس إلّا تعبيراً عن الوعي، وتسميته بالنفس ليست تسمية صدفة وإنما عنت أنها هي باطن الواقع الفيزيائي ويكون هو ظاهرها، صورتان متساويتان ومختلفتان في آنٍ معاً، متساويتان من منظور أن الوعي يعيش صورة المادة بالتقاطه إياها كمعاني، ومختلفتان من منظور أن المادة لا تحوي بذاتها على هذه المعاني كما أن صيرورتها لا تتأثر بها، فلنقل إذن أن النفس تلبس حالة المادة مسكوبةً في المعاني أو ما سماه الحكماء المُثل.
هل هذه المثل هي نفسها ما سماه كاتب "وهم الإله" بالنماذج التي يبنيها الدماغ البشري؟، فلندرس الآن أين ينتهي عمل الدماغ.
إن ما نعرفه بالعلم كما ذكرنا أعلاه أن الدماغ يستقبل الإشارات ومن المؤكد أن نمذجة هذا الإلتقاط سوف يشكّل فعلاً وحدة معلومات لتوصيف هذا الجزء من الواقع الذي ألقى ذبذباته على الإنسان الملتقط. ولنفترض أن الدماغ بعد تشكيل هذا النموذج ساقه إلى منطقة مركزية ما فيه، فإذا ما افترضنا أن هذه المنطقة هي ذات وعي خاص بها أو أن الوعي ليس مادياً البتة ولكنه يعيش حالة هذه المنطقة المركزية ويلبسها فالأمر سيان، وما يصح في الحديث عن تلك الحالة يصح أيضاً على الحالة الثانية.
هذه المنطقة أخيراً ليس فيها إلّا مواد كيميائية حيوية وأيضاً الكثير من الإشارات الكهربية العصبية التي تتنقل وتخزن وتعالج ضمن المادة، وبالتالي تخضع للقوانين الطبيعية الحتمية وهذا آخر عمل الدماغ. فرائحة الورد وطعم التفاح واللون الأزرق وإلخ... سوف تتواجد في الدماغ على شكل نماذج كهربية بذبذبات وإتجاهات وقوى متباينة. الدماغ يوفر هكذا نماذج وحتى المعقدة منها لتمثيل الأشياء المركبة مثل التفكير والشعور العاطفي وإلخ... ولكنني متأكد أنكم لو قرّبْتم أنوفكم من دماغ رجل يشم وردة عابقة لن تشموا شيئاً في هذا الدماغ، لأن إحساس شم رائحة الوردة هو موجود في ذاته، حتى الإنسان لا يستطيع أن ينقل هذا الإحساس بحقيقته إلى غيره أو حتى أن يصفه على الورق، هو يستطيع أن يقول أنها رائحة جميلة مثل رائحة الورد ليس إلّا، فمن يسمعه وكان قد شمَّ الورد سابقاً يستحضر دماغه الإشارات (النموذج الخاص بها حسب ذكرياته) ويوصلها إلى المنطقة المركزية ولكن ليس من المدخل المخصص للحواس وإنما من الذاكرة لهذا تصبح عملية إستحضار الرائحة من جديد فكرةً في الوعي وليس إحساساً وهذا أقصى ما يستطيعه الدماغ. ومن يسمعه ولم يكن قد شم وردةً سابقاً فببساطة لن يحس بأي شيئ سوى أن رائحةً ما قد تم شمها من قبل صاحبه.
الدماغ يركب النماذج نعم هذا واضح، ولكن لو إطلعتم على هذه النماذج لن تروا فيها أحاسيسكم كما تحسونها، وما قصده الحكماء عن المثل فهي عالم المعاني التي في ذاتها وهي المعاني التي يتركب منها وعي الإنسان بالتوازي مع النماذج التي يشكلها الدماغ، هي الروائح كما نشمها وعناصر الصور كما نراها وعناصر الأصوات كما نسمعها وإلخ...إنما أردت أن أذكر هذا فقط للتأكيد على أن ما فهمه د. ريتشارد عن درجة تطور الدماغ بما يكفيه لتركيب النماذج صحيح وواقعي، ولكن لا يفسر لي لماذا يجب عليَّ أن أشم وأسمع وأرى وأفكر وببساطة مجملة أن أحيا ما دامت فيزياء الجسد كافيةً لتفسير كل الأنشطة البسيطة والمعقدة التي يقوم بها.
وأعود للنقطة التي قد تستثار من قبل البعض بعد كل ما أوردته أعلاه، فيقول أحدهم:"أنت إذن تنفي معنى حريتنا وقدرتنا على الإختيار! وهذا شيءٌ أيضاً واقعي ونحس به تماماً كما نرى ونسمع!"، أقول من جديد الجسد بكل حيثياته هو مادي وفيزيائي وهو جزءٌ من الكون المادي ومن يدرك هذه الحقيقة يعرف أنه لا يوجد معنى لكلمة حرية وإختيار مهما كان إحساسك بهذه الحرية قوياً، أؤكد على ذلك من منظورنا لأنفسنا كأجساد، والشعور بالتدبر والحرية والإختيار ما هي إلّا إلتقاطٌ مباشر لعمليات معقدة جداً ومدفوعة بأسباب خارجة عن وعينا وتنتمي إلى العالم الفيزيائي ولكن هذا كله كما رائحة الورد نلتقطه عبر المثل وهذه المثل هي التي تعطينا الشعور النهائي الذي نحياه، نعم لولا مدنا بهذه المثل ونستطيع أن نسميها بحق الحياة ولمن شاء أيضاً الروح وأيضاً بعضهم أسماها الوجود، أقول لولا ربطنا بهذه الروح لعملت الأجساد كل ما تفعله كما تعرفونه الآن ولبنت الحضارات وأعقد التقنيات ونظمت العلاقات والبنى الإجتماعية والسياسية والفنية والرياضية والثقافية وكل شيءٍ دون أن يعيها أحد.
قد يقول أحدهم "ها أنت تنكر الإله بقولك هذا دون أن تدري فأنت تنكر من يعي هذه الدنيا إن لم يوجد البشر! سأرد أن لا يا سيدي أنا أدري ما أقول وأفهم ما ذهبت إليه ولم يختلط الأمر عليَّ بعد. ولنأت الآن بعد كل ما تقدّم لنتعرف على أنفسنا أكثر: الجسد يستطيع أن يوجد وأن يقوم بكل ما يقوم به دون أن نعيه نحن وهذا تضمنه له الطبيعة الفيزيائية المادية، ونحن عندما نعي ونحيا حالة الجسد إنما وجودنا هذا شيءٌ زائدٌ، بمعنى آخر هو فيضٌ بما تعنيه هذه الكلمة لغوياً، ونحن من حيث أننا وعيٌ لا نملك أي قدرة فعلية على تغيير أيِّ شيء في العالم الفيزيائي أي الطبيعة ، الواحد منا يلبس الجسد وحالاته كاملةً وهو مضافٌ إليه، بمعنى آخر نحن مسجونون في أجسادنا، ومصلوبون عليها ومن كانت له أذنان فليسمع.
وعينا هو وعي اللبس والسجن والصلب، ونحن لسنا شركاءَ في الخلق الذي ترونه وتحسونه وتعيشونه، نحن فقط شهداءٌ عليه، فهل من يُخلق هو كمن يَخلق؟ وهل تتصورون أن الخالق يعرف الأمور بنفس طريقة وعينا؟ وهل تعتقدون أن الإله الحق ينتظر من يمده بحبل المثل لكي يعيش؟ إنما المعاني هي من روحه وهي التي تعطينا شعور الحياة والوجود. فكيف تقيّمون الوضع الآن؟ هل ما زلتم تريدون إلهاً يعي مثل وعينا العاجز؟ هكذا إله لا ينفع ولا يضر!، إنما معرفة الإله الحق هي معرفةٌ فاعلة، هي ما صار ويصير وسوف يصير فعلاً، وما نفوسكم إلّا أسرى للأقدار التي قُدِّرت عليها.
والآن إن عدنا إلى الهدف الذي أراد الكاتب أن يثبته من خلال مؤلفه، والذي ذكرته أعلاه موضحاً ما أراد أن يقول من خلاله، وآخذا بعين الإعتبار ما قد تم سوقه في التحليل السابق لوضع الوجود الإنساني من منظوره كوعي، أرى أن إدعاء الكاتب يمكن إختصاره بما يلي:
إن جهةً ما تقبض على مقاليد كل شيء عبر قوانينها الأزلية، وهي بالحق الملازم لها تأسر ذواتنا (مع أن هذه الذوات ما زالت غير معروفة لنا أقصد علمياً وهي لن تُعرف بالعلم الفيزيائي أزلياً) في أجسادٍ هي صنعتها وهي تسيِّرُ صيرورتها بالقوانين الطبيعية، وتزودنا بمعانيها لتشكل وعينا الملازم والموازي للمادة وبهذا تكون قد أعطتنا الحياة والمعرفة، وهذا كله دون أن تكون هذه الجهة عارفة بما تفعل، ومن ثم هي ليست إلهاً.
ومما يدعم الكاتب رأيه به أن هذا الخلق المركب أتى على مراحل تطورية مديدة عبر الزمن، وكأن الألوهة يجب أن تقترن بالسحر لتكون ألوهةً حقة وعارفة!، لأن الإنسان للأسف خلط بين الحق والباطل في وعيه، فإذا بهذا الوعي تارةً يصدق على ما يحصل وطوراً لا يصدق، ولكن الإنسان إعتبر أن وعيه هذا هو المعرفة، ويريد أن يسقطها على الإله ويفترض بالإله أن يفكر مثله بذهن مشوش بين الحقائق والخيالات لكي يعتبره عارفاً، نعود لنقول أن لا فرق بين معرفة الله وبين الحقيقة الأزلية والحقيقة الصائرة أي الحق ثابتاً ومكوناً في المكان والزمان، إن ما نلتقطه، كل فرد على حدة، هو جزء من صورة ظلية لمعرفة الله.
ثم يقوم الكاتب بإدعاء ضمني مفاده أن الأديان تقول أن المخلوقات الحية هي الغرض والهدف من إنشاء الكون فلما لم يخلقها مباشرةً كما نعرفها دون مراحل تطورية عشوائية لو كان عارفاً لما يفعل؟ ولا ينتبه هنا أنه ببساطة يصادر غايات الإله من خلق الكون ومن ثم يحاسبه على معرفته القاصرة تلك، وما العشوائية إلا في أذهاننا نحن البشر، لأننا اكتشفنا أنه قد وجدت في الكون إضافات غير ذات فائدة من منظور معرفتنا القاصرة.
وقد يقول أحدهم أنه ما دامت معرفتنا ناقصة فكيف نتعرف على الإله الذي تصفه لنا، فليس لنا سبيل إذاً للوصول إلى حكمته، وما رفضنا للإله وللأديان إلّا لقلة الإستدلالات وعدم كفايتها، وعلى هذا يجب على هكذا إله وإن وجد أن لا يتعامل معنا على أننا مسؤولون عما لا نعرفه.
على هذا أرد، أن ليس شرطاً أن يدرك الإنسان المعرفة الكاملة ليكون متأكداً أنه موجود، بمعنى الوجود الذي شرحته أعلاه، ولا الإنسان مضطرٌ ليختزل الحقائق ليهرب من الأسئلة فإذا به يلغي البديهيات فقط ليحرر ذهنه من سبب وجوده، مختصراً الموضوع بأن وعيه مستمدٌ من المادة ورامياً نفسه في مستنقع الأوهام، يجب على الإنسان أن يواجه حقيقته وشرط وجوده وأن ينطلق من إيمانه بنفسه، فالمسؤولية المذكورة في الفقرة السابقة هي أولاً مسؤولية أمام النفس ذاتها، بأن تعود إلى جوانيتها، إلى أصلها، إلى منبعها، ساعتئذ ستلقى سببها، وستعرف قيمة ذاتها ومقامها والسبيل إلى ربها.