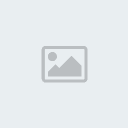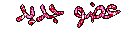د/ محمد سعيد ربيع الغامدى
اللغة نسبية الدلالة:
نظرية "النسبية اللغوية" هي النظرية التي جاء بها إدوارد سابير، أحد أهم رواد البنيوية اللغوية وأهم الذين رسخوا الانثربولوجيا الأمريكية. وهي النظرية التي تذهب إلى دعوى تطابق النماذج الثقافية والنماذج اللغوية. والفرضية التي عرفت باسمه واسم زميله وورف يلخصها هو في كتابه الشهير "اللغة" بقوله: "الفكر ليس سوى لغة تجردت من ثيابها الخارجية". (الغانمي: اللغة والخطاب الأدبي ص 121). ومع أن الفرضية واجهت انتقادات حادة في جانبها المتطرف كما يصفها معارضوها، وهو القول بأن اللغة المعنية تتحكم في طبيعة إدراك الظواهر، بحيث لا يصل أصحاب لغتين مختلفتين إلى المستوى نفسه في إدراك الظاهرة الطبيعية الخارجية فيزيائياً، اعتبرت النسبية اللغوية اجمالاً حدثاً مهما، عمل على تطويره والإفادة منه والبناء عليه الجيل اللاحق في أطروحاتهم، ولا سيما شتراوس وفوكو. يقول أوزباس: إن كتاب الكلمات والأشياء بكامله شرح لهذه الفرضية. (اللغة والخطاب الأدبي ص 121).
لا يسع المرء - مهما عارض الجانب الذي يبدو متطرفاً شيئاً ما في النسبية، لا سيما إلغاء الكليات اللسانية على حساب خصوصيات اللغات والثقافات - إلا أن يسلم مع سابير بأننا نصنع المعنى من خلال ثقافتنا، وأن اللغة في مستواها النسقي في المقام الأول (أي: بوصفها نظاماً داخلياً) ليست غير نظام للفكر بمعنى ما، وهي كذلك حتى في بعض مستوياتها السياقية (أي: بوصفها إما نظاماً إشارياً يحيل على واقع خارجي، وإما بوصفها وحدات لغوية متعالقة في التركيب)، إذ ليست هذه المستويات بمنجاة من النظام الداخلي المحكوم بأحكام التشكيل الثقافي. ولذا لا مفر أن يعد المعنى نسبياً معتمداً في صنعه على مستعمل اللغة.
لقد أطلعت على عدد من الأعمال الروائية والدرامية التي اتجهت إلى العناية بتصوير الإنسان معانيه الخاصة به، ربما بشيء من المبالغة في الوهم والتخيل الذي لا مسوغ له أحياناً، وقد يصل به الحال إلى تقرير مصيره في الحياة في ضوء هذه المعاني الخاصة الزائفة. وهذا قد يتفق إلى حد كبير مع نموذج ابن لادن الذي سبقت الإشارة إلى جزء منه فيما مضى. إذ يبدو أن ابن لادن صنع معناه للجهاد في ضوء ظروفه وملابسات حياته وثقافته وطرق تفكيره، وأقنع نفراً من الناس بذلك المعنى. ومما لا شك فيه أنه سيقنع عدداً غير قليل؛ للسبب المذكور آنفاً، أي: ثنائية الخير والشر السابق ذكرها. ثم عاد هؤلاء إلى النصوص الدينية من القرآن الكريم والسنة النبوية فرأوا أنهم هم المعنيون المخاطبون بهذه النصوص. وكأنهم وحدهم من دون العالمين الفئة الصابرة الثابتة على الحق الباقية على جادة الدين الصائبة. والمفارقة أن أحد زعماء بعض الطوائف التي يراها ابن لادن أشد كفراً من الكفار يستشهد في مقابلة تلفزيونية بنص الحديث الشريف الذي مفاده أن طائفة من المؤمنين في آخر الزمان تبقى صابرة ثابتة على الحق لا يضرها من حاد عنه. ويرى أنه هو وجماعته المعنيون بالنص. وهذا يشبه ما قيل في الخوا
رج من أنهم يعمدون إلى النصوص الصحيحة النازلة في الكفار والمشركين فيوجهونها إلى جماعة المسلمين.
يؤكد "غادامير" في تأويليته على سبيل المثال نسبية الدلالة الخاضعة للأعراف والتقاليد والثقافة، وينكر بشدة "القول بإمكانية تحديد المعنى الثابت عبر العصور والأزمان، بما أن المعنى عنده يبرز نتيجة محاورة تداخلية بين النص والقارئ في زمان محدد وحسب أفق شخصي معين وخاص. فالمعنى يظل نسبياً؛ لاعتماده على خصوصية أفق القارىء الفرد وزمانيته ومكانيته". (الرويلي والبازعي: دليل النقاد الأدبي ص93).
5- اللغة موهمة الدلالة:
اللغة التي يلجأ إليها الناس للتواصل قد تكون هي العائق دون التواصل، والمانعة من حصوله. ذلك لأنها لعبة كما يقول "فتجنشتاين" لا يعيها أغلب الناس؛ بسبب أن اللغة قادرة في بنيتها التكوينية على التمويه والخداع، وعدم إعطاء الفرصة لاكتشاف أسرار لعبتها الدلالية، وهذا هو مكمن الخطورة فيها. ولا يقترب مستعملو اللغة والمشاركون في اللعبة من الوعي ببعض مراوغات اللغة إلا نسبياً وبقدر إجادتهم اللعبة التي يشاركون فيها، لكنهم يعجزون حتماً عن مجاراتها أو السيطرة الكاملة عليها. ولذا يؤكد "هابرماس" مثلاً للحوار اللغوي بين متحاورين حتمية أن "يتجاوز كلام كل من المتحاورين الآخر دون وعيهما بذلك. مثل هذا الاتصال الزائف سيؤدي إلى اتفاق وهمي، ولا يمكن مهما طالت الحوارات أن يستطيع المرء اختراق هذا الوهم". ثم يؤكد أن أعقد أشكال الاتفاق الوهمي المفروض قسراً ولا يتكشف بسهولة تكون "أشكاله منسوجة في ذات اللغة التي تربط قطبي الحوار. وحينما تكون اللغة نفسها هي شكل من أشكال الهيمنة المتراكمة فلا يمكن للمشارك إدراك وتصحيح الاتصال الزائف زيفاً انتظم في كينونة وبنية الاتصال نفسه". والوحيد الذي يمكن أن يدرك هذا الوضع الزائف في نظر هابرماس هو المراقب ا
لخارجي غير المشارك في الحوار أو اللعبة، لكن المراقب الخارجي هذا ليس أي أحد، بل هو المحلل النفسي على المستوى الفردي، والناقد الأيديولوجي على مستوى المجتمع. (ينظر السابق: ص93).
اللغة تستعمل في كثير من الأحيان لباساً يستر الحقائق ويمنع من تعريها وتعريتها. يستعملها السياسيون وأصحاب النفوذ للسيطرة على الناس والاستبداد بمصائرهم. يسعون إلى أن يصبوا في آذان الناس ألفاظاً وخطباً رنانة تلعب بعواطفهم وتخدرهم، وهي في الحقيقة ألفاظ فارغة من المعنى تماماً، أو تخفي من المعاني غير التي يريدون قولها للناس. وهذا يذكرنا بصيحات "قورمان أرنولد"، و"ألفرد كورتسبسكي" المعبرة عن الاستياء من الألفاظ التي تحكم حياتنا عن طريق من يسيئ استعمالها. (ينظر السعران: علم اللغة ص168). والعجيب أن هؤلاء الذين يحكمون حياتنا عن طريق إساءة استعمال لغتنا قد لا يقصدون ذلك، وهم بطبيعة الحال لا يدركون حقيقة ما يفعلون. لأن المسألة تتعلق في المقام الأول باللغة ذاتها أكثر من تعلقها بمقاصد مستعمليها.
تتخذ العلاقة اللغوية وسيلة لتغطية حقيقة علاقات غير لغوية، بعضها في غاية القبح والشناعة، لو لم تستر اللغة تلك العلاقة فتجردت من ثيابها وظهرت على حقيقتها لصارت ربما في أبشع ما يمكن تصوره، بحيث قد لا تحتمل هذه العلاقة. ومن أمثلة ذلك علاقات المصالح المادية الصرفة المغلفة ضرورة باللغة الحميمية الإنسانية، وشواهدها ظاهرة ملموسة على المستوى الفردي والمستوى الجماعي والعلاقات الدولية. وقد يتطابق مع ذلك أيضاً العلاقات التي هي جنسية في حقيقتها مغلفة بلغة الحب والغرام في ظاهرها، وهكذا. وتستعمل كلمات التحية والشكر والسؤال عن الأهل ونحوها من الألفاظ المفرغة من معانيها اللغوية الحرفية في إقامة علاقات أخرى، ألبست هذه العلاقة لباساً لغوياً زائفاء.
تستطيع اللغة باقتدار أن تغير ملابسها فتظهر اللفظة غير المقبولة أو المحملة بايحاءات ثقافية معينة بلباس آخر يجعلها مقبولة سائغة. وهذه الصنعة يعرفها جيداً من خبر عين الرقيب في المطبوعات مثلاً. ويعرف من تأمل الفرق بين الألفاظ التي يمكن أن تجيز العمل وتلك التي تؤدي إلى منعه أن المسألة إنما هي لعبة، تقتضي من المرء الدخول فيها بشروطها. والفرق بين مستعملي اللغة كافة إنما هو فرق في مهارة اللعب، كالفرق بين لاعب كرة قدم ولاعب كرة قدم آخر. ولهذا يعرف المتعاملون مع الرقيب بحكم الخبرة أن "لهم في اللغة مندوحة" كما يقول العرب.
هناك مثال مشهور بين الناس في إبراز الجوانب الايجابية لشيء ما وإهمال الأشياء السلبية فيه، مع أنه لا مفر من وجود الجانبين كليهما في أي شيء، وهو: "الحديث عن النصف المملوء من الكوب" على سبيل التشبيه. ويُلجأ إلى لغة "النصف المملوء" بشكل ملحوظ في الدعاية والإعلان وترويج المنتجات والسلع وكسب العقود، وفي السياسة والدعاية السياسية وإقناع الناس بتوجهات معينة، إما سياسية وإما أيديولوجية، وفي التقدم بطلبات التوظيف، والمنافسة على المناصب، ونحو ذلك. وقد يعمد إليها أيضاً أنماط من الناس الذين يحبون تقديم أنفسهم دائماً للآخرين، باعتبارها الطريقة التي تقنع الآخرين بهم وبشخصياتهم، كما هو مشاهد ملحوظ، فتثمر عند بعض سامعيهم، وتنقلب إلى عكس الدلالة المرادة عند آخرين، كما سيأتي. ومن الحديث عن نصف الكوب الممتلئ مرة ونصفه الآخر الفارغ مرة أخرى ما روي في حكاية الرجل الذي مدح رجلاً آخر، ثم حصل من ممدوحه ما ينم عن عدم رضاه مما قال لأنه أقل مما يستحق، فهجاه هجاء مراً، فلما سئل عن سبب تناقضه في مقولتي المدح والهجاء لرجل واحد قال: والله لقد صدقت في الأولى وما كذبت في الثانية’’ إذ ذكرت في الأولى أحسن ما علمت فيه، وفي الثانية أسوأ ما علمت في
ه.
واللغة اللعبة يستعملها المتكلم في مناسبات معينة وسياقات محددة أداة لممارسة لعبة الخداع على سامعه، فينجح في ذلك؛ لأنه استعمل أداة ممتازة حقاً. غير أن هذه الأداة التي تجيد اللعب والمراوغة ترتد على مرسلها لتلعب عليه لعبة الخداع والتمويه، فيقع هو دون أن يشعر فريسة لها. كثيراً ما نسمع سائلاً يسأل مفتياً في مسألة، لا ليصل إلى إجابة في مسألة مشكلة، بل ليقول المفتي فتوى بعينها يعتقدها هو، فيلجأ إلى تقديم نصف الكأس الفارغ، ليقدم في النهاية فتواه إلى المسؤول، أي: أن السائل يتحول إلى مسؤول. غير أن لعبة اللغة التي تنطلي على السائل هنا تكمن في أنه لم يدرك حقيقة ما حدث، ويغفل عن إدراك أنه اشترك في لعبة من نوع ما أصلاً. ثم قد يقوده هذا إلى تكريس نوع من المعرفة عنده لم يلاحظ وجه الخلل فيه.
واللغة اللعبة دينامية في أصل تركيبها، تنتقل ألفاظها بخفة وخفية من مستوى إلى مستوى، ولا تتيح لمستعملها ملاحقتها في تحولاتها تمام الملاحقة، ولا سيما المستعمل الوثوقي غير الحذر. تنتقل الألفاظ في حركة دائبة دائمة بين المعنى اللغوي والمعنى الإصلاحي الصناعي، وقد تراوح الكلمة بين أكثر من مستوى لغوي واصطلاحي في آن، وقد تستعمل الكلمة لأكثر من معنى اصطلاحي في داخل العلم الواحد، وقد ينتقل اللفظ من حقل إلى حقل مع اختلاف واضح أو غير واضح في المضمون، الاصطلاحي. وتنتقل الألفاظ بين الحقيقة والمجاز بمعناهما العام، ويشمل هذا التنقل لغة العلم حتى في أكثر المصطلحات صرامة وتحديداً. وهذا الانتقال الدائم للألفاظ قد يغفل عنه بعض المتخصصين، بله العامة، وقد سبقت الاشارة إلى تفاوت مستعملي اللغة في الوعي بالكلمة.
6- اللغة مؤجلة الدلالة:
عنيت اتجاهات تحليل الخطاب ومدارسه عبر الأجيال التي تعاقبت على تحديد مناهج البحث فيه، بدعاً ب غرايس" وانتهاء ب "ميشيل فوكو" و"إدوارد سعيد" ومروراً بنظريات الحدث الكلامي وسياق الحال ل "فيرث" وكتابات بعض السيميائيين.. وغير ذلك، بالدلالات غير اللفظية، والتي لا تقولها اللغة ولا تشير إليها ألفاظ نصوصها. أما تحليل الخطاب في صورته المتأخرة عند بعض المعاصرين فقد لفت الانتباه الى الدلالة المنتجة من مجموع الخطاب لا بما يقوله كل نص منفردا. ولعل ما قدمه ادوارد سعيد في كتابه الشهير "الاستشراق"، معتمداً على رواد تحليل الخطاب وفي مقدمتهم فوكو، يجلو صورة كيف تصل مؤسسة كمؤسسة الاستشراق من خلال ما تراكم فيها من نصوص وما اكتسبته من استقلالية في رجالها ومتخصصيها وقواعدها الى مرحلة من السلطة والهيمنة بحيث لم يعد أحد من خارج المؤسسة يدعي المقدرة على الكلام في شؤون الاستشراق. هذه السلطة أصبحت من جهة تملي المفاهيم وتنتجها بالكيفية التي تنبثق منها لا من غيرها، ومن جهة أخرى اجتمع من خلال النصوص المتراكمة في داخل هذا الخطاب تعريفات للشرق وتعريفات للغرب وصورة للشرق والغرب راسخة لا يمكن زحزحتها مع ما فيها من صور زائفة، لم تتبلور هذه الصور
ة إلا بعد زمن، فوصلت دلالات الخطاب بعد حين.
من المفارقات العجيبة أن اللغة في الوقت الذي تعجز فيه عن أن تعني ما تقوله، كما سبق، تستطيع أيضاً أن تعني ما لم تقله ولم تشر اليه؛ لأن مجموع دلالات خطاب ما ليست بالضرورة مجموع دلالات نصوصها منفردة. مثلما أن دلالة الجملة ليست مجموع دلالات المفردات، ودلالة النص ليست فقط مجموع دلالات الجمل. وما لم تقله اللغة أو تشير إليه صراحة هو الأخطر والأعظم. وتزداد خطورته أكثر وأكثر إذا كان هذا النوع من الدلالة هو دلالة خطاب، لا دلالة نص مفرد.
من يصدق أن مجموع نصوص خطاب قيمي يحث بقوة على الخير ويحذر بشدة من الشر قد يسفر بعد حين عن دلالات شريرة لا دلالات خيرة؟ خذ مثلاً ما رآه أحد الكتاب في تعاضد التربية القبلية الصارمة التي تشدد على قيم معينة كالشجاعة، وتفترض في الابن إن أراد الاعتراف به في القبيلة الشجاعة، وإلا فالنبذ والتعيير بالعيب الكبير إن كان جباناً، وكذلك الكرم في مقابل البخل، وحسن التصرف في المواقف، والنجدة، والاعتزاز بالانتماء إلى القبيلة، وتجنب ما يعد في نظر القبيلة فضيحة أو مجلبة للعار ونحو ذلك. وبجانب هذه القيم ويسير معها خطاب قبلي صارم في تربية الأبناء على ذلك، وإلحاح دائم على إيصال هذه الرسالة لهم، فكانت الدلالة اللاحقة الناتجة بعد حين ذلك النمط النفسي المعروف عن كثير من العرب الذين يحاولون تزييف شخصياتهم والادعاء ولبس الأقنعة؛ ليتطابق الشخص مع المعنى القبلي للرجولة الحقة. هذا مع أن أحداً من مؤسسة الخطاب لم يكن يدري أن مثل هذا سيكون النتيجة؛ إذ لا إشارة له من قريب أو بعيد في نصوص الخطاب.
هذه الصورة تقرب منا ما يمكن القياس عليه من جهتين، الجهة الأولى ما ستكون عليه صورة المعنى لخطاباتنا القائمة الآن، والجهة الأخرى ما نحن فيه الآن، أمعنى هو لخطاب ساد فيما مضى أم لا؟
حفظ الله ذلك العالم الجليل ونفعنا بعلمه ، تحياتى