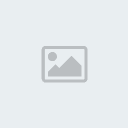من الأسلوبية إلى الشعرية
جان-ماري كلينكينبرغ
تقديم وترجمة: فريدة الكتاني
تقديم:
من المعروف أن "البلاغة"، منذ أرسطو، كانت، في دراستها لأنماط خطابية محددة (الخطاب التداولي والخطاب القضائي والخطاب الإشاري)، تبئر اهتمامها على وسائط إقناع المخاطب بصحة قضية ما. غير أنها لم تلبث أن فقدت هذه الخاصية الذرائعية المباشرة باتخاذها الخطاب الأدبي موضوعا امتيازيا لها، وخاصة منه الخطاب الشعري. ثم ازداد مجال اهتمامها بعد ذلك تقلصا لينحصر في إواليات ترصيف الكلمات في الجملة، أي فن الأسلوب، قبل أن تتحول إلى مجرد إحصاء لصور زخرفية مقولبة، وتصبح ممارسة مبتذلة سرعان ما اختفت من البرامج التعليمية.
ولئن كانت البلاغة ستشهد في الستينات صحوة نوعية بأثر من اللسانيات (البلاغة الجديدة)، فإن ما يهمنا من مسارها التطوري هذا هو أن "الأسلوبية" قد تولدت بالذات من نوع من القطيعة السجالية مع "البلاغة" في بداية القرن العشرين. وقد اختصت بملامح الموهبة والتفرد والإبداع في الخطاب الأدبي، أي دراسة فن التعبير عن حساسية الأديب باللغة واثر هذه اللغة على حساسية الأديب تلك. وهذا يعني احتفاء خاصا بالإمكانيات الأسلوبية للغة، أي "الآثار الأسلوبية" بالمعنى السوسري، أو "الوظيفة الانفعالية" للغة بالمعنى الجاكوبسوني.
غير أن هذا العلم الفتي (الأسلوبية) سرعان ما "انفجر" إلى مباحث لسانية مستقلة (علم المعاني، علم الأصوات…) أو تحول إلى نقد أدبي "تأثري" أو تأملات في علم الجمال، مما أفضى به إلى أزمة حقيقية ستكون، إضافة إلى عوامل أخرى (النقد الشكلاني في روسيا والنقد الجديد في أمريكا…)، إيذانا بظهور "الشعرية"، بما هي علم أخذ على عاتقه دراسة "أدبية" الأدب.
ولا شك في أن أهمية هذه الدراسة التي قمنا بترجمتها تكمن بالذات في عنايتها الخاصة بالتأريخ لهذه النقلة النوعية التي عرفتها الدراسات الأدبية المعاصرة من الأسلوبية إلى الشعرية. وقد كتبها Jean-Marie Kkinkenberg، أستاذ البلاغة والسيميائيات في جامعة (لييج) وأحد أنشط أعضاء "Groupe U" ببلجيكا الذين طوروا الدرس البلاغي. وهي منشورة في "Revue des langes vivantes"، المجلد 51، العدد 4، 1995، ص ص. 348-370.
وليست أهمية الدراسة تأريخية فحسب، بل هي منهجية كذلك من حيث حرصها على تحديد المفاهيم وإبراز العلاقات وتعيين الفوارق وتأويل الظواهر واقتراح النماذج النظرية والتطبيقية على اختلاف أصولها الجغرافية وآفاقها المعرفية. وهكذا، تعتمل في هذه الدراسة أسئلة مضمرة ذات ملاءمة كبرى هذه بعضها: ما هي عوامل إخفاق المشروع البلاغي الكلاسيكي وكيف أدى ذلك إلى ظهور الأسلوبية؟ كيف تم عقد القران بين الأسلوبية والأدب؟ ما هي خصائص الأسلوبية الأدبية؟ إلى أي حد يمكن اعتبار هذه الأسلوبية نقدا أدبيا؟ ما هي طبيعة الشكوك والانتقادات التي لازمت الدراسة الأسلوبية للأدبي، وكيف أدت هذه الشكوك والانتقادات إلى نشوء الشعرية بما هي ثورة جذرية في طبيعة الرؤية إلى النص الأدبي؟ ما هو دور الشكلانية الروسية والنقد الأمريكي الجديد وكذا آراء واجتهادات بعض الأدباء والنقاد والفلاسفة الحداثيين في تبلور خطاب علمي حول الأدب؟ ما هي الرهانات الإبستمولوجية لهذا الخطاب وكذا الأخطار التي تهدده؟
ولعل مما يجدر التنويه به هنا هو أن المؤلف -في سعيه إلى رصد وتعليل سيرورة موت البلاغة، وظهور الأسلوبية ثم أفولها، واحتلال الشعرية مواقع الصدارة بين مناهج النظر إلى الأدب، ثم العودة الظافرة للبلاغة بفضل اللسانيات البنيوية- لم يفلح دائما في الالتزام بروح التجرد والموضعية، حيث جنح أحيانا إلى توريط ذائقته وذاتيته في التعاطي مع تلك السيرورة. ترى هل كان يسعه غير ذلك، سيما وأن لهذه العلوم إغراءاتها، وأن موضوعها كذلك، أي النص الأدبي، لا يقل عنها غواية؟
ف.ك
* * *
يبدو أن عبارة "النقد الأدبي" لا تنطبق تماما على واقع ثابت ومتماسك: فلئن كانت تفيد في الغالب نشاطا يستهدف الحكم على موضوع معين، بحسب سلم قيمي قد تتنوع طبيعته (قيم جمالية، قيم إيديولوجية، الخ)، فإنها تدل، في معناها الرحب، على كل خطاب منتج على الخطاب الأدبي. وبهذا المدلول الثاني فقط، يمكن الحديث عن أنشطة تروم تأسيس "علم للأدب"، علما بأن هذه العبارة الأخيرة نفسها لا تخلو من إبهام، بحكم إمكان إحالتها على انشغالات (علم النفس وعلم الاجتماع مثلا) هي في حد ذاتها غريبة عن الموضوع الأدبي.
وحسبنا هنا أن ننظر إلى ذلك العلم الذي نذر على نفسه صراحة دراسة ما يبني الأدب في خصوصيته، ألا وهو "الشعرية" (la poétique). وبما أن نظرنا الشامل هذا سيكون تاريخيا ومنهجيا في آن، فلن يسعنا فصل "الشعرية" عن نشاط آخر يشاركها نفس الاعتبار (وهو أن الأدب موضوع لغوي بالأساس ويتعين دراسته بما هو كذلك) ألا وهو "الأسلوبية" (la stylistique)، التي تتميز مع ذلك عن "الشعرية" في كونها أوثق صلة منها بالنقد في معناه المتداول.
وإذا كنا نستصعب النظر الشامل إلى هذين النشاطين من زاوية موسوعية حقا، فليس مرد ذلك فقط إلى اعتبارات كمية (بسبب تعذر إحصاء كافة الأبحاث المنتمية إليها). بل كذلك إلى اعتبارات كيفية تتعلق بالأسلوبية خاصة.
وبالفعل، فقد واكبت كل خطوة خطتها الأسلوبية شكوك تتصل بحدودها الخاصة، بل وبوجودها نفسه. والأكثر من ذلك هذا النزوع في السنين الأخيرة إلى إعادة توزيع ما تم اعتباره إلى حينئذ أبحاثا أسلوبية ضمن خانات مستحدثة في حقل المعرفة، هذا في الوقت الذي كانت فيه الشعرية تتخلق بخطابها النظري ومقتضياتها المنهجية. ولا يعني هذا أننا قد انتقلنا اليوم مما يدعوه(هنري ميتران Henri Mitterand) "الفوضى الغريبة"، متمثلة في أسلوبيات عدة ليس بينها أي جامع (الأسلوبية التكوينية، أسلوبية النوايا، أسلوبية الآثار، أسلوبية اللغة، الخ) إلى نوع من الإجماع العام حول موضوع البحث الجديد وإجراءاته. ذلك أن أساس هذا البحث نفسه -وهو النظر إلى الأدب من حيث خصوصيته اللغوية- قد تم وضعه موضع سؤال. لا أساسه فحسب، بل أيضا منهجيته، لدرجة جرأة البعض على تكرار ما كان يقوله( شارل برونو Charles Bruneau) عن الأسلوبية: "إذا تذكرنا ما حدث سابقا لبرج بابل، الذي حال اختلاط اللغات دون اكتمال بنائه، أمكننا إدراك الأخطار الحقيقية التي تحدق بهذا العلم الذي ما يزال في مهده"(1).
ويبدو أن تكهن (برونو) هذا قد تحقق إلى حد ما: فلا أحد اليوم، وخلافا للمعهود من قبل، يدعي انتماءه إلى هذه الأسلوبية التي لم تعد، بما هي كذلك، تثير الجدل. ذلك أن إعادة التوزيع المشار إليها آنفا قد أدخلت نهائيا بعض أنماط البحث، التي اعتقد سابقا أنها مستقلة، في مدار علوم لغوية أخرى (الدلالية، اللسانيات النفسية، الصوتيات)، في الوقت الذي كان فيه بعضها الآخر حريصا على الظهور بمظهره الحقيقي، أي كونه نقدا أدبيا انطباعيا أو شرح نصوص أو تأملا جماليا أو فهرسة مدرسية للأساليب الخ.
وهكذا، سيكون آخر تحول عرفته الأسلوبية هو توضيح ما كان يمكنها ولا يمكنها ادعاؤه في آن واحد. كما أن الإعلان عن موت هذا العلم -وهو ما يخلف لدى البعض ترحاب معاداة التقاليد، ولدى البعض الآخر اعتراضا شديدا- لا يعني القول بميتة احتقار أو لا مبالاة: فالأسلوبية إنما تموت اليوم من عدم تحققها. ونحن نعرف ما الذي حث ويحث على هذه الثورة: إنه اللسانيات التي وسعت، منذ عقود، نطاق نفوذها بأن أدرجت ضمن اهتماماتها القضايا الدلالية، ورفضت النظر إلى الجملة بما هي الوحدة النهائية القابلة للتحليل، وطرحت إجمالا مسألة علاقتها بـ"السيميولوجيا" كما التمسها/دو سوسور De Saussure.
ومن ثم، يبدو تاريخ الأسلوبية في هيأة حلقة: فبعد أن تم تصورها كمادة لسانية، نزعت تدريجيا إلى اتخاذ الأدب موضوعا لها، مستعيرة عند الاقتضاء بعض الخاصيات التقليدية للخطاب المنتج على هذا الأدب، لتفضي إلى شعرية حريصة على أن تكون علما لغويا قائما بذاته، مثلما عبر عن ذلك (رومان جاكبسون Roman Jakobson) في صيغة مدهشة(2).
1 - أسلوبية اللغة والأدب:
1.1-تطورات الأسلوبية التطبيقية:
لا يتسع المقام هنا للتعرض المسهب إلى فكر من ابتدع كلمة stylistique (الأسلوبية)(3) فقد كان (شارل بالي Charles Bally)، وهو تلميذ (دو سوسور) الذي استهوته فكرة "نسق أدوات التعبير"، مقتنعا بهاتين الفكرتين: أن كل بحث لساني مجرد وهم إذا لم يربط الفكر باللغة، وأن هذه اللغة قبل كل شيء ظاهرة جماعية، لا أنها أداة تواصل بين الناس فحسب، بل لأنها أيضا تسمح للمتكلم بتحديد موقعه ضمن النسيج الاجتماعي. غير أنه إذا كانت اللسانيات السوسورية تميل، بحكم مقتضيات نماذجها، إلى المطابقة بين التواصل باللغة الفطرية والتواصل باللغة العلمية، فإن الأسلوبية تلح على العناصر الانفعالية للممارسة اللغوية. وعليه، فإن كافة التجليات الفردية تنتفي، ومن بينها العمل الأدبي باعتباره فعلا كلاميا.
ويمكن القول باختصار إن هذا البرنامج يشمل دراسة التلفظ (l 'énonciation) والتنويعات الحرة. ويتم إدراك الصلة بين الملفوظ (l 'énoncé) والتلفظ من خلال ما يدعوه (بالي) الآثار الطبيعية، وهي التي تخبر بوجدان المتكلم، ثم الآثار الإيحائية، وهي التي تحيل على البيئات (الاجتماعية وغيرها) التي يمكن أن تنسب إليها أحداث لغوية معينة"(4).
وسيستوقف نظرنا تطور واحد من مختلف تطورات هذه الأسلوبية الأولى، وهو أن علما مثل هذا لا يمكنه إلا أن يواجه مسألة اللغة الأدبية، التي تم إقصاؤها منذ البداية. ولا يكمن سبب هذه المواجهة في عريضة العنوان الذي اختاره (بالي) لكتابه فحسب، وهو: "Traité de stylistique française"، بل أيضا في فكرة مسلم بها على نحو غامض منذ كتابه هذا، وهي أن "اللغة الطبيعية دوما جميلة بالقوة"، وعلى نحو واضح في كتابه" le langage et la vie"، وهي أن "الأسلوبية الداخلية، رغم اختصاصها باللغة المشتركة، تضطلع تماما بمهمة الكشف عن رشيمات الأسلوب، وتوضيح أن القوى التي تعتمل فيه مخبوءة في أكثر أشكال اللغة ابتذالا"(5). وحيث إن التعارض لا يعدو كونه علاقة تراتبية، فقد كان حدس إمكانية إنجاز دراسة هذه الخصائص في خطابات خاصة أمرا هينا، ومن بين هذه الخطابات الخطاب الأدبي.
ومن المعروف أن (جول ماروزو Jules Marouzeau) قد أشاع في مجال البحث مفهوم "الانتقاء" (le choix) الدال على موقف المتلفظ من المادة التي تقدمها له البنية الاستبدالية (paradigmatique) للغة، وهو ما يقربنا بداهة من الأسلوب(6)، لأن هذا الأخير مفهوم أدبي بالضرورة. ألا يقول (ماروزو) إن "دراسة الأسلوب لا يمكن مباشرتها على نحو مفيد تبعا للأعمال الأدبية"؟(7) لكنه إذا كان ينفر من الدراسة المونوغرافية للمؤلفين، فهو يقترب من الأطاريح الجمالوية (Esthétisantes) بتفكيره في دراسات مونوغرافية للأساليب تروم فحص العناصر المكونة للغة، وذلك من أجل رصد "الفائدة التي يمكن استخلاصها منها بهدف منح هذه اللغة خاصية (une valeur)". وقد كانت كلمة "valeur" هذه من الالتباس بحيث أعطاها الكثير من القراء مدلول "قيمة".
وسيعرف البحث تحولا نوعيا مع (مارسيل كريصو Marcel Cressot) الذي أنجز دراسة أسلوبية وصفية في كتابه "La phrase et le vocabulaire de Joris-Karl Huysmans"، قبل أن يفرد كتاب "Le style et ses techniques" للغة الأدبية. ولعل الفضل الأساس لـ(مارسيل كريصو) هو تأكيده، ومن ثم إيحاؤه الصريح بلا جدوى إضفاء وحدة منهجية على ذلك العلم، المركب حتما، الذي سيهتم بهذا المجال(8) وستكون هذه المشكلة الدقيقة، كما سنوضح ذلك لاحقا، إيذانا بنشوء "الشعرية".
هكذا تم إذن اقتران الأسلوبية بالأدب، خاصة وأن الذي يسر هذا الاقتران هو ذلك التقليد الفيلولوجي العريق الذي أسهم في الخلط بين الاهتمام بالنصوص، الأدبية أساسا، والاهتمام باللغة. وقد أمكن بذلك الحديث، بموازاة مع أسلوبية لسانية "خالصة"، عن "أسلوبية مطبقة اللغة الأدبية" دشنتها أبحاث (شارل برونو)، الذي كان يرغب في تأسيس "علم تجميع" (une science de ramassage) يرصد ويصنف الظواهر من غير أن يضع قوانين، وذلك في أفق تحقيق توليف كبير سيحين أوانه. وقد تم تطبيق هذا "التجميع" في رومانيا خاصة، حيث كثرت الدراسات المونوغرافية ذات الطابع الإحصائي البسيط في الغالب، والتي حرص على جلها (تودور فياني Todor Viani). أما في فرنسا، فسرعان ما خبت الحمية، حيث تواترت أهم الأبحاث في الأربعينات خاصة (كريصو Cressot، ناردان Nardan، كوهين Cohen، شيرير Schérer). وبالطبع، فإذا كان إثبات الوقائع وتحديدها وتأريخها لا يخلو دائما من فائدة، وكان مستحيلا رفض أي حقيقة، فإن برنامجا مثل هذا لا يمكن أن تترتب عنه معرفة لا باللغة ولا بالظواهر الأدبية.
فمن وجهة النظر الأولى، اعتبر بعض اللسانيين -وهم أوروبيون عموما وذوو اتجاه دياكروني- أن اللغة المكتوبة هي اللغة بحصر المعنى (وهو الخطأ الذي لم يكن بإمكان زملائهم الأمريكيين اقترافه)(9) ويتفق الجميع اليوم على الإقرار بأن فائدة لغة فردية نادرة وشاذة مثل لغة الشعراء هي فائدة بسيطة. ومن ثم، فإن كتاب " Histoire de la langue française" وخاصة فصوله التي حررها (برونو Bruneau )، يبدو نوعا ما مطابقا لعنوانه: فهو، بحكم عدم إدراكه للغة الفرنسية في حد ذاتها ولصيروراتها التاريخية، لا يمثل في الأكثر سوى مساهمة "تجميعية" في عملية استكشاف نوع من اللغة المكتوبة.
ومن وجهة النزر الثانية، يعترف البعض بذنب جهلهم للملاءمة الأسلوبية للظواهر اللغوية المحددة: فالتساؤل عن مبتدع كلمة ما، هل هو Géongora أو Verhaeren، لا يفيد كثيرا إذا لم ينظر إلى وظيفة هذه الكلمة في نص ما. فما يعتبره المؤرخ لفظا مبتكرا قد لا يعتبره كذلك قارئ النص، مثلما يمكن للفظ آخر معتمد أن يفقد هذه الصفة، وهذا حال الألفاظ المهجورة(10) لذلك، فالتوسل بالمدونات النحوية(11)، التي يتجلى أثرها في تفجير الإواليات الأسلوبية ذات الملاءمة، لا يؤدي إلى وصف شاف ومرض للموضوع الأدبي.
ويعتبر النقد الذي وجهه (ميكاييل ريفاطير Michael Riffaterre) في 1961 إلى كتاب (مونيك بارون Monique Parent) المعنون بـ" Francis Jammes" -وهو أحد أنجح الأبحاث المنتمية إلى مدرسة (برونو)- أكثر النقود حدة وإقناعا ضد هذا النمط من المقاربات(12).
ومهما يكن الأمر، فإن هذه الأبحاث الكثيرة لم تكن عديمة الجدوى. فقد أتاحت أولا تطور تقنيات ذات فائدة كبرى في حقول لسانية أخرى، وسمحت ثانيا بوضع مفاهيم وتمييزات مفيدة: ألم تكن إحدى المعضلات التي أثارت جدلا طويلا في الأسلوبية الرومانية هي بالذات التمييز الذي ينبغي مراعاته بين اللغة المكتوبة واللغة الأدبية؟
لقد ذهب (برونو) إلى ضرورة حصر موضوع الأسلوبية التطبيقية في "لغة مؤلف مخصوص" باعتبارها نموذجا للغة الشاملة(13)، ومن ثم إلى ارتهان وصف عمل أدبي ما بمدى مناقضته ومفارقته لهذه اللغة-النموذج. وهذا يذكرنا بمفهوم "الانتقاء" المركزي، الذي سرعان ما سيقترن بمفهومي "المعيار" (la norme) و"الانزياح" (l 'écart)، اللذين كانا رايتين باسمهما تحارب كثير من الأسلوبيين والشعريين دون أن يحسم في الموضوع إلى اليوم.
ولقد كان هذان المفهومان، اللذان ينحدران من التقليد البلاغي، واللذان أريد لهما أن يكونا مقياسين محددين للغة الشعرية، مدار انتقادات صادرة عن آفاق منهجية وإيديولوجية جد متباينة. وحسبنا أن نشير هنا إلى أنهما كانا وراء تبلور منهجيات مختلفة. فبموازاة "الانزياح النوعي" (الذي اعتبره البعض، من زاوية سجالية، مرادفا "للخرق الصريح للسنن"(14)، هناك "الانزياح الكمي"الذي يتعلق بـ"الاستعمال العيني للوسائل المشتركة"(15)، والذي يعد عامل تصحيح لأبحاث مدرسة (برونو). والحق أن بينهما "مطابقة مملة"(16) مردها بالذات إلى الافتقار إلى معطيات تحدد الكمية الأسلوبية (بيير جيرو Pierre Guiraud)(17)، إلا أنه خيب كل الآمال المعقودة عليه. ولا يرجع سبب هذا الإخفاق إلى المنهج نفسه (مع أن لتقنية "الكلمات-الموضوعات" و"الكلمات-المفاتيح"، المهمل تطبيقها اليوم، نقائصها الواضحة)،وإنما يرجع إلى المزاج النفسي لذوي الميول الأدبية: فبحكم نفورهم التقليدي من شكلنة الرياضيات، ومحاولتهم رفض مفهومي "الصدفة" و"الاحتمال" في عالم مقدس، وسوء فهمهم لمفهوم "الخبر" الذي لبسوه مضمونا دلاليا، فإنهم لم يستسيغوا ولم يغفروا لمنهجية، ذات نتائج مضمونة لكن بسيطة(18)، أن تحرمهم من امتياز قول الكلمة الأخيرة عن "سر الأثر الفني". ولا شك في أن الرياضيات الاحتمالية تثبت اليوم فائدتها في مجالي الترجمة والمعلوميات أكثر مما تثبتها في حقل الشعرية، ذلك أن هذه الرياضيات، وبأثر من اللسانيات التوليدية، قد تراجعت في هذا الحقل لصالح الرياضيات الجبرية.
1.2-الأسلوبية في اللسانيات:
إن كل هذه الاعتبارات توضح إذن أن أسلوبية اللغة لم يعد بإمكانها اليوم أن توجد بصفتها علما مستقلا. وقد سبق لـ (ستيفان أولمان Stephen Ullmann) أن قال "إن الأسلوبية التعبيرية ليست فرعا من فروع اللسانيات، وإنما هي علم مواز يفحص نفس الظواهر من زاوية خاصة"(19). فهناك إذن، إلى جانب علم الأصوات، ما دعاه (تروبتزكوي Troubetzkoy) "الأسلوبية الصوتية"(20)، مثلما هناك، إلى جانب علم التركيب، الأسلوبية التركيبية الخ.
وهكذا، كان على الأسلوبية،بسبب مواجهتها لإشكالية الأسلوب، إما أن تجاوز ميدانها الأصلي فتتحول إلى مبحث أدبي، وإما أن تذوب في مباحث لسانية أخرى. وكما قال ذلك (تزفيطان طودورف Tzvetan Todorov)، فإن ّدور الباحث الأسلوبي كان لمدة طويلة هو دور الرائد الذي يضم إليه مناطق جديدة، ولكنه لا يستغلها بجد إلا بعد قدوم التقني المجهز، أي اللساني. إن ما أنجزه (بالي) في مضمار المقارنة والتمييز بين المترادفات ينتمي اليوم دون منازعة إلى علم الدلالة، ذلك لأن المصادرة على أن الفرق بين مترادفين ليس أسلوبيا تعني حرمان "المعنى" من أي موقع له بين "الأسلوبي" و"المرجعي"، وهو ما لا يمكن تصوره"(21).
تبقى المشكلة إذن في السؤال عن مدى أهمية الحفاظ، داخل كل مبحث، على التفريق بين ما هو أسلوبي وما ليس كذلك. هذا مع العلم بأن الحدود المقترحة بينهما غير ثابتة أحيانا: فمفهوم "الوظيفية" لا يفسر كل شيء في أعمال (أندري مارتيني André Martinet). كما أن القول مع (بيير ليون Pierre Léon) بـ"الخبر الثاني" لا يخلو من تسرع.
ومع ذلك، فقد تم اقتراح بعض الحلول: فهذا (ألجيرداس جوليان جريماس Algirdas Julien Greimas) يقترح في كتابه "Sémantique structurale" تسمية كل بحث ينطلق من المتن ليفضي إلى بناء نموذج نظري بـ"الوصف الدلالي". أما ذلك الإجراء التكميلي، الذي ينطلق من النموذج الثابت ليجمع مختلف المتحولات الحرة بصفتها "نوعا من النماذج الفرعية التي تحلل اشتغال البنيات العليا وإنتاجيتها"، فيدعوه "وصفا أسلوبيا"(22).
وفي نفس الاتجاه، يخص (طودورف) الأسلوبية بمجال محدد، حيث يقول: "إذا سلمنا باحتواء كل ملفوظ لغوي على عدد من العلاقات والقوانين والإكراهات، التي لا يمكن تفسيرها بإوالية اللغة، وإنما بإيوالية الخطاب وحدها (…)، فمن الممكن حينئذ الحديث عن تحليل للخطاب يعوض البلاغة القديمة بما هي علم عام للخطابات. ومن شأن هذا العلم أن تكون له فروع "عمودية"، كالشعرية التي تهتم بصنف خطابي واحد هو الأب، وفروع "أفقية"، مثل الأسلوبية التي لا يتألف موضوعها من كل القضايا المتعلقة بكافة الخطابات"(23).
وبطبيعة الحال، فإن مثل هذه الأسلوبية، إضافة إلى ضرورة استفادتها من تحليل الخطاب ومن لسانيات النص(24)، ستتقارب مع دراسة التلفظ، التي لا تعتبر الإنتاج اللغوي معطى مغلقا ومنجزا، بل بمثابة سلوك رمزي. لكن هذا النوع من الدراسة، الذي تمتد جذوره العميقة إلى البلاغة والذي يطبق خاصة في البلاد الجرمانية والأنجلوساكسونية، لم ينتج بعد آثاره كاملة وواضحة في مستوى دراسة الأساليب(25).
2 - الأسلوبية الأدبية أو النقد الأسلوبي:
1.2-الأسلوبية والنقد:
إن الحدود الفاصلة بين أسلوبية اللغة ودراسة الأدب كما رأينا، وخلافا لما يريده البعض، ليست حدودا كتيمة ولا ثابتة(26) وبهذا الصدد، فإن المقياس المميز بين هذين التوجهين ليس تماما ذلك التعارض بين الجماعي والفردي: فلقد أمكن لدراسة الأدب أن ترصد "أساليب حقبة معينة" وأن تتسم بالأحرى بانتقالها من الاختيارات الممكنة إلى الاختيارات الفعلية، ومن وصف نسق ما إلى وصف وقائع تلفظية. وبتعبير آخر، فإن موضوع الأسلوبية الأدبية لم يعد هو البنيات ذات التحققات الافتراضية، وإنما هو النص الأدبي بالذات.
ولسوء الحظ، فإن هذا التحول الجوهري في تاريخ الدراسات الأدبية أخطأ أهدافه: فقد تم النظر بالفعل إلى أن النص معطى مباشر، بحيث أدى تقديس الممارسة الأدبية ببعض كبار اللسانيين أنفسهم، وبصدد هذه الممارسة بالذات، إلى الاعتقاد بأن على كل علم أن "يبني" موضوعه. فقد أكد (سبيتزر Spitzer) بأن "ميير-لوبك Meyer-Lübke، وهو رائد الاتجاه الوضعي في اللسانيات الرومانية، قد اختار بإجلال أسلوبية المؤلفين، وهي بالضرورة أسلوبية جمالية وتتطلب "موهبة فنية" من الناقد"(27). وهكذا، وبعيدا عن كونها علما للأدب، اعتبرت الأسلوبية الأدبية نفسها منذ البداية فرعا من فروع النقد. وحتى إذا رفض كثير من الأسلوبيين هذه الصلة، فإن بعضهم نظر إلى الأسلوبية بما هي نشاط مساعد للنقد(28)، وبعضهم الآخر عدها شرطا لازما له(29). وفي أحوال كثيرة، فقد ظلت ممارسة تابعة له، هذا إذا لم يتم اعتبار الممارستين متماثلتين(30). ولعل الدراسات الإيطالية كانت أكثر من غيرها مجالا لهذا الخلط(31)، بحكم حسم الباحثين مسألة علمية الأسلوبية أو لا علميتها(32).
ومهما تكن الدرجة التراتبية لهذه العلاقة بين النقد والأسلوبية، فإن ترابطهما ليس واضحا كل الوضوح: فإذا كان على هذه أن تقدم لذاك "كشفا للنص بواسطة الوصف الدقيق"(33)، بل وكان بإمكانها أيضا أن تبرهن على توافق عناصر النص وتطابقها، فإن كافة "النقاد الأسلوبيين" ظلوا متكتمين على سيرورة الانتقال من الملاحظة الشكلية إلى أحكام القيمة. وهي ما يغري بالقول في هذه الحالة بأن الوصف اللساني لا يمثل سوى "نغم إضافي" في عمل الناقد(34).
ومن المفيد ملاحظة أن ذوبان الأسلوبية الأدبية في النقد يوازي تماما ذوبان أسلوبية اللغة في مختلف المباحث اللسانية. إلا أن كلا من هذين التوجيهين لم يستطع أو لم يشأ صياغة جهاز مفهومي خاص كفيل بصيانة استقلاله. ففي حالة التوجه الأول، أدى التنقل بين النقد والأسلوبية إلى السيادة الإمبريالية لهذه الأخيرة، بحيث ضمت إلى مملكتها ناقدا صرفا مثل (جورج بولي Georges Poulet)، بل وحتى (إيريك أويرباخ Erich Auerbach) وكتابه "Minmesis"(35). فهل يبعث هذا التردد على الاستغراب ما دام أن الأسلوبية لم تكن جسرا بين اللسانيات والأدب (رغم قولة (سبيتزر) المأثورة) بمقدار ما كانت صرحا متكامل المعارف تتجاوز فيه غالبا نتف من علوم النفس والتاريخ والاجتماع والجمال، من غير أن يكون هناك "إسمنت" منهجي يرسخ قاعدة هذا الخليط؟ كيفما كان الأمر، ورغم العديد من التحفظات والمجادلات "النظرية"، فإن معايير البحث إجمالا مبهمة إبهام "الحدس" الذي تغنى به (داماسو ألنصو Dâmaso Alonso) في قوله: La intuicion del autour, su registro en el papel; la lectura, la intuicion del lector. No hay mâs que eso"(36)*.
أما تعدد التسميات (أسلوبية النوايا، أسلوبية الآثار، أسلوبية الموضوعات، أسلوبية الأشكال) فلا يعكس فوارق منطقية بقدر ما يعكس ارتيابا خطيرا يتصل بأهداف البحث ذاتها.
2.2-خصائص جوهرية: النزعة الجمالية والنزعية النفسية.
1.2.2-لا يكتسي هذا التطور أية غرابة لدى من يريد الاهتمام بتاريخ هذا الفرع من الأسلوبية، حيث سيلاحظ بأنه، منذ البدء، تكتنفه صعوبات خطيرة. فبمجرد ما تم الترويج فعلا للأسلوبية باسمها هذا، انتهجت هذه مسارات متباينة دون أن تستطيع التحقق في أحدها. وهناك إجماع حول نسب الموقف اللاوضعي المشهور به كل من (سبويري Spoerri ودريسدن Dresden) إلى (كارل فوسلير Karl Vossler) ومن خلاله إلى (بينديتو كروتشه Benedetto Croce). والحال أن هذا الأخير يماثل بجرأة بين مفهومي الفن والتعبير، بل وبين مفهومي التعبير والحدس، مما يؤدي إلى ذوبان اللسانيات في علم الجمال(37). وهو ما يفترض نشوء اللغة بتلقائية رفقة ما تعبر عنه من رؤى وتصورات، ومن ثم إقصاء كل تحليل للمقولات اللسانية. هكذا، وإزاء فكر شامل مثل هذا، نصبح إذن وبكل بداهة بعيدين كل البعد عن حقل الشعرية التي تلح على تحليل ما قرر (كروتشه) اعتباره غير قابل للتحليل. بيد أن للأطروحات المتضمنة في كتابه "Estetica" -والتي تعمق هنا فكرة لـ (ف.دوسانكتيس F. de Santkis)- قاسما مشتركا مع الشعرية، وهو أن الفن شكل، وليس مادة. والحق أن العبرة من تعاليم (كروتشه) غير هذه: إنها تكمن على العكس في النزعة الجمالية الكلية التي يمثلها (فوسلير Vossler) في مرحلته الثانية، أي ذاك الذي يجعل من الأسلوبية مجالا للأسلوب، والذي يعرف الأسلوب بما هو نقطة التقاء كافة وسائل التعبير(38). ترى هل هذا يدفع البحث إلى الأمام؟ إن صفحات تاريخ الأسلوبية تعج بتعاريف الأسلوب مثلما تعج صفحات النقد الأدبي بتعاريف الشعر والجمال(39):فالأمر يتعلق بمفهوم ميال اليوم إلى الاختفاء من سوق التداول بسبب عدم وضوحه وبيانه(40).
2.2.2-أما التوجه الثاني الذي انتهجته الأسلوبية الأدبية، فيمكن إسناده إلى (جوستاف جرويبير Gustar Groïber) الذي خص اللسانيات النفسية، في كتابه "Grundriss"، باعتبار سبق لـ(بالي) أن سعى إلى تحقيقه(41). لكن نظراته لم تطبق على الموضوع الأدبي إلا مع (فوسلير) في مرحلته الأولى، الذي عمد في كتابه "Benvenuto Cellinis Stil" إلى تحليل الأسلوب النفسي(42). وقد كان لـ(فوسلير) أتباعه أيضا الذين يتفاوت وفاؤهم به. غير أن اكتشافات التحليل النفسي ما لبثت أن أبانت عن هشاشة الأسس التي شاء هذا الصرح أن ينهض عليها. فهل يعني هذا حلول "أسلوبية تحليلية نفسية" محل "أسلوبية نفسية"؟ إن ما حصل بالأحرى هو العكس: فالأبحاث التي تتوسل حصرا بنظرية (فرويد Freud) -كما هو الحال مع (أوطو رانك Otto Rank وماري بونابارط Marie Bonaparte)- تنتمي بقوة القانون إلى التحليل النفسي دون سواه. وكما قال ذلك (طودوروف) بطرافة، "فإذا كان التحليل النفسي أو الاجتماعي لنص أدبي ما غير جديرين بالانتساب إلى علم النفس أو علم الاجتماع، فأي حق يمكن نسب هذين التحليلين إلى علم الأدب؟"(43). ومن ثم، يكون النقد النفسي كما طبقه (شارل مورون Charles Mauron)(44) في عداد التحليل النفسي أو، ببساطة، في عداد النقد الأدبي إذا ما أنكر هذا التحليل أن ذلك النقد نفسي. مثلما يكون "التحليل النفسي العنصري"(*)، كما طبقه (باشلار Bachelard) ذا تعلق بالشعرية… ومع ذلك، فإن أبحاثا كثيرة ما تزال تنتمي إلى الأسلوبية النفسية: فبموازاة أولئك الذين ما يزالون يستكشفون العلاقة بين "mens" مؤلف ما وأشكال نصوصه، هناك آخرون يسعون بجرأة إلى وضع نمذجات منهجية تميز إلى ما لا نهاية بين الأساليب المزاجية(45).
3.2-نماذج موضحة:
لا ريب في أن أعمال (ليوسبيتز) تعد، أحسن من سواها، نموذجا تجتمع فيه النجاحات الجمالية، المعزوة لمهارته كباحث متخصص غالبا في الأسلوبية، والهنات المنهجية للنقد الأسلوبي. وحسبنا التذكير بمبدإ "الدائرة الفيلولوجية" المشهور(46)، حيث يتعلق الأمر بالانطلاق من جزيئـة أو خاصية أسلوبية بارزة (من وجهة النظر النوعية أو الكمية)، ثم باستخلاص رؤية افتراضية إجمالية منها (ذات طابع نفسي)، يتعين التأكد منها بواسطة ملاحظات دقيقة، فتصبح الدليل الهادي إلى "قراءة شاملة" The life-giving center, the sun of the solar system"(47)(**)، حينئذ، يمكن لهذه العلاقة، المفصحة عن رؤية الكاتب للعالم، أن ترتبط بالظرف السوسيوتاريخي. وكمثال لذلك، يلاحظ (سبيتزر) في رواية "Bubu de Montparnasse" كثرة استعمال الأدوات السببية في أحوال تفتقر موضوعيا للصلة السببية. وهذه الخاصية ينظر إليها بما هي افتراضيا مؤشر على "حافز موضوعي مزعوم" منتج لإحباط مستسلم إليه، وهو الموضوع الأساس في الرواية. وسيكون هذا الموقف بدوره تعبيرا عن القدرية التي استبدت بالنفسية الفرنسية في عهد شارل-لويس فيليب. ففي مثل هذا الإجراء، نتعرف بجلاء على الخصائص العامة للأسلوبية الأدبية، وهي: المحاكاة الشكلية للمنهج العلمي واستعمال مفاهيم تفتقر إلى الدقة الكافية (مثل: "الملاحظة الجيدة"، "الهيئة الداخلية"، "الجذر النفسي")، والتسليم بتماسك النصوص وبوجود صلات (غير موضحة) بين المعطى اللغوي والطبع الذهني للشخص، وبين هذا الطبع والجماعة الخ(48).
4.2-خاتمة:
هل ينبغي أن نستنتج من كل ما سلف ابتذالية الأسلوبية الأدبية؟ لا نعتقد ذلك، خصوصا أن جميع الانتقادات الموجهة إلى سليل الفيلولوجية هذا قد تم تصورها انطلاقا من موقع تهيمن فيه مقتضيات المنهج العلمي. فمن المفيد فعلا التمييز بين موقفين ممكنين من نص أدبي ما:
"ففي الحالة الأولى، لا يكون العمل الفردي سوى نقطة انطلاق إلى معرفة النمط الخطابي الذي ينتمي إليه. أما في الحالة الثانية، فإن هذا العمل يبقى الهدف الأخير للبحث، الذي يروم الوصف ومن ثم التأويل. فثمة من جهة دراسة الممكنات الخطابية (أو "الأشكال" الأدبية كما في الاصطلاح التقليدي)، ومن جهة أخرى الإمساك بمعنى العمل، بحيث ينتمي الإجراء الأول إلى العلم، وينتمي الإجراء الثاني إلى التأويل"(49).
لذلك، لا يمكن حرمان الأسلوبية من حقها في الوجود. إن المشكلة بالأحرى تكمن في مدى قدرة هذا المبحث أو عدم قدرته على تقديم إضافات إلى دراسة الأدب. فما أكثر الجسور التي مدت بين مواقع بعضها وهمي! وما أكثر "النظريات" التي عجزت عن اتخاذ موضوع معرفي خاص بها من فرط ادعائها الإحاطة بكل الظواهر! وما أكثر التلفيق الذي تطفح به صفحات مجلات العلوم الإنسانية! ومن ثم، لا يمكن للأسلوبية الأدبية أن تصمد إلا إذا تم قبولها كما هي في ذاتها، سواء باسم النقد الأدبي أو بأي اسم كفيل برفع كل سوء فهم(50).
3 - الشعرية:
1.3-العلم والأدب:
إن التحول الذي تمثله الشعرية في حقل الدراسات الأدبية ليس، كما يعتقد أحيانا، مجرد توفيق بين الانشغالات السابقة بواسطة المعرفة اللسانية، وإنما هو بالأحرى، وكما يوحي بذلك نص (طودوروف) السابق ثورة جذرية في طبيعة الرؤية إلى النص الأدبي. ونحن نعرف اقتراح (جاكوبسون) الذي ينص على أن موضوع العلم المنشود ليس هو العمل، ولا هو الأدب بصفته مجموعة أعمال، وإنما هو "الأدبية" (La littérarité)، أي الخاصية المجردة التي تجعل من عمل ما عملا أدبيا(51). وهذا يعني بداهة أنه لا يمكن تصور علم للأدب إلا بهذا الشرط، بما أن لا علم بدون تجريد.
وهكذا، أخذت الشعرية على عاتقها تحقيق ذلك الهدف الذي أخطأته الأسلوبية بمناسبة تحولها الأول، أي حين اعتقدت اتخاذ العمل الأدبي موضوعا خاصا بها بتوسيعها مجال البحث من اللغة إلى الأدب. بيد أن علاقة التوازي بين اللسانيات واللغو، وبين الأسلوبية والعمل علاقة خادعة طبعا. وقد كان واجبا على الأقل تعويض الطرف الثاني في القضية بـ "اللغة الأدبية" (أو "الشعرية"). ومن أجل أن يكون منهج الشعرية علميا علمية منهج اللسانيات، كان يتعين الخطو بعيدا إلى الأمام بهدف دراسة لا التفاصيل والجزئيات، وإنما فقط القوانين التي تحكمها وتحددها(52). ولا غرو من أن عدم إدراك هذه المقدمة الكبرى ما زال يؤدي اليوم ببعض الباحثين الجامعيين إلى المجادلة حول برنامج الشعرية، مثلما يفقد بعض التمييزات الأساسية (كالتمييز بين العلم والتأويل) قدرتها على الصمود.
2.3-ثورة الشعرية:
1.2.3-لعل الغريب أن هذا التحول لم يتم بحدوث تغير في الأسلوبية الأدبية ولا بنشوء الجدل حول تطبيق الأسلوبية اللسانية على الأدب. إن ما وقع تسجيله بالأحرى هو إجمالا نوع من قطع الصلة، بحيث إن الحقل الجديد للأبحاث قد تشكل انطلاقا من تضافر تأثيرات خارجية يمكن إرجاعها، بالنسبة إلى الميدان الأوربي، إلى ثلاثة. هذا دون الإشارة على أي حال إلى التأثير (الحاسم) للأوضاع الاجتماعية الجديدة، المتمثلة في الانفجار الديموغرافي، وفي إعادة تشكيل الخريطة المجتمعية التي اجتذبت الشرائح الشابة للطبقات الجديدة نحو العلوم الإنسانية، وفي التوسع الاقتصادي غير المعهود الذي ترتب عنه نزوع إلى التفاؤل كانت له انعكاسات على هذه العلوم.
فهناك أولا طلائع الشعرية كما أفرزتها الشكلانية الروسية(53) والنقد الجديد في الولايات المتحدة الأمريكية الخ.
ثم هناك فئة من الكتاب أو النقاد الذين مهدوا لنشوء خطاب علمي حول الأدب، سواء بممارستهم أو بشعريتهم (بالمعنى التقليدي للكلمة هذه المرة). من هؤلاء طبعا بعض الفلاسفة. مثل (ميرلو-بونتي Merleau-Ponty)، الذين يبحثون في النص ذاته عن علل وجوده. ومنهم كذلك بعض الكتاب مثل (يون باربو Ion Barbou) الذي وفق بين الرياضيات والشعرية من منظور كونهما يفترضان تكثيفا لوسائط التعبير(54)، و(جون بولان Jean Paulhan) الذي اهتم بالبلاغة، وكذلك (مالارمي Mallarmé وفاليري Valéry) وغيرهم. ولئن كان هذا الأخير لا صلة له باللسانيات، خلافا لما يعتقده البعض(55)، فإن كثيرا من أفكاره لا يخلو من حداثة أكيدة، حيث إن ما يستأثر باهتمامه هو المعضلة العامة للغة الشعرية، بغض النظر عن تحققاتها. ولا بد من الإشارة أيضا إلى بعض علماء الجمال مثل (ماتيلا غيكا Matila Ghyka) الذي وضع نظرية رياضية للشكل تهدف إلى تحليل التناظرات المتجلية في الطبيعة وفي مختلف اللغات الفنية معا، ومثل (بيوس سيربان كوكوليسكو Puis Serban Coculescu). ويمكن أن نضيف إلى هؤلاء الأسلاف (ريموند كوينو Raymond Queneau) الذي أفصح عن انشغالاته البنيوية منذ الثلاثينات. وستعرف الستينات تبلور أشكال أدبية جديدة أعلنت عن نفسها في حقول مختلفة، مثل "مختبر الأدب الاحتمالي" (L’Oulipo) و "الرواية الجديدة" اللذين تطلبا مقاربات نقدية جديدة.
أما التأثير الحاسم الثالث، فكان هو، كما تقدم، تطور اللسانيات الحديثة -وخاصة مدرسة براغ في علم الأصوات- التي استعارت من (دوسوسور) فكرة الوظيفة لتصوغ مفهومي "التعارض" و"النموذج النظري"، وحددت إجراءات التحليل المفهومي الخاص بالنظرية "الكلوسيماتيكية"، وردت الاعتبار للدلالية التي أقصاها (بلومفيلد Bloomfield)، واقترحت تمييزات مفيدة كالتعارض بين الشكل والمادة، وبين السيميائية الإشارية والسيميائية الإيحائية. وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذا التحول من اللسانيات إلى الشعرية لم يكن مباشرا في مجال البحث الروماني على الأقل(56). ذلك أن الطريقة إلى الشعرية، الذي سدته إلى حينئذ الدراسات الفيلولوجية، قد انتهجه بالأحرى باحثون ينتمون إلى آفاق معرفية أخرى. ويكفي أن نشير إلى ذلك الأثر القوي الذي أحدثته في فرنسا الإثنولوجيا البنيوية، وبالأخص أبحاث (كلود ليفي-ستروس Claude Lévi-Strauss) الذي يرى بأن الأشكال الاجتماعية تتمفصل مثلما تتمفصل اللغة(57). وقد عزا البعض هذه المنعطفات، التي سلكها كثير ممن فاتهم الركب، إلى اللسانيات، الشيء الذي أثمر مجادلات بل ومغالطات في العقدين الأولين من هذا القرن.
2.2.3-ولئن حصل، في المستوى النظري، نوع من قطع الصلة بين الأسلوبية والشعرية، فإن الوقائع التاريخية لا تثبت ذلك. فباسم الأسلوبية، أنجزت حول الأدب أبحاث نظرية في منتهى الأهمية(58)، مثل أبحاث (ميكاييل ريفاطير Michael Riffaterre) خاصة التي تعتبر جد متقدمة في هذا المضمار بحكم إلغائها منذ البداية مفهوم "الجودة" (أو "الكيفية"): فلا يهم أن يكون الأسلوب المرصود للتحليل جيدا أو رديئا بما أن ثمة أسلوبا. وهي جد متقدمة كذلك لأنها لا تستهدف أولا التعليق على نصوص، بل اقتراح ترسيمات هي وحدها الكفيلة بتأسيس علم للقراءة أو للأسلوب. وقد ابتدع (ريفاطير) مفاهيم لعل أكثرها أصالة مفاهيم "السياق" (Le contexte) و"الشفرنة" (L’encodage) و"الوحدة الأسلوبية" (L’unité Stylistique). وبخصوص هذه الأخيرة، التي لا توجد بالنسبة لمعيار لساني خارج عن النص، فإن ما ينتجها هو العلاقة بين سمة مفارقة ما وسياقها المباشر. ولا يمكن فصل مفهوم "السياق" هذا عن مفهوم "التشبع" (La Saturation): فكل تكرار في الأسلوب يعادله نقصان تدريجي في أثر المفارقة، ومن ثم يترتب عنه توجه جديد للسياق. وهذا التصور، الذي يستعير جزءا من مقدماته المنطقية من نظرية الإبلاغ (التي لم تستغلها الشعرية بكفاية)، والذي تعترضه هنا إشكالات ذات صلة بالذكاء الاصطناعي، لا يتخذ النص مجرد ذريعة، بل يدرسه في ديناميته، أي في سيرورة قراءته. وهو ما يعني فك شفرة نسق الأسلوب وبناء نماذج تنجز بنيات المرسلة وتكرار الموازيات والمفارقات.
وفي أبحاث لاحقة، عكف (ريفاطير) أكثر على تحليل نصوص عينية، مستأنفا بذلك ممارسة لم يهجرها نهائيا(59). إلا أن مقالاته ظلت، أكثر من ذي قبل، مقالات منظر، بحكم رفضه التقيد بنزعة تجريبية وصفية ضيقة كثيرا ما كانت مصدر إساءة إلى الأسلوبية. وهكذا، تم حلول أسلوبية توليدية محل أسلوبية بنيوية. ومع ذلك، يمكن التساؤل عن مدى ملاءمة التسمية الأولى، ما دام أن الدراسات التي تدعي الانتماء إلى الأسلوبية التوليدية لا جامع قويا بينها وبين دراسات (أو همان Ohamnn) أو (فان ديك Van Dijk) مثلا: فقد اهتم فيها (ريفاطير) بالأحرى بتوضيح سيرورة تشكل الجملة، بل والنص كذلك، انطلاقا في الغالب من معطى دلالي أولي تتم معالجته بحسب بضع قواعد تختلف عن قواعد الخطاب العادي(60).
وقد تم إنجاز أبحاث أخرى رائدة في إطار "الكلوسيماتيكية"، رغم أن هذه لم تستعمل أبدا مصطلح الأسلوبية. وفي هذا الصدد، تعتبر الأبحاث الفذة التي خص بها (هانس صورنسن Hans Sorensen) شعر (فاليري Valéry)(61) نماذج أولى لتطبيق مفاهيم (هيلمسليف Hjelmslev) على الأدب: وهكذا، فإن شكل المحتوى يحدد الحافز (الذي يحدد بدوره الموضوعات والأجناس والتركيب)، بحيث تكون مادة المحتوى "ذريعة" غير لسانية، وتكون اللغة وكذا الأسلوب تقنيمين (Hypostases) لمادة التعبير وشكلها. وقد طور (أ.ستندر-بيترسن A. Stender-Peterson) هذه المفاهيم في كتابه" Esquise d'une théorie structurale de la littérature"، حيث ربط "الأدوية" (L’instrumentatlisation) في مستوى التعبير بـ "الانفعالية" (L’émotionalisation) في مستوى المحتوى، مما يسمح بتصور "رحم" يولد أربعة أجناس بسيطة (الغنائي، الدرامي، الملحمي، السردي) تقدم عددا كبيرا من الأنواع المتزاوجة.(يتبع)