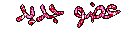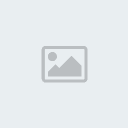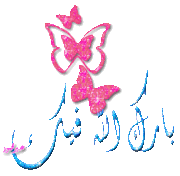[كيف يمكن للفكر الفلسفي أن يكون متعددا، و واحدا في آن واحد؟
الإشكالية الثالثة
كيف يمكن للفكر الفلسفي أن يكون متعددا، و واحدا في آن واحد؟
5- المشكلة الأولى: في الفلسفة اليونانية
كيف استطاع العقل اليوناني الوصولَ بالفلسفة إلى أوجها، بعد أن كان مكبَّلا مدة قرون بقيود الخرافة، وكيف دعا الإنسانَ إلى استثمارها في حياته الخاصة؟
6- المشكلة الثانية في الفلسفة الإسلامية
كيف قُدّر للفكر الإسلامي ـ القائمِ على الإيمان بعقيدة التوحيد ـ إنتاجُ فلسفة قائمة على العقل، وتحقيق التقارب بين هذا الإيمان، هذا العقل، في شكل توفيقي وتكاملي بينهما؟
7- المشكلة الثالثة: في الفلسفة الحديثة
كيف تمكَّن الفكر الفلسفي الحديث من تجاوز النظرة السكولائية، وتأسيسِ نظريَّةٍ في المعرفة قائمةٍ على العقل وعلى التجربة، وكيف استفاد من تطوُّر العلم في جعل هذه النظرية تنويرية، نقدية، ونسقية شاملة؟
8- المشكلة الرابعة: في الفلسفة المعاصرة
كيف عبر الفكر الفلسفي المعاصر عن الهموم الأنطولوجية والروحية للوجود الإنساني، وكيف دعا ـ على أساسٍ من تحليل الظواهر وتوضيح الأفكارـ إلى نبذ ما وراء ذلك الوجود، والتحوُّلِ نحو ما يميزه من علم وعمل نافع ؟
(5) المشكلة الأولى
[تاريخ الفلسفة اليونانية]
كيف استطاع العقل اليوناني الوصولَ بالفلسفة إلى أوجها،
بعد أن كان مكبَّلا مدة قرون بقيود الخرافة،
وكيف دعا الإنسانَ إلى استثمارها في حياته الخاصة؟
***
مقدمة: طرح المشكلة
I- ماذا.. فوق الأشياء ؟
أولا: الوضعية المشكلة الأولى: الموت والنجاة منها
ثانيا: الوضعية المشكلة الثانية: أسطورة "عقب أخيلوس"
II- ماذا.. وراء الأشياء؟
أولا: النوع الأول من الوضعيات المشكلة: العناصر الأولى المادية و المجردة للأشياء
ثانيا: النوع الثاني من الوضعيات المشكلة: ماذا... و راء الإنسان؟
ثالثا: النوع الثالث من الوضعيات المشكلة: العالم الذي تستقر فيه الحقيقة المطلقة
رابعا: النوع الرابع من الوضعيات المشكلة: علل الأشياء و الحكمة منها
III- كيف.. نعيش مع الأشياء؟
أولا: الجزء الأول من الوضعية المشكلة العامة
ثانيا: الجزء الثاني من الوضعية المشكلة العامة
خاتمة: حل المشكلة
مقدمة: طرح المشكلة
إن الفكر اليوناني حاول ـ على العموم ـ الإجابة عن أسئلة ثلاثة كبرى، هي:
ماذا.. فوق الأشياء؟ وماذا.. وراء الأشياء؟ كيف.. نعيش مع الأشياء؟
I- ماذا.. فوق الأشياء؟
سنقدم تحت هذا السؤال الكبير، وضعيتين مشكلتين، بالعرض والتحليل كل واحدة على حدة، لنكتشف خصائص الفكر اليوناني اللاهوتي[1] الذي كَبـَّل مدة قرون، الروحَ الفلسفية:
أولا: الوضعية المشكلة الأولى
1- عرض: لنتأمل معا، الوضعية المشكلة الآتية:
شخصان يمشيان معا، أحدُهما يتسلق شجرة عالية، وعند مبلغ قمتها يسقط منها، وينجو من الموت، والآخر تعثَّرت به قدمه، عند جذورها الملتوية، فسقط ميتا.
2- تحليل: إن الافتراضات التي تساعدنا على تفسير هذه الظاهرة، لا تتعدى افتراضين اثنين، أحدهما علمي، يقوم على رد الأشياء إلى أسبابها؛ والآخر لاهوتي، يعزو وقوع الأشياء مباشرة، إلى الإله[2].
في الافتراض الأول، قد يتجه التحليل إلى ذكر عوامل موضوعية، وأخرى ذاتية. أما الموضوعية، فيمكن تلخيصها في كون الناجي منهما، أشدَّ مقاومة وأخف جرحا وأكثر ممارسة للتسلق وللرياضة، وأوسعَ حظا في الوقوع على أرضيةٍ أوفرُها رطوبة؛ و يُحتمل أن يكون من ناحية العوامل الذاتية، أصلبَ عزيمة وأعظم حذرا وتحملا. ومن الأسباب التي يضعها التفسير في الحسبان بالنسبة إلى الهالك، نزيفٌ دمويٌّ في مستوى الدماغ أو سكتة قلبية، أو تسمم في الدم.
وفي الافتراض الثاني، لا يرى العقل في كل هذه الأسباب، ما يطمئن إليه، أمام قوة إيمانه بالإله الذي يخلق الأشياء، ويحركها. فإن العلم يبقى عاجزا أمام إرادة هذا الإله، ومشيئته وقدرته وعلمه. فهو الذي يهيئ أسباب الظاهرة، ويقرر موت هذا، ونجاة ذاك.
إن هذا التفسير الذي يردُّ ـ رأسا ـ شؤون الأشياء إلى الإله، ليس جديدا في ثقافة الناس عبر التاريخ. إننا نجده قد بلغ ذروته مع مفكري اليونان، وخاصة في الفترة ما بين القرنين العاشر والثامن قبل الميلاد.
ثانيا: الوضعية المشكلة الثانية
1- عرض: لِنُصغ إلى هذه الأسطورة المعروفة بـ "عَقِب أخيلوس"[3]:
في الميثولوجيا اليونانية، وخاصة في إلياذة هوميروس، لا يُدعى شخص بطَلا، إلا لأنه ابنٌ لإلهٍ ولأُمٍّ عادية أو العكس، اِبنٌ لأب عادي ولأم إلهة، فهو ذو هيبة، باعتبار قدسية ولادته، ولأنه بالضرورة، محارب وقائد، مثل القواد العسكريين في حرب طُرُوَادَة.[4]
فالبطل أخيلوس هو ابن شخص عادي ـ هو الملك بولي (Pelée) ـ وإلهة المياه والغابات ـ ثيطيس (Thétis) ـ غطَّسته أمه، وهو صبيٌّ في مياه مقدسة، لتجعل منه كائنا ذا مناعة، لا يدركه ضرر. ولكنها، عندما غَطَّسته في هذه المياه، كانت تحمله من عقبه الذي لم يتبلل بالماء، وبالتالي لم يستفد من بركة المياه المقدسة. لقد برز أخيلوس في حرب طروادة، وكان يخيف عدوَّه بما كان يرتديه من واقية معدنية لامعة، ولكن، بعد عشر سنوات، وبينما لم يتغير موقع الإغريقيين ـ ما داموا راسين على الشواطئ مع بوارجهم ـ إذا بمشاجرة تحتدم في صفوفهم بين أخيلوس وذراعه الأيمن ـ آغامنون ـ بسبب تقسيم الغنيمة. وكان هذا الأخير، قد سَجن عنده بنتَ قسِّ أبولون[5] لدى الطرواديين. إن هذا الإله، ناصر الطرواديين وضرب بالسهام الجيش الإغريقي. وعلى إثر ذلك، انتشر وباء؛ و هو الأمر الذي أجبر آغامنون على تسليم السجينة لوالدها. ولقد قرر أخيلوس ألا يشارك بعد، في الحروب، هو ورجالُه. إلا أن الأحوال تغيرت، وأخذ الطرواديون الغلبة، ولم يعد أيُّ إغريقي قادرا على مواجهة هيكتور، القائد الطروادي. ولم يتقرر لدى أخيلوس ردُّ فعلٍ، حتى في الحالة التي استطاع الطرواديون اختراق خطوط الإغريقيين، وحرق سفنهم.
لقد استطاع أحد أصدقائه، أن يقنعه بقيادة الجيش، موهما العدوَّ بأنه أخيلوس بنفسه، وبتجهيزه الحربي؛ اِستطاع أن يدفع العدو إلى الوراء؛ ولكن، على الرغم من تعليمات أخيلوس، فإن هذا القائد الجديد، لم يستطع تجنب هكتور، فهلك وسُرقت منه الأسلحة التي كان يحملها، والتي ليست سوى أسلحةِ أخيلوس. وعندئذ، تقرر لدى أخيلوس الانتقامُ لصديقه. وتقرر لدى أمه، أن تمده بأسلحة جديدة. لقد عظم الأمر إلى درجة أن انشغلت به الآلهة، وطلبت من زيوس التدخل. وبعد النظر في قضية الرجلين، ظهر أن وزن مصير أخيلوس أثقل، وهذا يعني، الأمر بموت هكتور. ففر هكتور، واستطاع أخيلوس أن يداركه، فوقعت بينهما حرب، هلك فيها، هكتور استجابة لمصيره. هذا، ولقد تنبأ الكهنة بموت أخيلوس التي ستتبع هلاك هكتور بثلاثة أيام. وفعلا، لقد قُتل أخيلوس في اليوم الثالث، بسهم مسموم أطلقه أخٌ لهكتور، فأصاب عقبه، وهو ـ كما قلنا ـ الجزء الصغير من جسده الذي لم ينغمس في الماء المقدس.
2- تحليل: هذه الأسطورة التي يحكيها هُوميروس في الإلياذة، تعكس لنا الارتباط الروحي الوثيق بين الأحداث وقرارات الآلهة، وتبرز كيف أن المعركة فيما بين الآلهة، تؤثر في أشياء العالم، وكيف أن ما يجري في عالم الأشياء، يجد تفسيره في ما فوقه. وهي لا تأخذ معناها، إلا بإرجاعها إلى سياقها الثقافي، وهو سياق يتعامل مع الخرافة والسحر والقُوى الخارقة للطبيعة. وهذه القوى، تتجسد في وجود آلهة، لا شكل لها، أو آلهة بشرية تتمثل في أشخاص، أو مادية مثل الكواكب والأشجار والصواعق.
ففي هذه الأسطورة، لا نفهم جيدا، كيف اكتسب أخيلوس البطولة والغلبة، إن لم نربطها بقصة ولادته المقدسة من جهة أمه، إلهة المياه والغابات؛ ولا يمكننا أن نفهم أيضا، تخاذل جيش الإغريقيين من جهة، ثم هلاك عدوِّهم هيكتور، وكذا مصير أخيلوس، من غير إرجاع ذلك، إلى زيوس إله الصواعق وثيطيس إلهة المياه.
هذا هو التفسير اللاهوتي، كما يسميه ـ بعض علماء الاجتماع ـ الذي يتعامل بالفطرة، مع الخيال ومع القوى الخارقة فوق الأشياء، وفي كلمة، مع الآلهة ومعجزاتها.
وفي التعقيب على هذا التحليل، نقول:
لا شك في أن الإنسان فيما قبل التاريخ، واجهته ظواهر طبيعية استغربها، وحاول أن يفهمها. وقد نتساءل عما هي الأساليب الأولى التي يحتمل أن يكون قد لجأ إليها، في محاولته لفهمها، وكذا لإراحة فضوله؟
أ- لقد وجد الإنسان البدائي نفسه، أمام جملة من الظواهر الطبيعية، وكانت هذه الظواهر أكبر منه قوة وأشد منه بأسـا؛ وكان عليه، لكي يحمي نفسه من غائلة هذه الظواهر، أن يعرف كُنهَها ـ أي حقيقتها ـ وأن يجد لحدوثها، تفسيرا. كيف إذن، يقي حياته من أن تطيح بها الطبيعة المتمردة من حوله. وكيف يسيطر على تلك الطبيعة ويُخضعها لإرادته، بدلا من أن يَخضع هو لإرادتها: فأين يذهب من العواصف التي تطيح بمسكنه، وأين يفر من الرعد الذي يصم آذانه، ومن الأمطار التي تغمر الأرض، وكذا من دواهي الزلازل والبراكين والأعاصير؛ وهي كلها أمور تثير الخوف والدهشة والعجب. وعندما يثار الخوف، يجنح الإنسان إلى الخيال بحثا عما يرضي فضوله.
إن إيمان الناس بالآلهة، يرجع إلى التأثير العظيم الذي تتركه في نفوسهم، عظمةُ العالم وجماله وقوانينه المُحْكَمَة. ولقد اعتقدوا دائما، عبر العصور، في قوة قاهرة ومدبرة فوقهم، هي الله أو الإله بمفهومه الأوسع.
ب)- وعندما تثار الدهشة، يأخذ الإنسان في التفكير والبحث عن السبب. وعندما يرجع إلى نفسه وخبرته الذاتية كمصدر للمعرفة، يجد أنه من الممكن، أن يرى نفسه في أماكن مختلفة في الأحلام، يتحدث ويروح ويجيء ويحارب ويغضب ويفرح، في حين أن جسمه يظل ثابتا في مكانه، أثناء النوم. ولما كان ذلك الكائن الذي يراه في أثناء النوم، يستطيع أن يخترق الحجُب، ولا يتقيد بطبائع الأشياء، اعتقد أنه من طبيعةٍ مخالفة لطبيعته، وأسمى هذا الشيء، بالروح أو النفس. واعتقد أن هذه الروح تسكن جسمه و تغادره مؤقتا في أثناء النوم، ثم تغادره نهائيا، عند الموت. ولقد عزا إليها، حركته وسلوكه، واعتقد أنها مسؤولة عن كل ما يصدر عنه.
ج- وكذا نسب إلى الطبيعة الجامدة أرواحا كروحه هو، وعزا "أفعالها" وظواهرها إلى إرادة خفية يتصوَّرها على نحو ما يتصور إرادتَه هو، إرادةً تعمل بحرية ذاتية، دون تقييد بقانون أو نظام، ودون خضوعٍ لمنطق العلل، بل إن هذه القُوى الخفية أو الأرواح أو الآلهة أو النفوس التي تسكن أجسامنا، كانت هي نفسُها في نظره، العللَ الأولى للأشياء، ولحركات الإنسان. أليس في يدها أن تُحييَ الإنسان أو تميته؟ أليس في يدها أمر حمايته أو الإطاحةُ به أو هلاكه؟ ومن هنا، كان لا بد من أن يتعبَّدها، وأن يبتهل لها، ويتوسل إليها. ومن هنا أيضا، كانت الطقوس والسحر والتعاويذ والعادات الغرِيبة التي لا نزال نرى الكثير منها، في ثقافتنا الحالية.
د- هذه هي المرحلة الأولى مرحلة التفكير الخرافي، حيث حاول الإنسان أن يجيب عن هذا السؤال: ماذا فوق الأشياء، حيث كان يُسند إلى الكائنات الطبيعية حياةً روحية شبيهة بحياة الإنسان، ويعزو إلى هذه الأرواح، جميع ما يحدث في هذا الكون من ظواهر.
II- ماذا.. وراء الأشياء؟
للرد على هذا السؤال الثاني وهو الأوسع، نحاول تأمل أربعة أنواع من الوضعيات المشكلة:
أولا: النوع الأول من الوضعيات المشكلة: وهو يدور حول العناصر الأولى المادية والمجردة للأشياء.
1- أمامك الوضعيات المشكلة التالية والخاصة بالأشياء الفيزيائية:
أ- إذا كانت الحياة تنبعث حيث يكون الماء، وتنعدم حيث ينعدم، ألا يمكن اعتبار الماء، الأصل الأول في وجود الأشياء؟
ب- وبالمثل يمكن التساؤل، إذا كانت الأرض قرصا أو جسما يسبح في الهواء، وكان هذا الهواء يشعُّ في كل أنحاء الوجود، ألا يمكن اعتبار الهواء، السبب الأول في صدور هذه الأشياء التي يحتوي عليها الكون؟
ج- وفي سياق هذا المنطق، ألا يمكن التفكير أيضا، في النار كأصل يقف وراء عالَم الأشياء الذي لا يتوقف عن الحركة والاحتكاك، ؟ ويمكن تحويل التساؤل أيضا، إلى مستوًى تجريدي حيث نتحدث عن الحب والنفور، والجوهر الفرد، والقوة العاقلة، والعدد، ونحو ذلك؟[6]
ففي نطاق الوضعية المشكلة الأولى، نقول بأنه من الفلاسقة الذين ردوا أصل الكون إلى الماء، طاليس (621- 550 ق.م تقريبا):
لقد انطلق من الفرضية التالية، وهي أن الأشياء على رغم من تغيرها وتنوعها، واختلاف بعضها عن بعض، تشكل عالما معقولا، وترتد إلى مبدأ واحد هو الماء. ومن الحجج التي يؤكد بها صدق هذه الفرضية، أن الحياة تدور مع الماء، وجودا وعدما، فتكون الحياة حيث يكون الماء، وتنعدم حيث ينعدم؛ وأن الماء يستحيل إلى صور متنوعة، فيصعد في الفضاء بخارا، ثم يعود، فيهبط فوق الأرض مطرا، ثم يصيبه برد الشتاء، فيكون ثلجا؛ وهكذا، يكون غازا حينا، وسائلا حينا، وصلبا حينا. وكل ما يقع في الوجود، لا يخرج عن إحدى هذه الصور الثلاث؛ فلا فرق بين هذا الإنسان، وتلك الدابة وذلك الجبل إلا الاختلاف في كمية الماء الذي يتركب منها، هذا الشيء أو ذاك؛ هذه حقيقة مطلقة، يؤمن بها طاليس، إلى درجة أنه خيل إليه، أن الأرض قرص متجمِّد، يسبح فوق لجاج مائية ليس لأبعادها نهاية.
و في نطاق الوضعية المشكلة الثانية، يفترض أنكسمينس (588-524 ق.م. تقريبا) أن هذا الشَّتات الذي تتقدم به الأشياء المتنوعة في الاختلاف، ليس سوى قرصٍ مسطوح يسبح في الهواء. ومن الأدلة التي يستند إليها، أن الهواء يشيع في كل أنحاء الوجود؛ فإذا تكاثف حينا، كان شيئا، وإن هو تخلخل حينا، كان شيئا آخر. فإذا هو أمعن في تخلخله مثلا، انقلب نارا، حتى إذا ارتفعت، كوّنت الشموس، والأقمار. وإذا هو أمعن في التكاثف مثلا، انقلب سحابا، ثم أنزل السحاب ماء، ثم تجمد الماء، فإذا هو تربة وصخور.
وفي نطاق الوضعية المشكلة الثالثة، يرى هرقليطس (540-480 ق.م) أن الأشياء تتغير باستمرار، ومصدر ذلك، النار؛ وهذا، لأن طبيعة النار، أن تحرق، والاحتراق تغير. فكل الأشياء في العالم، ظواهر لا تكف عن الاحتراق؛ وبهذه العملية، يتحول الشيء باستمرار إلى الآخر؛ وليست هذه الحياة التي تدب في الأحياء، وهذا النشاط العقلي الذي يُميّز الإنسان، إلا قبسا من تلك النار؛ فكلما كثرت النار في جسم، ازدادت حيويته، واشتد نشاطه؛ وكلما أظلم الشيء ـ أي قل ما فيه من نار ـ كان أقرب إلى الموت واللاوجود.[7] و بتعبير آخر، كل شيء يخرج من النار، وإلى النار يعود؛ لأن الوجود في الحقيقة، عملية مستمرة للصيرورة؛ وعملية التحول هاته، تأخذ اتجاهين: طريقا صاعدا، وآخر هابطا: ـ فالصاعد يبدأ من التراب ثم الرطوبة ثم النار؛ ـ والهابط، من النار إلى الرطوبة، فالتراب. ويرى أن التوازن متساو تماما، و هو تحول حقيقي بين العناصر: "إن النار تحيي موت التراب، والهواء يحيي موت النار، والماء يحيي موت الهواء، والتراب يحيي موت الماء". وهكذا، تتحول كل الأشياء للنار. يقول هرقليطس: "كل الأشياء تتتابَعُ، ولا شيء يثبت. فأنت لا تستطيع، أن تنْزل مرتين في النهر نفسه، لأن مياها جديدة، تجري حولك متتابعة"،"وأما التعارض والشقاق، فليسا في رأيه، شرا بل هما خير. والناس لا يعرفون كيف أن التنوع، يتفق مع نفسه" وذلك، لأنه "من الشقاق والتعارض تتولد كل الأشياء". وفي كلمة، هذه النار العالمية، هي عملية التغير، وهي قانون الكون، وهي الإله نفسه، فهو "نهار وليل، شتاء وصيف، حرب وسلام...". هذا عن أصل الأشياء في مستواها المادي.
2- ويمكن تحويل التساؤل أيضا، إلى مستوًى تجريدي حيث نتحدث عن الحب والنفور، والجوهر الفرد، والقوة العاقلة، والعدد، ونحو ذلك؟ ونتطرق، في هذا الإطار إلى أربع وضعيات مشكلة حيث نتساءل: ألا يمكن رد الأصل الأول للأشياء - إلى الحب والنفور، أو ـ إلى الجوهر الفرد أو ـ إلى قوة عاقلة أو ـ إلى العدد؟
أ- ألا يمكن رد أصل الكون إلى نسبة الامتزاج فيما بين العناصر الأربعة التي يحددها الحب والنفور؟
يرى إمبذوقليس (Empedocles ، ت. حوالي 490 ق.م)، أن نشأة الأشياء ترتد إلى عناصر أربعة: التراب والماء والهواء والنار؛ وهي عناصر لا تنقطع فيما بينها، عن الاتصال والانفصال والاختلاف؛ وذلك، تبعا لتفاوت نسبة المزج فيما بينها. ومحرك هاته العناصر، قُوَّتان متضادتان هما الحب والنفور.[8]
ب- ألا يمكن رد أصل الأشياء إلى الجوهر الفرد؟
يعتقد ديمقريطس (حوالي 460-370 ق.م) وأصحابه بأن أصل الأشياء، هو عنصر واحد متجانس، يدعونه الجوهر الفرد أو الذرة. ودليلهم في ذلك، أنه لو فكَّكنا الأشياء إلى جزئياتها، لانتهينا إلى وحدات لا تقبل التقسيم، هي لا نهائية العدد، وتبلغ من الدقة، حدا يتعذر معه إدراكها بالحواس، وهي خالية من الصفات. أما الصفات التي ندركها في الأشياء، فهي ناشئة عن كيفية ائتلاف الذرات في تكوينها للأجسام.
ج- ألا يمكن رد أصل الأشياء إلى العقل؟
وفي الرد على هذا السؤال، يعتقد أناكساغوراس (500 ق.م.- ؟ ) أن وراء الأشياء، قوة عاقلة مجردة ذكية وبصيرة، تدبر شؤونها، فتولد الحركة في الأشياء، إقبالا وإدبارا حتى تتكون منها العوالم. وأساس هذا الاعتقاد، انبهاره من نظام الكون وجماله وتناسقه، وكذا استنتاجُه بأنه يستحيل على قوة عمياء، أن تُخرج هذا العالم في هذه الدقة والتناغم والجمال. إلا أن العقل لم يَخلق المادة من عدم، بل هما عنصران قديمان أزليان، نشأ كل منهما بذاته، ثم طرأ العقل على المادة، فبعث فيها الحركة والنظام.
د- وأخيرا، ألا يمكن رد أصل الكون إلى العدد؟
إذا كان أصل الأشياء هو الماء عند طاليس، والهواء عند أنكسمينس، فإنه عند أصحاب فيثاغوروس (ت. نحو 600 ق.م)، العدد كمفهوم مجرد. فالأشياء مهما اختلفت صفاتها وأعراضها، في مستوى المشمومات والمسموعات والمرئيات وغيرها، فهي تتأسس على العدد؛ فكلٌّ من السوائل والغازات والصلبيات، لا بل كل عنصر أو نوع داخل الصنف الواحد، له عدده؛ وبتعبير آخر، لا يمتاز شيء عن شيء إلا بالعدد. ومن هنا، نستخلص أن العدد هو جوهر الوجود وحقيقته؛[9] فكل ما تقع عليه عيناك، مركب من أعداد. ولما كانت الأعداد كلها متفرعة عن الواحد، لأنها مهما بلغت من الكثرة، فهي واحد متكرر، كان الواحد أصل الوجود، عنه نشأ، ومنه تكوَّن. هذا عن أصل الأشياء في مستواها المجرد. وهذا كله عن النوع الأول من الوضعيات المشكلة.
ثانيا: النوع الثاني من الوضعيات المشكلة: ماذا... وراء الإنسان، هل هو مصدر الحقيقة؟
ويمكن اختصاره في هذه الوضعية المشكلة العامة: إذا كانت الأشياء في بعض أجزائها، تمثل الإنسان، وجب أن نتساءل ماذا وراء الإنسان، هذا الكائن الذي يعود إليه فهم الطبيعة، وما وراءها؟ هل حواسه هي مصدر المعرفة، وهي ميزان الحقيقة؟ هل الحقيقة تابعة لحواسنا، فتختلف من هذا الشخص إلى ذاك، أم هي ثابتة يُقرِّرها العقل؟ يمكن حل هذه القضية، في جزأين:
1- الجزء الأول: ماذا لو انطلقنا من أن حواسنا هي التي تقف وراء كل معرفة للأشياء؟ وأنها تختلف باختلاف الناس؟
يرى السفسطائيون[10] ـ وكانوا جميعا من أهل البراعة والحذق أمثال غورجياس وهيبياس وبروتاغوراس ـ بأنه ليست ثمة، حقيقة مطلقة بل حقائق، لأن حواسنا هي مصدر المعرفة، وميزان الحقيقة، وهي التي تحدد مدى صواب الأمر. إنها تُظهر لنا العالَم الحسي متغيرا ومتكثرا. يقول كبيرهم وهو بروتاغوراس: "الإنسان مقياس كل شيء"؛ فإذا بدا لك الشيء ناقة فهو ناقة، وإذا بدا لي نخلة فهو نخلة. ولقد ساروا على هذا المبدأ، في تعليم الطلبة البلاغةَ والجدالَ بحيث يخدم كل واحد منهم، قضيته من أي سبيل، أي بالمنطق الذي يرى فيه المصلحة والفائدة، بالسفسطة أو بغيرها.
2- الجزء الثاني: ولكن ماذا.. لو قلنا: إن الحقيقة واحدة وأنه يُقرها العقل؟
يذهب سقراط، إلى أن الحقيقة، يقرها العقل، وأن حواسنا تخدعنا، ولا تدرك الموجودات كما هي في حقيقتها، بل كما تبدو لحواسنا. وليست الحقيقة مجرد أمر فردي؛ وبذلك، يثبت ما أنكره السفسطائيون، وهو أن وجود الحقائق الثابتة تتجاوز حواسنا، ومُعلِنا "أن كل ما أعرفه هو أنني لا أعرف شيئا". والتفلسف يبدأ عندما يبدأ الإنسان يمارس الشك وخصوصا، الشك في الحقائق المقررة التي يؤمن بها، ويقدسها، كالمدركات المألوفة والبديهيات والمعتقدات.
وبهذه الطريقة، رفض سقراط كل شيء في الأساطير التقليدية والمعتقدات الدينية التي لا تتفق وكون الله خيرا. إن الإنسان ليست لديه معرفة مؤكدة عما هو خير في الحياة. ولكي يحيا حياة فاضلة، من الضروري أن يعرف الخير.