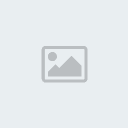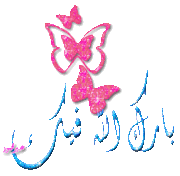ملاحقة سلطة المعنى
أو دريدا مفككا للميتافيزيقا
محمد طواع
المجلة العربية للعلوم الادبية
سنفكر في هذا العنوان مع دريدا Derrida وبنصوصه، معتبرين ذلك محاولة للاقتراب من الأفق الفكري الذي عقد حوارات مع الميتافيزيقا(*) من أجل مجاوزتها.
المجلة العربية للعلوم الادبية
I – الكتابة والميتافيزيقا:
أما السؤال الذي سنجعل منه منفذا للتفكير مع دريدا وهو يحاول تفكيك الميتافيزيقا هو الآتي: بأي معنى يعتبر الفكر الغربي في مختلف أعراضه بتصور واحد للكتابة، التصور الذي يقيم هذه الأخيرة (= الكتابة) على الصوت واللوجوس؟
تجدر الإشارة بداية، إلى أن دريدا، لا يخرج، في مفهمومه لهذا الذي نسميه فكرا غربيا، عن تصور هيدجر للميتافيزيقا. وذلك لأنه يربط مفهومه للكتابة بتاريخ الفكر الغربي منذ بدئه مع سقراط الذي يعتبر لحظة انقلبت معها مجموع القيم حين اعتبر الفكر هو القيمة الحقيقية "للطبيعة الإنسانية"، وأنه على النظام التربوي أن يهذب النفس من أجل صيانة هذه الطبيعة وذلك لأنها مهددة دوما بحمق الجسد وبمقوماته الحسية، وينبغي لهذا النظام أن يكون لا نهائيا لأن ثمة عالم الأهواء الذي يهدد رصانة العقل. وإذا كان الإنسان جسدا ونفسا تفكر، وبما أن هذه الأخيرة تتميز بالخلود والتعالي، فإنه يتعين علينا صيانتها بشكل دائم عن طريق التربية حتى يتسنى لعين النفس أن تتخلص ما أمكن من ظلال الكهف وضلالاتها وتتمكن من رؤية تقوم على العقل الذي ينبغي له أن يوجه الإنسان نحو الأعالي، نحو الآيديا الذي يتميز بوجود أنطلوجي متعال؛ على العقل، بوصفه المستوى الجوهري داخل النفس، أن يعمل جاهدا من أجل أن تحاكي ماهيته ماهية هذا العالم، عالم الآيديا. من هنا حصل انشطار الوجود إلى عالمين متنافرين، عالم يمثل الحقيقة وعالم يمثل الضلال.
فمنذ هذا العمل السقراطي ستصبح مسألة المعنى والكتابة هي مسألة الماهية. وستتخذ صيغة السؤال، الذي ظل يحكم الميتافيزيقا، الشكل الصوري التالي: "الشيء-ما هو؟" أي أن لكل شيء ماهية تتميز بالحضور والجوهرية: فالفكر جوهر الإنسان وطبيعته الحقة. وهو بهذا قابل للنقل في حضوره وصفائه، من رأس إلى رأس عن طريق الحوار وفن الجدل والمايوتيقا، أو يتم نقله عن طريق اللغة بوصفها موجودا يسمي الأشياء ويقوم بإيصال الأفكار بين العقول، خاصة وأن الأفكار ماهيات، ونحن نعرف مع أفلاطون أن الماهية لها سبق أنطلوجي في الوجود قبل اللغة أو الكلام.
يرى دريدا أنه من داخل هذا الإطار الميتافيزيقي, تأسس للفكر الغربي مفهوم ما للكتابة وللغة يقوم على مفهوم الدليل منظورا إليه في ثنائيته المنشطرة إلى مكونين متباعدين وهما الدال والمدلول. ومن هذا المنظور لا كتابة تقوم إلا على التمييز المطلق بين التلفظ والملفوظ. فاللفظ مرتبط بالتلفظ والنطق والتنفس واللسان والأذن ويعمل على تبليغ "معنى" ينبوعه الصوت الباطني المستور في النفس أو الخاطر ينتظر الكلمة أو الإشارة لكي تبينه أو تكشفه. ومن ثمة فجميع هذه الكلمات (= اللفظ، النطق، الصوت، النفس، المعنى، الدليل…) تقوم على ذلك التصور الذي ينظر إلى المعنى بوصفه أصلا وماهية وحضورا. وهو تصور ميتافيزيقي تم تكريسه بشكل عميق مع فلاسفة الأزمنة الحديثة: فالحقيقة مع ديكارت ترادف مفهوم اليقين، أو أنها الحدس وقد أصبح تمثلا يقينا أو رؤية تتراءى في الأمام، أمام الذات، لتأتي اللغة والكتابة بعد ذلك للتعبير عنه وتبليغه إلى المتلقي أي لكي تلقي به في الخارج ليعيش سقطته مع الكتابة.
وقبله نجد أرسطو يقول في العبارة ما يلي: "ينبغي أن نضع أولا ما الاسم وما الكتابة ثم نضع بعد ذلك ما الإيجاب وما السلب وما الحكم وما القول، فنقول إن ما يخرج بالصوت دال على الآثار التي في النفس وما يكتب دال على ما يخرج بالصوت"(1). إن رنين الصوت هو رمز لأحوال النفس التي تتضمن بشكل قبلي، معقولات ومتصورات ومتخيلات.فتأتي الألفاظ والكتابة بعد ذلك كملحقات بما يخرج من النفس جوهريا عبر الصوت من أجل التحبير. وفي سبيل ذلك تشكل الكلمات المكتوبة رموزا للكلام الذي يبثه الصوت عند النطق.
هذا يدل على أن الميتافيزيقا، من خلال أرسطو، تعتقد أن عالم المعقول والتصور والمتخيل عالم جواهر أو ماهيات لها وجود أنطولوجي سابق على كل من الصوت والكتابة أو التحبير. ويشرح الفارابي ما ذهب إليه المعلم الأول بقوله إن: "ما يكتب دال على ما يخرج بالصوت يعني به الخطوط"(2).
يرى دريدا أنه منذ أفلاطون وأرسطو تم إقصاء قدرة الحواس على إقامة الحق. وفي مقابل ذلك أقيم مفهوم الحق على مفهوم اللوجوس أو العقل بصفته لوجيا, وهو إقصاء يقوم على رؤية الميتافيزيقا إلى ماهية الإنسان بوصفه جسدا ونفسا تفكر. ومنذئذ تشكل تراث فكري نبذ كلا من الذاكرة والحواس وما يقوم عليهما من حقيقة. وهو تراث عرف بتمركزه على لوجوس وصوت النفس. وبناء على هذا الأساس الذي يتمركز على العقل تم تحديد نمط الكتابة الصواتية-المفهومية الذي يقوم على خطية الزمان المنطقي أي على خطية زمان الوعي والتمثل اللفظي.
يرى دريدا، أيضا، أنه مع هذا الثرات الميتافيزيقي، أصبح ينظر إلى المعنى باعتباره حضورا كأصل، أي أنه في البدء يتميز المعنى بوجود أنطلوجي مطلق، وهو الأيدوس: المعنى هناك، في نقائه وعذريته حاضر أي أنه جوهر قار ومستقر خارج الزمان وفعل سيرورة الكتابة أو القراءة من حيث هما تحويل للمعنى وتفضيل له عن معنى آخر. وبهذا تضحى الكتابة مع الميتافيزيقا تعبيرا ماديا، إذ تأتي وأدواتها، كالورق والحروف المرسومة عليه كآثار، لتحفظ ما يتم نسخه من عبث مفعول الزمان وتقيده. فالكتابة بهذا المعنى قيد. أو نقول إنها مجرد تحبير.
يقول دريدا: "بين الكتابة الصواتية وبين اللوجوس (أو بينهما وبين زمان المنطق) الذي يسيطر عليه مبدأ عدم التناقض، بوصفه المبدأ المؤسس لميتافيزيقا الحضور بأكملها، تعالق عميق"(3).
بعد هذه البداية، نتساءل مع دريدا بأي معنى تكون مجاوزة الميتافيزيقا ممكنة؟
إن مفهوم المجاوزة عند دريدا سيتحدد على شكل تفكيك، نعم، ولكن ما هو المنفذ الذي يسمح بولوج عالم الميتافيزيقا من أجل مجاوزته أو تفكيكه؟
يرى دريدا أنه لمجاوزة الميتافيزيقا ينبغي أن نجعل مفهوم الكتابة المتداول موضع سؤال، وأن نفكر في ذلك من خلال مجموع النصوص الفكرية وغيرها، التي عملت على تأزيم مفهوم الكتابة الميتافيزيقية وما يقوم عليه من أسس فلسفية نحتتها ووضعتها مسلمات تاريخ الميتافيزيقا بأكمله. من هنا استهوته مجموعة من الأعمال الفكرية التي كانت لها مساهمتها الأساسية داخل الاستراتيجية العامة التي عقد الفكر الغربي العزم على تدشينها والتفكير من داخلها في أسسه وقضاياه ولغته، مثل أعمال فرويد التحليلية-النفسية وأعمال دوسوسير اللسانية.
إن دريدا وهو يحاور فرويد وما انتهت إليه أعماله من تكسير لنرجسية الذات بوصفها وعيا أو كوجيطو يحضر في وضوح وتميز أمام نفسه كلما أراد ذلك، قد طالبنا بأن نقرأ فرويد مثلما قرأ هيدجر الفيلسوف إمانويل كانط(4).
وهذا مؤشر على أن عمل دريدا التفكيكي يشكل مساهمة لها تفردها وما يميزها، داخل الاستراتيجية العامة لمشروع مجاوزة الميتافيزيقا بصفته مشروعا لا نهائيا. لقد اتخذ مشروع المجاوزة مع دريدا شكل تفكيك، تفكيك الأزواج الميتافيزيقية المتعارضة، وقد جاء على شكل تأمل نقدي للأزواج المتداولة مثل: الكلام/الكتابة، الروح/الجسد، الدال/المدلول، العقل/اللاعقل، كلام الشعور/كلام اللاشعور… وهو تأمل نقدي لا يمكن إنجازه إلا داخل النظام الذي نريد تفكيكه سواء مع نص من تاريخ الفلسفة أو مع نص أدبي. غير أن الهدف الذي يركز عليه التفكيك هو مفهوم الكتابة الذي تم إرساؤه طيلة تاريخ الميتافيزيقا(5). ويقيم مشروعه التفكيكي على الفرضية الآتية:
هناك وحدة تاريخية متماسكة بشكل قوي، يلزم تحديدها كما هي، لأنها تشكل الشبكة المحددة لرؤية الميتافيزيقا، هذه الوحدة يجسدها النزوع نحو التمركز على العقل، أو النزعة نحو إضفاء المعقولية على كل شيء. هذه النزعة التي بلغت تمامها لما تأسست بشكل موضوعي في ما أشار إليه "فوكو" في نظريته حول السلطة من خلال مقاربته لحقيقة مؤسسات الترويض والعزل والتربية التي يتجسد معها ما وضعه الغرب من اقتصاد سياسي للجسد.
إن هذه النزعة العقلية هي الأساس الذي تقوم عليه كل مثالية أو كل نزعة روحية أو كل ميتافزيقا في مختلف تشكلاتها. يذكرنا هذا القول في ما ذهب إليه هيدجر حين اعتبر أنه سواء قلنا مثالية أو أفلاطونية أو ميتافيزيقا فإننا نقول الشيء نفسه.
وبناء على ذلك فإن كل مجاوزة للميتافيزيقا، وخاصة في نظر دريدا، ينبغي أن تلاحق هذا الأساس المحدد لكل الأشكال الفكرية الميتافيزيقية بغية تفكيكه، وذلك من خلال تقويض الأزواج المتعارضة التي قامت على هذا الأساس ليتحدد معها تصورنا للفكر وللمعنى وللحقيقة وللتاريخ وللصورة التي ينبغي أن يتخذها السؤال، هذه الصورة التي هندس تصميمها سقراط على الشكل الآتي: "الشيء، ما هو؟" أي ما هويته؟ أو بلغة أرسطو، ما هي مجموع المحمولات أو المقولات التي تحصر ماهية ما نتساءل عنه، وكأننا دوما في البحث عن مدلول متعال متماثل في ذاته ويحكم نسيج النص والكتابة.
وبناء على تأملصورة السؤال هذه يمكن أن نقول مع دريدا إن مختلف المفاهيم التي نحتت مع الميتافيزيقا تقوم على مفهوم الحضور أو الماهية، بصفتها الأساس الذي تقوم عليه مسألة المعنى والحقيقة والقول والكتابة. في محاورة فيدروس، تتعارض كتابة الحقيقة في النفس مع الكتابة التحبيرية. ومنذ إرساء هذا التعارض بين كتابة صوت النفس وبين كتابة اليد التحبيرية، أصبح ينظر إلى الكتابة كملحق باللوجوس.
وضدا على مفهوم الحضور؛ ومن داخل استراتيجية التفكيك اللانهائية والعامة؛ يستعمل دريدا مفهومي التباعد والتغاير. وذلك لأنه ليس ثمة ذاتية متجانسة وحاضرة أمام نفسها بشكل منغلق. إن كل ما هناك هو التباعد: إن للذات مسافة ما بينها وبين نفسها. هذا التباعد يتخذ شكل حركة إجرائية مولدة للدلالة. وعليه، فليس هناك انسجام ولا تجانس، كل ما هناك هو التصدع والاختلاف. وكنتيجة لذلك ليس هناك حقيقة بالمفرد بل هناك حقيقة بالجمع؛ أي ليس هناك حقيقة واحدة متوحدة بل هناك حقائق كثيرة ممكنة. ولأجل هذا نقول ليس هناك هوية متطابقة مع نفسها تتجسد في شكل وعي بالذات أو في شكل مدلول متعالي-قبلي ومحتجب في جهة ما خلف نسيج الخطاب أو النص، منظورا إليهما بصفتهما يقومان (الخطاب والنص) دوما على بنية صورية منغلقة ترتد إلى معنى أساسي أو حقيقي(6). وضدا على ذلك نقول مع فوكو، تقطن في كل هوية نفوس عدة تتنازع داخلها، ومنظومات تتعارض فيها ويقهر بعضها البعض.
من هنا اتخذ عمل دريدا شكل ملاحقة "لسلطة المعنى" منظورا إليه بصفته "مدلولا متعاليا" أو بوصفه نهاية (telos). وهو عمل ينتصب أمام تاريخ الفلسفة بغية تقويضه لأنه يعتقد أن لا تفلسف يكون بعد اليوم ممكنا خارج التاريخ الميتافيزيقي نفسه.
ولهذا نقول إن هذا المشروع التفكيكي هو استئناف للعمل الهيدجري من حيث اعتقاده أن لا مجاوزة للميتافيزيقا إلا من داخل حوار لا متناه مع النص الميتافيزيقي. وكما أسلفنا القول، إن المنفذ إلى تفكيك الميتافيزيقا بوصفها تاريخا متمركزا على العقل والصوت أو من حيث هو تاريخ خطي للمعنى؛ هو مفهوم الكتابة. أما السؤال فهو: ما هي الأسس التي أقامت عليها الميتافيزيقا تصورا ما للكتابة؟
للاقتراب من هذا السؤال، مع دريدا، سنركز بالأساس على حوارين خاضهما هذا الأخير مع نصين متميزين داخل التاريخ الميتافيزيقي، متميزين بنوعية العمل الذي قام به كل منهما في مجاله:
أما الحوار الأول فكان مع سيجموند فرويد وثورته في مجال علم النفس التحليلي التي عملت على تقويض الأسس الميتافيزيقية لمفهوم الوعي بوصفه حضورا. والحوار الثاني تم مع فرناند دوسوسير والثورة التي أقامها داخل اللسانيات.
II – لغة القانون ولغة الرغبة:
لقد حاولنا، جهد المستطاع إلى حدود ما قلناه، بصدد العمل التفكيكي الذي قام به دريدا، أن نبين أنه يروم تقويض نمط الفلسفات التي منحت الوعي والحضور امتيازا أساسيا. وبما أن الوعي هو حضور أمام الذات، نلاحظ ذلك الترابط بين مقولة الوعي ومقولة الذات ومقولة الحضور. وإن الفكر الذي يمنح الوعي والحضور، بوصفه "أوسيا" امتيازا يكون قد سكن داخل الهواء الذي تتنفسه الميتافيزيقا(7).
وبما أن العمل التفكيكي مع دريدا يروم هدم هذا النمط من الفكر وتجاوزه، فإننا نفهم حواره مع فرويد بصفته عملا استراتيجيا من أجل مجاوزة الميتافيزيقا وما تقوم عليه من أسس. ويكون هذا العمل منسجما مع مهمة الفكر اليوم كما يراها فكر الاختلاف بعد وضع لبناته الأولى مع نيتشه ونضج كمشروع فكري له إبدالاته في الفكر الغربي المعاصر مع هيدجر.
إن مهمة الفكر، كما ارتآها هؤلاء، تكمن في تفكيك فلسفات الوعي أو الحضور. من هنا كان تركيزهم على تقويض المفهوم المركزي الذي قامت عليه هذه الفلسفات وهو مفهوم الذات بصفتها تقوم على الوعي وعلى مفهوم الأنا بالضرورة.
وتأتي أهمية فرويد في كونه حاول تكسير نرجسية الذات وسلطة الوعي. ومن ثم فجر زلزالا داخل أنطلوجية الذات التي تمركز ماهيتها على العقل في بعده المنطقي وتقصي الأبعاد الأخرى باعتبارها مصادر للوهم والضلال. ويأتي في مقدمة ما تم إقصاؤه بعد الخيال والحس. من هنا حرصت الميتافيزيقا، دائما، على ضرورة خضوع الذات لقواعد المنطق ولمقولات الزمان والمكان المحددة للنظام العام الذي ينبغي للذات أن تتحرك داخله.
يقول فرويد، وهو يتابع الأزمان المختلفة أو الجروح المتعددة التي لحقت نرجسية الإنسان، ما يلي:
"فخلال عدة قرون كبد العلم تكذيبين كبيرين للأنانية الساذجة للإنسانية. المرة الأولى حيث أظهر العلم أن الأرض ليست هي مركز الكون، وأنها ليست سوى ذرة لا قيمة لها ضمن النظام الكوني… وهذه البرهنة الأولى ترتبط باسم كوبرنيق رغم أن العلم الأسكندراني كان قد أعلن شيئا مشابها. أما التكذيب الثاني فقد تكبدته الإنسانية بواسطة البحث البيولوجي، حين رد ادعاءات الإنسان في كونه يوجد في موقع متميز ضمن نظام المخلوقات إلى لا شيء، وأرجع الأصول التي ينحدر منها الإنسان إلى المملكة الحيوانية… هذه الثورة الأخيرة تمت في أيامنا هذه بعد أعمال داروين… وهي أعمال ولدت أكثر أشكال المقاومة صلابة بين معاصرينا. وسيتم تكبيد تكذيب آخر إلى اعتداد الإنسان بذاته (mégalomanie) بواسطة البحث السيكولوجي القائم في أيامنا هاته والذي يحاول أن يظهر للأنا أنه ليس سيدا في بيته…"(8).
السؤال الآن هو: كيف نؤطر قراءة دريدا لفرويد ضمن برنامجه التفكيكي العام؟
ستعمل الثورة الفرويدية، وهي مقروءة من طرف دريدا، على إثبات أن الكلام الذي كانت تعتبره الميتافيزيقا اشتقاقا من الوعي وأصلا للكتابة، هو، بدلا من ذلك، اشتقاق من كتابة اللاشعور ولغته. وإن ما تعرفه الذات، ويتراءى لها في كامل الوعي والوضوح والتميز، ليس هو حقيقتها وذلك لأن هناك أبعادا أخرى تم اعتقالها وإخضاعها لقانون الحديث الصادر عن الذات في واضحة النهار، وأيضا، لأن هناك قسطا من رغبتها لا يمكنها الإفصاح عنه. من هنا توتر الذات وقلقها الدائم. لأن كل شيء تعيشه في تأرجح بين قانون الواقع وبين مطالب الرغبة.
وبناء على ذلك، نقول، ستعمل الثورة الفرويدية على تأسيس معرفة بما يفلت من سلطة الذات من حيث كونها مختزلة في مقولة الأنا. أي أنها عملت على الاقتراب من عالم يولد مقاومة وتصدعا لدى الذات. كما أظهرت أن مصادر تصرفات الإنسان قائمة في اللاشعور.
ولهذا السبب، سيشكل النص الفرويدي، فضاءا خصبا لقراءة دريدا وهي تروم تقويض فلسفات الوعي. وفي هذا الصدد ركز دريدا على الحلم وأهميته في توضيح هشاشة ما يدعيه الأنا من سيطرة وقدرة على عقلنة مختلف التصرفات. لقد بين فرويد أنه مع لحظة الحلم يفسح المجال للمكبوت وإلى ضغوط اللاشعور ومفعولات لغة الرغبة. وهي لحظة يضطر فيها خطاب القانون ولغة رصانة العقل إلى مغادرة الساحة لتحل محلها لغة لا تخضع لقواعد المنطق القاطعة، ولا لأبعاد الزمان التي تحكم خطاب الأنا وهو يتحدث عن الذات مدعيا أنه يقول اليقين. ويرى فرويد أن قواعد المنطق القاطعة لا قيمة لها في اللاشعور، بل يمكن القول بأنه مملكة اللامنطق، "لا يوجد في هذا النظام اللاشعوري لا نفي ولا شك ولا درجة من اليقين"(9).
من هنا تطرح مشكلة مدى إمكانية الأنا في ترجمة "النص النفسي": هل ترجمة "النص النفسي" وكتابته ممكنة؟ قد نترجم في الصباح مجموع الصور التي تمت رؤيتها ليلا، مثلا، إلى اللغة المتكلمة في النهار من طرف الأنا، لكن ما قيمة هذه الترجمة أمام مقاومة الأنا التي تريد لمبدأ اللذة أن يمحي ليترك المكان لمبدأ الواقع؟ وحتى وإن تمت هذه الترجمة، ألا نكون فقط عند مستوى ما تمت رؤيته في بعده المباشر؟ هل يمكن لهذه الترجمة أن تتحقق مع لغة المكبوت؟ هل يمكن حصر وتحديد نظام الطاقة الليبيدية اللامحدودة؟ ذلك النظام الذي يتحكم في توليد المعنى؟ هل من منطق للدوافع وللميول؟
لا تقوم كتابة الحلم على خطية زمانية كما قد يبدو للإحساس المباشر بأحداث الحلم. كما لا تقوم على علاقات منطقية. ولهذا، حينما أراد فرويد أن يقربنا من كتابة الحلم هاته استدعى مفهوم الكتابة الهيروغليفية، بصفتها لغة لا صوتية، كما بين أن لغة الحلم تتكلم الرغبة وتشغل رموزا تستمد معناها من التحويل المجازي، لأنها عبارة عن مؤشرات تلمح لصراع يقوم على الرغبة. من هنا يصعب الحديث عن الحضور، حضور المعنى بوصفه أصلا، وإنما هو شيء يتم إنشاؤه باستمرار. لأن القراءة تتعامل مع لغة ذات نزوع أخاذ إلى التكثيف، لغة تتكلم بشكل مقتضب ومختزل بالقياس إلى المادة التي صدرت عنها. لذلك فهذه الكتابة تستدعي نمطا من القراءة مخالف لتلك التي تعلمنا إياه الميتافيزيقا: إذا القراءة المستدعاة قراءة تأويلية-تحويلية لأنه ثمة تكثيفا للمعنى وتحويلا له. وكما نعرف، يغيب الاستماع مع الحلم إذ ليس هناك صوت. وكل ما هنالك هو "المشاهدة أو الإدراك" فقط(10). ليس هناك لا حصر ولا حد ولا تحديد، كما تدعي الميتافيزيقا، بقدر ما توجد الصور. إن الحلم يكتب كتابة تشكيلية لا يمكن الاقتراب منها إلا مع التحويل والترجمة. ومن هنا يستحيل الحديث عن معنى أصلي، يركن هناك بشكل نقي كحضور تحفظه الدلائل. يقول Pontalis مشخصا لغة الحلم قائلا:
"إذا اعتبرنا وسائل التمثيل في الحلم، بشكل رئيسي، بأنها صور مرئية وليست كلمات، يمكن أن نقارن، دون أن نجانب الصواب، الأحلام بنسق للكتابة عوض مقارنتها باللغة. إن تأويل الأحلام شبيه، في جميع نقطه، لتأويل الهيروغليفيات"(11).
وبهذا الاعتماد على لغة الرمز والتصوير في الكتابة، نلاحظ أن لغة الحلم لا تستدعي التحليلات اللسانية حيث النزعة الصوتية والزمان المتصل، زمان الوعي. مع فرويد لا وجود للزمان إلا كتباعد واقتصاد للكتابة، كما لا يمكن الحديث عن حضور للذات أمام نفسها. لذلك يقول دريدا: "إن الذات لا تصبح دالة (سواء بواسطة الكلام أو الإشارات) إلا وهي منخرطة داخل نظام الاختلافات. وبهذا المعنى الأكيد، إن الذات المتكلمة أو الدالة لا تحضر أمام نفسها"(12).
الذات تعيش دوما تصدعا مع نفسها بحكم نظام الرقابة الذي تخضع نفسها له ضمانا للبقاء. وليس المقصود هنا مفهوم الرقابة في معناه السياسي، وإنما رقابة الكاتب على كتابته فقط. ومن ثمة ليس هناك كتابة شفافة قابلة للقراءة المرآوية، إذ ليس هناك وعي شفاف واضح، وكل ما هنالك هو التحويل. فالكتابة منذ بدايتها هي ترجمة تقوم على فعل التحويل وهتك عذرية الفكر قبل توجيهه إلى المتلقي، لذا يذهب دريدا إلى أن ليس هناك "ذات" كاتبة تتمتع بكامل الوعي، متفردة بسيادتها. والحال أن "ذاتية" الكاتب نظام من العلاقات منها ما يعود إلى اللاشعور وآلياته أو إلى إطار علائقي بالآخرين، كما أن علاقة الأنا بما يقرره هي علاقة إرجاء لأحيان وظروف مواتية(13). وبناء عليه نقول، إن الاعتقاد في وجود "الذات" الكاتبة بصفتها هوية منفردة ومعزولة لها السيادة على نفسها، وهي في كامل وعيها، حاضرة في كل آن وحين أمام نفسها؛ وتتحكم في مختلف سلوكاتها وأنشطتها؛ لا وجود لها إلا في التصور الميتافيزيقي(14).
فالذات لا تعرف حضورا حتى عندما تحاول تخليد الاسم وتوقيعه لأن ثمة دوما، الآخر. إن ما تم توقيعه سوف لن يخلد إلى الراحة، أي سوف لن يحضر، لأن هناك الآخر الذي سيمنحه الحياة مرة أخرى بعد موت موقعه وسوف تعطى أولوية لمعنى على آخر داخل المقال نفسه من هنا يمثل النص فضاء للاختلاف والصراع، ولسوء الفهم أحيانا، وحتى للتأويلات المتناقضة وللحقائق المتباينة.
سوف يخلق هذا الكلام نوعا من الاشمئزاز لدى الميتافيزيقا لأنه بدلا من "أن ترى في الدليل والعلاقة مكان تناحر واختلاف وعوض أن تنظر إلى الدليل على أنه المكان التفاضلي الذي تؤثر فيه مختلف التأويلات، ترى فيه، على العكس من ذلك، مناسبة لحضور المعنى"(15).
وهكذا ينظر التأويل الفرويدي إلى الأعراض بصفتها فضاء مكثفا للمعاني وليست دلائل لمعنى أصلي(16). وعليه فليست الألفاظ خزانات تحفظ للمعاني أزليتها وتبقى على تطابقها. والقراءة عنده ليست بحثا عن أعماق الذات بل هي فقط اقترابا من الآليات الشعورية التي تحكمها طاقة لا نهائية ما تفتأ تعمل على إنتاج المعاني وتوليدها. وإذن, إن الوقوف عند تجليات اللاشعور، وخاصة في الحلم، من أجل التأويل، هو وقوف عند ما يجعل المعنى ممكنا، أي آليات المركب اللاشعوري التي تمثل، في نهاية التحليل، شروط إمكان المعنى. وبهذا يخرج المعنى عن الذات بصفتها "أنا" كوجيطو أو بوصفها حضورا كأوسيا، ويتم تجاوز ذلك الفهم الذي يعتبر "أفكار الحلم أكثر كذبا من غيرها" كما يذهب ديكارت إلى ذلك.
بهذا نلاحظ أن قراءة دريدا لفرويد لم تكن قراءة تأريخية أو قراءة إبستمولوجية محض، بقدر ما هي قراءة تدخل في إطار حوار استراتيجي شامل يروم مجاوزة الميتافيزيقا أي تقويض الأسس التي أقامت عليها حقيقتها. فمع فرويد تم تحطيم مفهوم الذات بوصفه وعيا أو أنا كوجيطو منسجما مع نفسه، يتمثل ذاته ويحضر أمامها بشكل حدسي. كما تم من جهة، تجاوز تصور المعنى بوصفه ماهية وأصلا تأتي اللغة لتكشفه وتحصره بألفاظها وتحده، وكأن المسألة هي مسألة ماهية أي مسألة شيء يخلد خارج الزمان وتأتي الكتابة لتحفظه وتوهم بأن ذات التلفظ ما تزال حية(17)، ومن جهة ثانية، تم تجاوز مفهوم ينظر إلى التأويل باعتباره بحثا في أغوار اللغة عن معنى أصلي، إلى مفهوم ينظر إليه من حيث هو قراءة تفاضل بين معنى وآخر وتمنح الأولوية لمعنى على آخر. وبهذا فالنص مع هذا المفهوم الجديد للتأويل، سوف لا يعرف خلودا إلى الراحة، بل سوف لا يعرف موته بقدر ما سوف يحقق بقاءه اللانهائي ما دام هناك آخر يؤول وبإمكانه أن يؤول تأويله ويتجاوزه باستمرار. وهذا التحول الذي طرأ على مستوى مفهوم القراءة والتأويل سيجعل من مسألة الترجمة قضية إشكالية ستفرض على دريدا أن يستعيض عن هذه الكلمة (= ترجمة) بكلمة "التحويل" التي سيستعملها ويشتغل بها. وهذا ما سنحاول الاقتراب منه، قدر الإمكان، من خلال حواره مع اللسانيين.
III – من الكتابة إلى الجرماتولوجيا:
يعتبر الدليل اللغوي من بين المفاهيم الأساسية التي قامت عليها نظرة الميتافيزيقا إلى اللغة والكتابة. ويرى دريدا أن تفكيك هذا المفهوم يعتبر منفذا، من بين منافذ أخرى كثيرة ممكنة لتفكيك أسس الميتافيزيقا. وفي هذا الإطار تحدد اعتراف دريدا، وهو ينجز عمله التفكيكي، بأهمية العمل السوسيري في مجال الدراسات اللغوية الحديثة، وبقيمته من حيث مساهمته في إحداث تحويل على هذا المفهوم الذي استفاده دوسوسير من التراث الميتافيزيقي ليوظفه ضد التراث نفسه(18). وقد أنجز دوسوسير عمله التحديثي هذا من خلال إقامته مفهوم الدليل على مقولتي الاعتباط والاختلاف.
يقول دوسوسير: "إن العلاقة التي تربط الدال بالمدلول هي علاقة اعتباطية، أو نقول بعبارة أخرى، ما دمنا نقصد من كلمة "دليل" signe الناتج الحاصل عن اجتماع الدال واتحاده بالمدلول: إن الدليل اللساني اعتباطي… وتقتضي كلمة "الاعتباط" منا إبداء ملاحظة من أجل الإيضاح، وهي أنه يتعين علينا ألا نفهم أن الدال يتعلق بالاختيار الحر أو بإرادة الذات المتكلمة… وإنما نقصد أن الدال غير معلل، فهو اعتباطي بالنسبة لمدلوله الذي لا تربطه به أية علاقة طبيعية في الواقع"(19).
ويقول أيضا في جهة أخرى من دروسه: "إن الذي يؤسس اللسان هو مجموعة الاختلافات الصوتية phoniques والاختلافات التصورية conceptuelles…"(20).
ولقد كان لأفكار دوسوسير اللسانية تأثير واسع ومتنوع على مختلف من اهتم بالدراسات اللغوية واللسانية أو من انشغل بالأنتربولوجيا والتحليل النفسي والأدب والفلسفة.
غير أنه على الرغم من هذه الثورة السوسيرية التي شهدها عالم اللغة، يرى دريدا أن دوسوسير لم يعمل إلا على التقليد حيث ظل يفكر في الدليل من خلال الزوجين "دال" و"مدلول" حتى وإن كانا وجهين لعملة واحدة، وبهذا لم يعمل على تخليصه (= الدال) من شحنته الميتافيزيقية إذ ظل يعني عنده "شيئا مجردا"(21). ونتيجة لهذا التمييز داخل الدليل بين مكونين، لكل واحد ما يميزه عن الآخر كذاتية مستقلة، يرى دريدا أن دوسوسير ظل سجينا للأساس الميتافيزيقي المتمثل في التمركز على اللوجوس والصوت، ذلك لأن مفهوم الدليل بهذا المعنى السوسيري يظل مشدودا إلى فلسفة الحضور تلك التي تجاور بشكل مطلق بين الصوت الذي يجسده الدال بوصفه متوالية صوتية وبين معنى الوجود (= المدلول)، أو بين الصوت ومثالية المعنى. وبهذا يكون دوسوسير قد حافظ على الزوجين الميتافيزيقين المادي والروحي أو المحسوس والمعقول بحيث كرس وجودهما في مجال اللغة.
لقد ظل المدلول يفيد المتصور الفكري الذي يحتاج، لكي يصبح متمثلا أمام الذات، إلى الصوت بوصفه سمعيا. ومن حيث هو الوجه المتعقل الخالص، إن للمدلول وجودا أنطلوجيا قبل السقوط في الخارج، في العالم السفلي الحسي(22). وبهذا الاستعمال لمفهوم الدليل ظل دوسوسير يعتقد في وجود مدلول في ذاته، في حضوره النقي وفي استقلال عن اللسان. أي في وجود مدلول متعال على الكلام أو الكتابة. بل أكثر من هذا، إنه ما برح يعتقد بشكل راسخ أن الكتابة هي دوما ملحق بالكلام وتمثيل له وفضاء مادي يتهاوى فيه صفاء الفكر ويغتصب، إنها عالم الخيانة والتدنيس(23). ولقد استمر هذا الاعتقاد في خدمة تاريخ الميتافيزيقا بصفته الفضاء الذي نحتت فيه اللغة الصواتية، لغة الأبجدية، ونظام فكر الحضور من جهة، وبصفته التقليد الذي ما فتئ يبحث عن مدلول متعال(24) وعن مفهوم مستقل أو عن معنى أصلي ونقي من جهة ثانية.
من داخل هذا التصور العام للدليل تحدد مفهوم ما للكتابة وللترجمة.
يقول دريدا: "الاختلاف بين المدلول والدال ينتمي بشكل عميق وضمني إلى كلية هذا العصر الكبير الملفوف بتاريخ الميتافيزيقا"(25).
أثبت دريدا أن الكتابة مع هذا التقليد الميتافيزيقي قد اعتبرت تحبيرا على الورق لبيان الفكر، وهي بذلك نسخ أو استنساخ يعمل على حفظ الأيدوس وتقييده ضد التلف والنسيان أو ضد عبث فعل الزمان. لذلك تشدد الميتافيزيقا على أن تكون الفكرة في البدء، واضحة متميزة في الحضور. وعلى الكتابة أن تأتي لاحقا، كفضاء مادي براني لكي تقوم بعملية النقل، نقل الفكرة من الرأس، وضاءة وخالصة إلى الورق أو إلى رأس أخرى. وبهذا يكون الدليل عبارة عن تمثل وتمثيل لشيء حاضر. واستنادا إلى هذا، إن الوضوح والتمييز يعمل على ضمان شفافية الصوت، صوت الأنا المتكلم، بصفته الماهية التي تتراءى للوعي، ضد الضياع والالتباس أو سوء الفهم، فهم المعنى الأصل الأساس. وذلك لأنه حين أتكلم فأنا أكون واعيا بكوني حاضرا في ما أفكر فيه، وحين أنتج ملفوظا فإن هذا الأخير يكون امتدادا لزمان وعيي. ومن ثم ينبغي للكتابة أن تكون أداة نسخ ونقل للحقيقة في صفائها الوهاج وامتلائها، وتكون مرتبطة بالزمان المتصل لصوت الوعي لكي تضمن عذرية الفكرة ويسهل أمر الترجمة.
ونتيجة لهذا التصور الميتافيزيقي نقول إنه على الدال أن يمحي أو أن يصبح شفافا كي يترك المعنى يقدم نفسه في كامل حضوره(26)، وهو بهذا يلغي عن الكتابة كل مفعول وقدرة على اغتصاب المعنى وتحويله.
يفترض هذا التصور الميتافيزيقي إذن، إمكان الوعي قبل الدليل وخارجه. يقول دريدا: "إن برانية الدال هي بصفة عامة برانية الكتابة. وسنحاول في ما سيأتي إظهار أن لا وجود لدليل قبل الكتابة"(27).
ضدا على هذا التصور اقترح دريدا مقولة التحويل بدلا من مقولة الترجمة. والمقصود بالتحويل هنا، تحويل للغة من طرف لغة أخرى أو تحويل لنص معين من لدن نص آخر. تحويل الأنا لمطالب مبدأ اللذة لتمحي وتترك المجال لمبدأ الواقع. ومن ثم تكون عملية نقل من نظام لساني إلى آخر، أو حتى داخل اللسان نفسه ممارسة لفعل تحويل المعنى(28).
أما الترجمة في معناها الميتافيزيقي فقد شرطت تصورا ما للقراءة يرد كلية النص إلى حقيقة معناه. ومن ثمة تنظر هذه القراءة إلى النص بوصفه تعبيرا أو بيانا لمعنى محجوب، فتقصي بذلك ما يقوم عليه النص من مفعولات دلالية لا نهائية تقوم بدورها على اللعبة المولدة لجميع الاختلافات(29). وبهذا، فالنص ليس له حدود بموجبها ينغلق فضاؤه ويحصر داخل بنية صورية أو معنى أساسي بل أكثر من ذلك، ليس هناك ما هو أساسي وما هو ثانوي كمعنى، وليس هاك موضوعات أساسية وأخرى ثانوية كما أن ليس هناك إرادة في القول. من هنا تأتي أهمية الهامش أو الحاشية أو الملحق والعنوان، وهي أمور تشكل ممرا أساسيا في حالات كثيرة, يلقي بنا في مسار بعيد داخل متاه النص وتأويله. وهنا ينبغي أن نستحضر قيمة "فلتات اللسان" أو "زلات القلم" في منظور التحليل النفسي، وتلك القيمة التي تمنحها تقنيات التحليل عند عملية التأويل والقراءة(30). كما ينبغي أن نستحضر ما يذهب إليه فوكو في إطار حديثه عن نيتشه وماركس وفرويد ومساهمتهم في تطوير مفهوم التأويل من أن التأويل لا يكشف عن خفايا مادة للتأويل إذ أن كل تأويل هو في حد ذاته تأويل لتأويل. وسترتبط بهذا التغير الذي لحق مفهوم الدليل وما ارتبط به من تحول على مستوى مفاهيم الذات والكتابة والتأويل والقراءة والمعنى والحقيقة، مشكلة فلسفية أساسية هي مشكلة علاقة الذات بما تكتبه. وهي مشكلة سنحاول الاقتراب منها من خلال طرح السؤال الآتي: ما الكتابة كاختلاف؟
يرى دريدا، وكما أشرنا إلى ذلك من قبل، أن الذات نسق من العلاقات يتحكم في ما هو نفسي وأسطوري في الذات كما يتحكم في العلاقة الممكنةبينها وبين العالم والإطار العلائقي العام الذي يربطها بالآخرين(31).
لا يمكن فهم هذا التصور الجديد إلا بتجاوز ذلك التصور التقليدي الذي ينظر إلى الذات نظرة تبسيطية تختزلها إلى مجرد ذاتية منغلقة على نفسها، مكتفية بذاتها، تحضر أمام نفسها وهي تتمثل نفسها. فالذات ليست حاضرة أمام نفسها ماثلة في كامل وعيها اليقيني كما تعتقد الديكارتية، بل إن ثمة دوما نوعا من التباعد عن صراع الأنا وتمزقه بين مطالب مبدأ اللذة ومطالب مبدأ الواقع الشيء الذي يجعل الذات وأنشطتها وسلوكها تقوم على مبدإ اللف والدوران والتأجيل، تأجيل تحقيق المكبوت إلى حيث ظهور الفرصة التي تسمح بذلك.
من هنا فإن حقيقة توازن الذات أمام الواقع تقوم على المقاومة والتصدع والتحمل. وهذا ما يجعل الذات محكومة بنظام الاختلاف الذي يرى فيه دريدا تلك الحركة المولدة للمعاني أو هو ما يمنح إمكانية ما نفهمه. وهي رؤية تنسجم مع ما ذهب إليه فرويد حين صرح أن الكتابة لا يمكن التفكير فيها بدون التفكير في الكبت. ودريدا ينبهنا أن لا نعتقد في أن الاختلاف شيء حاضر بشكل محتجب. كما لا ينبغي أن ننظر إليه من خلال مقولتي الحضور والغياب(32)، أو أن نعتبره مجرد مفهوم أو كلمة. إنه الشيء الجدير بالتفكير بوصفه هذا الذي يمنح الدليل شروط إشعاعه واشتغاله. إن الاختلاف بين فونيمين مثلا هو ما يمكن هذين الأخيرين من الاشتغال(33)، كما أن لعبة الاختلافات تفترض في كل قراءة أن تنظر إلى العناصر، كالدلائل المكتوبة، من حيث قدرتها على تحطيم سياقها الحقيقي لتقرأ ضمن أنظمة سياقات جديدة. وهذا التحول والتكرار، رغم غياب السياق، هو ما يمكن الدليل من أن يشع بالمعاني. والتعالق النسقي الذي يحكم هذه العناصر المشعة هو ما يحكم نسيج النص ليجعل منه فضاء بلوريا فياضا بالمعاني.
وبناء عليه، فالعنصر، فونيما كان أو حرفا ليس دليلا يعني بذاته، أي ليس له مدلول حاضر كماهية أو جوهر. لذلك قلنا، إن ما يتحكم في توليد المعنى وأصدائه، ليس هو الكوجيطو وإنما لعبة الاختلافات التي تقوم على تباعد العناصر ومجيئها صوب بعضها البعض. وعليه ففي إطار لعبة الاختلافات والتباعدات إذن يتم إنتاج المعنى.
بهذا يتم تجاوز تلك القراءة والترجمة اللتين تبحثان عن المعنى بربط النص بنفسية الكاتب أو بنيته في القول أو بكلية متعالية مزعومة. كما يتم تجاوز تلك الدراسات التي تعتبر النص وثيقة تاريخية أو نفسية تعبر عن ذات المبدع وتعكس عصره.
يقول دريدا: "لا وجود، البتة، إلا للاختلافات وآثار الآثار"(34).
وبناءا على هذا لا تسمح لنا الكتابة بوصفها اختلافا بالتفكير فيها من داخل الزوجين المتعارضين حضور-غياب. لأن ما يقال لا يرتد إلى ذات أو إلى جوهر أو إلى موجود في جهة ما ينفلت من حركة الاختلاف والتباعد. أو نقول ليس هناك حضور قبل الاختلاف وخارجه(35). من هنا ينبغي أن نتخلص من التفكير الذي يفسر كل شيء بمبدأ الهوية حيث التطابق والحضور أو بمبدأ السببية. فالمعنى والوعي لا يتكونان إلا داخل هذا النظام الذي لا حضور له، إذ لا يتشكل إلا في تباعده واختلافه وهذا يجعلنا نقول إن اللغة نفسها ليست من وظيفة الذات المتكلمة لأن الدلالة عينها لعبة صورية من الاختلافات أي من الآثار(36).
ليس هناك من ذات تكون سيدة على المغايرة. ولا حضور للذات في كل العمليات التي تقوم بها أو في "كلمتها الحية" وفي ملفوظها بدرجة تبلغ اليقين المطلق. ولهذا فإن الغراماتولوجيا ترى أن ليس هناك شيء قبل اللغة أو بعدها. فليست الحقيقة والمعنى إلا من نتائج المجاز والاستعارة والأقنعة البلاغية. وبهذا فالجراماتولوجيا لا تعترف بحقوق المؤلف على قرائه، لأن بينه (المؤلف) والقراءة بوصفها تحويلا وترجمة علاقة تواصل تقوم على مجال اتصالي تفعل فيه قوانين إنتاج الخطاب أو استراتيجية القراءة والكتابة وبنيات النص وموسوعة المتلقي القرائية المتمثلة في بنياته الدلالية والمعرفية. كل هذا يجعل من الترجمة بوصفها قراءة وكتابة في الآن نفسه، فعل تحويل يمارس نوعا من العنف على النص وعوالمه الدلالية الممكنة. وهذا كلام ينسجم مع ما يذهب إليه هيدجر، حيث يعتبر أن لا فكر خارج الكلام أو خارج اللغة أو سابق لهما سبقا زمانيا وحضورا(37).
هكذا نلاحظ كيف حاول العمل التفكيكي مع دريدا إخراج الدليل من معناه الميتافيزيقي إلى معنى مخالف، إذ لم نعد ننظر إليه بوصفه حدا لمعنى متعال وحصرا له، أو أنه مرتبط بذات مفكرة حاضرة دوما أمام نفسها، فتم رده إلى شروط إمكان دلالته أي إلى الاختلاف والتباعد والتفاضل. وبهذا التحويل تضحى كل المتعارضات المفهومية التي أرست عليها الميتافيزيقا دعائمها (= دال/مدلول، محسوس/معقول، كتابة/كلام، كلام/لسان…) مأزومة ومتجاوزة، لأنها تروم إقامة كل شيء على "قيمة حاضرة" كحضور الذات أمام نفسها وهي تتأمل ذاتها أو حضور المعنى الحقيقي الأصلي الذي يكون سابقا على الاختلاف وأكثر أصالة منه، يتجاوزه ويتحكم فيه في آخر التحليل. وهذا ما يسميه دريدا الهواء النقي الذي تتنفسه الميتافيزيقا أي المدلول المتعالي الذي ما فتئت هذه الأخيرة تبحث عنه محاولة حصره وتحبيره وإسقاطه داخل عالم اللغة والكتابة من دون اغتصاب له أو تحويل. وهذا يعود لكونها (= الميتافيزيقا) تعتبر المعنى صوتا والكتابة صوتية تقوم على صوت الروح وهي تحاور ذاتها. وهنا ينبغي أن نتذكر تصور أفلاطون للنفس باعتبارها جوهرا غير فان،جوهرا يفكر قبل سقوطه في الجسد وسيظل كذلك بعد مفارقته له عند الموت، ويقوم هذا الجوهر على العقل بوصفه أرفع أحوال النفس الممكنة.
يقول أفلاطون: "… والآن، ففي وسعك أن تجد ما يطابق هذه الأقسام الأربعة في الأحوال الذهنية الأربعة الآتية: فالعقل أرفعها، والفهم هو التالي له، والاعتقاد هو الثالث، والتخيل هو الأخير. وفي وسعك أن ترتب هذه الأحوال، بحيث تعزو إلى كل منها درجة من الوضوح واليقين تتناسب مع مقدار الحقيقة التي تملكها موضوعاتها"(38).
وإن شئنا مع هيدجر، نقول إنه مع الأفلاطونية ظل الاعتقاد راسخا في كون المعنى مرتبطا بالنفس أو العقل أو الخاطر محجوبا ومستورا ينتظر من يكشف القناع ويهتك الحجب "متى يفضي السامع إلى حقيقته ويهجم على محصوله (= المعنى)"(39).
يقول الأستاذ الطاهر واعزيز مقربا رؤية الأفلاطونية للمعنى ما يأتي:
"… فهل نسير مع أفلاطون الذي أفصح، في الرسالة السابعة وفي محاورة فيدروس، عما شكل باطن فكره منذ شبابه فقال بأن المهم في الفلسفة لا يمكن التعبير عنه بكيفية مرضية، لا بالكتابة ولا باللفظ، وعلى الخصوص في التعليم المدرسي. "إن النصوص لا يمكن أن تقول إلا ما تقوله، ولو سألناها لما نطقت. وهي تقع في يد من يفهمها وفي يد من لم توجه إليه" (فايدروس 275 ج) وإن التبليغ الحقيقي لا يكون إلا من إنسان لإنسان، ولا يوجد لكل أحد، وإنما للنفس المتقبلة التي اختارت معلمها، وعندئذ ترتسم الكلمة في نفس المتعلم"(40).
يشير هذا النص إلى نظرة الأفلاطونية إلى الحقيقية باعتبارها ليست مسألة نكتفي بمعرفتها وإنما يجب كذلك تبليغها. إلا أن فعل التبليغ الحق لا يمكن أن يتم بوسائط كاستعمال الألفاظ والكتابة وإنما ينبغي أن يتم مباشرة من النفس إلى النفس، لأن ما يتم تبليغه وتعلمه هو الأيدوس.
لأجل ذلك نقول، إن الاعتقاد الذي ينظر إلى المعنى بوصفه حضورا أو أيدوس ينبغي تبليغه من النفس إلى النفس من دون وسائط تم التأسيس له فلسفيا مع سقراط عندما قلب مجموع القيم لكي يعتبر أن القيمة الحقيقية للطبيعة الإنسانية هي الفكر الذي تبلغه النفس بواسطة العقل حيث تتم الرؤية أو الإبصار الفكري للحقيقة. من هنا ينبغي أن نقف عند الدلالات الرمزية الاستعارية التي يوظفها أفلاطون لمفهوم "الشمس"، حيث الضوء والإنارة، حيث أراد تفسير بعد الفكر البصري. وفي هذا الإطار اشتغل على مجموعة من الثنائيات التي تفيد ذلك حيث نجده يقابل بالضد بين النور والعتمة(41). كما نجده يحدثنا على تربية النفس ورعاية الجانب القدسي منها، إنه النفس. وهذه التربية ضرورة لا بد منها لأن النفس مهددة دوما الجسد وعالم الأهواء الذي يشوش على رصانة العقل. وهي ضرورة أيضا لأنها تمكن من توجيه عين النفس وتحويلها من ضلال الكهف إلى نور العقل حيث النور الوهاج(42). ولكي لا تفقأ الأعين ينبغي للتربية أن تكون بالتدريج لكي تتقوى النفس وتتهذب لتصبح مهيأة للتفكير ورؤية ما هو متعال. وعليه فكما أن الرياضة البدنية ترويض للجسد فإن مجموعة العلوم التي نتعلمها بالتدريج ترويض للنفس ودربة لها(43) على فن المايوتيقا بوصفه فن توليد الأفكار التي تكون محجوبة حاضرة ويلزم تذكرها(44).
ولأجل مجاوزة هذه الميتافيزيقا، ذهب هيدجر إلى أن الأفلاطونية قد حددت "قدر" تاريخ الفكر الغربي برمته، هذا التاريخ الذي نريد مجاوزته من خلال تفكيك مختلف النظم الفلسفية التي شكلت الأفلاطونية منحدرها، وذلك اعتقادا منه بأن تقويض هذه النظم من حيث أسسها من شأنه أن يقوض هذا الذي قام عليه الفكر الغربي في مختلف تجلياته وكذلك تجربته الحضارية والعرقية التي بدا فيها الغرب هو المركز والنموذج.وللغرض نفسه أكد التفكيك مع دريدا على أن المعنى ليس صوتا، لأننا لا نجد أنفسنا، ونحن نقرأ نصا ما، أمام معنى حاضر وإنما أمام أصداء لمعاني متعددة أو أمام طبقات من المعاني ما تفتأ تتكاثر أنويتها وتشع بشكل بلوري لتفقأ أعيننا. ولأجل ذلك، أكد التفكيك، وهو يعمل على تقويض مفهوم الذات ومفهوم الدليل على مفهوم الاختلاف والتباعد والمغايرة والتعدد بدلا من مفهوم الوحدة والتطابق.
وبتأكيده على ذلك، يهدف التفكيك إلى تقويض نماذج الحضور التي يستند إليها هذا الفكر. وعليه فإنه إذا أمكن الحديث عن تاريخ للتأويل، نقول إنه تاريخ لهذا الذي اعتبره الناس حقيقة أو وهما وبؤرة للصراع.
وهكذا يمكن أن نلاحظ كيف أن عمل دريدا التفكيكي تطور ممكن لمشروع مجاوزة الميتافيزيقا الذي عقد الفكر الغربي المعاصر، مع هيدجر، العزم على وضع لبناته الأساسية من أجل إيقاظ استجابة عندنا لما تدعونا إليها الفلسفة، استجابة يقتضي منا أن نتباحث مع الفلاسفة فيما يتكلمون عنه. إن هذا التباحث المتبادل هو التكلم بمعنى التحاور. إنه الكلام من حيث هو حوار مع الآخر. إن الطريق نحو التفلسف إذن ليس انفصالا عن التاريخ ولا عن الآخر وليس إنكارا لهما، ولكنه بالعكس امتلاك لما يقدمه التراث الفلسفي عموما وتحويلا له. إن هذا الامتلاك للتاريخ هو ما يقصده هيدجر بكلمة "تهديم". إذا كان التأريخ للفلسفة ينحصر في إثبات آراء الفلاسفة ووصفها باعتبارها معلومات تنبني عليها الأنساق الفلسفية، فإن العلاقة بالتاريخ الفلسفي، من منظور هيدجر تقوم على نوع من الحوار المصغي المتباحث مع ما قاله الفلاسفة وتحدثوا عنه بصفته وجود الموجود… وإذن، ينبغي أن يفهم التفكير بوصفه إنصاتا واستجابة للنداء الذي لا صوت له، نداء الوجود، ولا ينبغي أن يختزل إلى مجرد "لوجيا".
غير أن ما يميز حوار دريدا للميتافيزيقا عن حوارات هيدجر لهذه الأخيرة هو أنه ساهم في تفكيك الميتافيزيقا في مجالات خارج تاريخ الفلسفة، متجسدا في حواره التفكيكي لمؤسس اللسانيات الحديثة وحواره لمؤسس علم النفس التحليلي. وهو عمل يفيد، من جهة أخرى إمكانية تطوير مشروع المجاوزة بالبحث خارج تاريخ النصوص الفلسفية الميتافيزيقية، وذلك على اعتبار أن الميتافيزيقا بوصفها فكر نسيان الوجود، ليست مجرد مبحث في الفلسفة ولا تحضر في كلام الفلاسفة فقط، وإنما هي "حاضرة" في مختلف ما يبدعه الإنسان فوق الكوكب الأرضي –أين تأسست الحضارات الإنسانية الكبرى- أو ما يحاول القيام به اليوم خارج هذا الكوكب. لذلك يعتبر هيدجر الميتافيزيقا بنية الوجود.
واللافت للنظر، أن الميتافيزيقا طيلة تاريخها عملت على تأسيس الفكر على العقل مختزلة إياه إلى مجرد "راسيو". لذلك اعتبرت "المنطق" هو المقياس الوحيد للحقيقة، كما عملت أيضا على نبذ كل من الشعر والخيال والحواس، الشيء الذي حول الفكر إلى تقنية مع العصر الحديث. هذا الفكر التقني هو ما يحدد اليوم نوعية علاقة الإنسان في كل الأصقاع بالوجود. وبهذا أضحت التقنية فكرا كونيا يريد أن يكون هوية لجميع الهويات، فكرا ما فتئ يكتسح ليس الإنسان الغربي الأوروبي فقط، وإنما يكتسح الإنسان أينما كان فوق الكوكب الأرضي. من هنا جنون هذا الفكر الذي حاول هيدجر أن يثير انتباهنا إليه من خلال حواره للعصر ومن خلال دعوته إيانا إلى تأمل مجموعة من الأسئلة نذكر منها: ما الميتافيزيقا؟ ما هذا الذي نسميه فكرا؟ ومن هنا كانت مساهمة دريدا من أجل تفكيك الميتافيزيقا من خلال مفهوم الكتابة كمنفذ استراتيجي لإعادة النظر في هذا المفهوم وعلاقته بالمعنى والحقيقة
(*) نأخذ مفهوم الميتافيزيقا هنا كمرادف لتاريخ الفلسفة أو للأفلاطونية في معناها القوي.
(1) عن شرح الفارابي لكتاب أرسطوطاليس في العبارة، نشر وتقديم ولهلم كوتش اليسوعي وستانلي مارو اليسوعي. دار المشرق – بيروت، الطبعة الثانية 1971، ص24.
(2) نفسه، الصفحة نفسها.
ونجد صدى هذا التراث الذي يقيم الحقيقة على صوت النفس في الثقافة العربية وخاصة عند الذين تحدثوا عن مسألة البيان: يقول الجاحظ: "المعاني القائمة في صدور العباد، المتصورة في أذهانهم، المتخلبة في نفسوهم… مستورة خفية وبعيدة وحشية ومحجوبة مكنونة… وإنما تحيا تلك المعاني في ذكرهم لها وإخبارهم عنها…"، البيان والتبيين، ج1، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت، ص42.
ويقول الجرجاني عبد القاهر: "وإذا كان لا يكون في الكلام نظم ولا ترتيب… بان بذلك أن الأمر على ما قلناه من أن اللفظ تبع للمعنى في النظم، وأن الكلم تترتب في النطق بسبب ترتب معانيها في النفس…"، دلائل الإعجاز، طبعة درا المعرفة، بيروت، 1978، ص45. أما عند صاحب لسان العرب نجد أن "كتب الشيء يكتبه كتابة يعني خطه ونسخه ومنه استنساخ ما تكتبه الحفظة وإثباته. نلاحظ إذن أنه عند أهل البيان أن المعنى