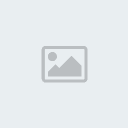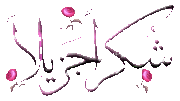فلسفة التفكيك عند دريدا
د.محمد سالم سعد الله
non_alshekh@yahoo.com
كلية الآداب / جامعة الموصل
يتجه التفكيك بشكل أساس إلى نقد الطرح البنيوي ، وإنكار ثبات المعنى في منظومة النص ، واختزال الفرد المُنتج ، وتحويل مسار السلطة الدلالية إلى حركة الدال ، وتحليل الهوامش والفجوات والتوقفات والتناقضات والاستطرادات داخل النصوص ، بوصفها صياغات تسهم في الكشف عن ما ورائيات اللغة والتراكيب ( Meta-Language ) .
في البدء يمكن القول أنّ هناك استحالة دائمة للتحديد الدقيق للتفكيك ولإجراءاته النقدية لأنّها في صيرورة دائمة ، ومتحركة مع الطرح السياسي والاقتصادي والاجتماعي المتحول دائماً ، وبالرغم من أنّ التفكيك لا يفقد شيئاً من خصوصيته إذا قيل باستحالة تحديده ، إلاّ أنّ الدخول إلى حصنه محكومٌ بأنواع من المخاطر ، إذا لم يتسلح الناقد بإجراءات نقدية دقيقة وصارمة .
يُمثل التفكيك نظرية نقدية شاملة تبغي إعادة قراءة النصوص الفلسفية والمعرفية والثقافية والإبداعية المتنوعة ، ويرى أنّ تلك النصوص تخضع لعمليات معقدة ناتجة من علاقات النصوص المتناصة بعضها مع البعض الآخر ، ويُعد تراجع البنيوية ناتجاً عن فشلها في تحديد السمات الكلية لحركة الدوال ، ومراهنتها على تموضع البنى في أنساقٍ تحيل إلى مدلولات متعددة نهائية ، وتُوصف بأنّها محددة ، فضلاً عن عدم إعطائها منزلة فاعلة للمتلقـي ، لأنّ النص عندها هو من يقدم المعنى إلى متلقيه ، ويمارس دور الفاعل والمفعول في الوقت نفسـه ، فكسب المعنى من جانب المتلقي ، مرهونٌ بما يتيحه النص ببنائه وتعدد أنساقه وحركة بنياتـه ، وانتظام تراكيبـه .
ويمكن الحديث عن أهم المعطيات النقدية التي قدمها دريدا لمشروعه النقدي التفكيكيّ من خلال النقاط الآتية :
1. الاخــتلاف : Difference .
2. نقد التمركـز : Critique of Centricity .
3. نظرية اللعب : Theory of play .
4. علم الكتابـة : Grammatology .
5. الحضور والغياب : Presence and Absence . تحيل هذه العناصر مجتمعة إلى نتيجة مفادها : أنّ كلّ شيء مؤقت في المشروع التفكيكـي ، لأنّ جميع التراكيب والبنى هي في حالة مستمرة لا نهائية ، وقد تأتى ذلك من انحطاط النموذج الإنساني أمام النص ، وإنكار التقاليد الإبداعية لولادة النتاج البشري ، وعدم الثقة بالحقيقة المطلقة ، وترجيع كلّ شيء إلى عدم ثبات ، … إلخ ، وقد حدّد ( كاموف ) التفكيك بقولـه : " التفكيك هو أن تنتهي إلى عمل لاشيء " (1) ، وحدده ( لاينج ) بقوله " التفكيك هو هفوة نقدية " (2) ، أما ( هابرماس ) فقد وصف التفكيك بأنه " عملٌ تعسفيٌّ " (3) ، وحدّده (بورديو ) بقوله : " التفكيك لعبة " (4) ، وحدده ( هاريسون ) بقوله : التفكيك يستلزم تبعات عبثيـة (5) .
إنّ تلمس الحقيقة في التحليلات النصية في المشروع التفكيكي هو محال ، وهناك تفسيرات مختلفة للنصوص لكنها لا تستند إلى حقائق نهائية ، ودور التحليل في هذا المشروع هو تحريك تفسيرات متعددة في قراءة نص معين ، ووفقاً لذلك لا تمثل اللغة انعكاساً طبيعياً للعالم ، لأنّ بنية النص هي التي تنظم ترجمتنا الفورية للعالم ، وهي التي تخلق مجموعة تجاذبات تسهم في فهم الحقيقة التي تتصف في المشروع التفكيكي بأنّها نسبية .
ويرى دريدا أنّ تاريخ الفكر الغربي يستند على مجموعة ثنائيات متعارضة ( الرجـل ـ المرأة ، الخير ـ الشر ، العقل ـ الجنون ، الخطاب ـ الكتابة ، … ) ويشكل الطرف الثاني نقـداً ، وجانباً سلبياً للطرف الأول ، ولا يستثني دريدا أي نص من احتوائه على ميراث تلك الثنائيات المتعارضة ، وتسهم تلك الثنائيات ـ حسب دريدا ـ بإطالة أمد بلوغ المرحلة النهائية للترجمة الفورية للنص ، بهدف كسب المعنى (6) .
يشير المصطلح الأول ( الاختلاف ) إلى السماح بتعدد التفسيرات انطلاقاً من وصف المعنى بالاستفاضة ، وعدم الخضوع لحالةٍ مستقرةٍ ، ويبين ( الاختلاف ) منزلة النصية (Textaulity ) في إمكانيتها تزويد القارئ بسيل من الاحتمالات ، وهذا الأمر يدفع القارئ إلى العيش داخل النـص ، والقيام بجولات مستمرة لتصيّد موضوعية المعنى الغائبة ، وترويج المعنى ـ حسب دريدا ـ يخضع دائماً للاختلاف ، والمعنى من خلال الاختلاف يخلق تعادلات مهمة بين صياغات الدوال والاطمئنان النسبي إلى اقتناص الدلالة (7) .
ويكشف الوقوف على دلالات مصطلح ( الاختلاف ) الصياغات المستقبلية ـ فضلاً عن الآنية ـ للطرح التفكيكي ، وذلك لتشعب الارتباطات الفكرية والمعرفية مع هذا المصطلح ، إذ يشكل ـ كما يرى البحث ـ البؤرة الأساس التي تنطلق منها مقاربات الطرح النقدي لجدلية الحضور والغياب ، ومفهوم الانتشار ( Dissemination ) ، والأثر ( Trace ) ، واللعب الدلالي ، والمتاهة ( Aporia ) ، وحركة الدال والمدلول ، وتغييب الدليل ، … الخ ، ويشير دريدا إلى أنّ الصفة المشتقة من فعل خالف / اختلف وُلّدت مصطلح ( Difference ) الذي يجمع صفاً من المفاهيم النسقية ، وغير القابلة للاختزال ، يتدخل كلّ واحد منها ـ بل تتزايد فعاليته ـ في لحظة حاسمة من العمل الإبداعي ، وتلك المفاهيم يجمعها عنصر المغايرة ، الذي يعدّه دريدا الجذر المشترك لكل المتعارضات المفاهيمية التي تُسهم في شرح اللغة ، واختراق نظامها (8) .
لقد عَمدَ دريدا إلى بيان صفة التغاير الدلالي مع وحدة الأداء الصوتي ، مستخدماً التوافق القصدي المزعوم بين مفردتي Differance ) ) ، وDifference ) ) ، فتغيير الصائت (e) إلى الصائت (a) هو تغير في بنية المدلول ، حيث تحول المعنى من الاختلاف والتغاير إلى الإرجاء والتأجيل ، وجاء هذا التغير ليؤكد منزلة المكتوب قياساً إلى المنطوق في حمله لدلالاتٍ ذات فاعلية فلسفية ومعرفية ، وهذا التحول الجزئي مهم في عملية إنتاج الاختلافــات ، وهي مهمة أيضاً في عملية الدلالة التي تُوصف بأنّها لعبة صورية من الاختلافات ، والمغايرة هي اللغة المنهجية للاختلافات وللتباعد الذي يجعل العناصر يحيل الواحد منها إلى الآخر ، وبهذا تحيل الإنتاجية التي توحي بها المغايرة إلى حركة توالدية داخل لعبة الاختلافات التي هي أساساً ـ وكما يقول دريدا ـ نِتاج تحولات : ( Transformations ) (9) .
ومسألة التحول الدلالي من الاختلاف إلى الإخلاف ، أو من المغايرة إلى التأجيل ، أو من الضدية إلى الإرجاء ، ليست عملية تلاعب بالمفردات أو الصوائت حسب ، إنّما هي عملية عقلانية قصدية تهدف إلى إعلان انتصار البنى في احتكارها للمعنى ، وسحب البساط من النشاط الإنساني الذي كان مُسلطاً عليها في يوم من الأيام ، وتهديم الثنائية التضايفية التي حكمت انتقال المعنى بين النص والقارئ ، بمعنى : استسلام نهائية المعنى الثابت أمام تغاير المعنى المتعدد اللانهائي ، فضلاً عن اتساع النسيج المفاهيمي الحامل لدلالاتٍ متغايرة ، ودور عملية الاتساع هذه في تقديم المعنى بصورته اللانهائية المؤجلة بصورة دائمة .
ويعلن العمل التفكيكي على لسان دريدا في صيغهِ التحليلية معاداته لكل المفاهيم التي تتسم بالبساطة ، والوضوح ، والفرادة ، والحضور الدائم ، والعزلة ، والتوافق ، والصياغة المطلقة ، وتواجد الحقيقية بشكل دائم ، والتواصل الدلالي ، … وغيرها من الشعارات التي مَقتها دريدا وراهن على وَأدِها ، وعدم امتلاكها لجديّة الطرح ، وفاعلية التطبيق ، فالمعاني يمكن تنميتها من خلال اختلافها وتأجيلها المستمر ، ويمكن تكوينها أيضاً من خلال تشكلها من حشدٍ من العلامات المتغايرة التي تحيل باستمرار إلى تأزم العلاقة بين الدال والمدلول ، نظراً لإمكانية الدال للإحالة على نفسه ، وتنظيم سلسلة من المفردات قبل الإحالة على المدلول ، بمعنى تعمّد الدال تغييب المدلول ، وهذا ما أكدّه دريدا في حديثه عن التلاعب الكتابي لمصطلح (Difference ) (10) .
إنّ المعطيات السابقة تقود إلى أن يغدو كل معنى مؤجلاً بشكل لا نهائي ، وكل دال يقود إلى غيره في النظام الدلالي اللغوي ، دون التمكن من الوقوف النهائي على معنى محدد ، وتغدو عملية التوالد للمعاني مستمرة انطلاقاً من اختلافاتها المتواصلة ، التي تبقى مؤجلة ضمن نظام الاختلاف ، وتظل محكومة بحركة حرّة لا تعرف الثبات والاستقرار ، وكل هذا يشحن الدوال ببدائل لا نهائية من المدلولات ، وهذا يكشف أنّ هناك بناءاً وهدماً متواصلين من أجل بلوغ عتبة المعنى (11) .
لقد أراد دريدا من الدال أن يكون بنية مناقضة لذاتها أو لغيرها ، والهدف من ذلك إدخال إصلاحات واسعة ، ومشاريع متطورة متعددة على أوضاع الدلالة الساكنة ، ثم الانتقال من المعنى المُوجَه في عهدهِ البائد إلى المعنى المغيّب المتسم بالاإستقرار ، والمنظِم لاستثمار فعل التراكم المعرفي الناتج من حوار مراكز دلالية لنصوص مختلفة ، والمطمح التفكيكي من عملية التحليل يكمن في تسيير فعاليات هذا المعنى المغيّب ، وهذا التطور الحاصل في رؤية المعنى هو عين التطور الكامن في ورشة القرار السياسي ، لكن لا يمكن رسم تحديد دقيق لأسبقية التأثر فيما إذا كانت للمشروع النقدي ، أم كانت للمشروع السياسي ، وحسب البحث القول أنّ الحديث عن الأسبقية هو حديثٌ نسبي ، لأنّ المشروعين دخلا في علاقة جدلية متضايفة ، ومتبادلة ، ومتحاورة في الوقت نفسه .
إنّ تسليط الضوء على التطورات النقدية المتلاحقة في الطرح التفكيكيّ ، يسهم في تشكيل المُناخ الفكري المحيط بالمعطيات النقدية للتفكيكية التي تظهر وكأنّها منفصلة عن بعضها ، والحقيقة أنها مترابطة ، وتضفي الواحدة منها على الأخرى لأنّها تأتت من فكرٍ متقدٍ ذي أبعاد لاهوتية وفلسفية موغلة في القِدم فضلاً عن الأبعاد الإيديولوجية التي تسخره للعمل لصالح هذا الاتجاه أو ذاك .
لقد التجأ دريدا بتكتيكاته إلى حصنٍ متنقل من الاصطلاحات ، لم يكن من الممكن اختزالها ، وقد كان فعل الاختزال أكثر هذه الاصطلاحات فعالية حيث أثبت على صعيد التحليل والبيان مقاومته لفعل الاختزال ، وعدم الإمساك بمعنى محدد له ، وهذا التوجه أكسب دريدا ـ حسب نورس ـ بناء نظام الأشكال المختلفة بوصفها شرطاً مسبقاً ، وبمجرد تثبيت الاصطلاح ضمن النظام المقدم فإنّه يصبح بناءاً مستخدماً بطرق تنفي رؤاه الداخلية المتطرفة (12) .
ويستمد الاختلاف تموضعه في المشروع النقدي التفكيكي من خلال سمتين (13) :
1. إنّه يقوم على اختلاف الدوال ، وينتج عنه اختلاف المدلول ، وتقديم لغة الكتابة على لغة الحديث ، أو تقديم المكتوب على المنطوق .
2. يتخذ الاختلاف ـ عادةً ـ شكل الثنائيات المتقابلة أو المتضادة : ( الخير ـ الشر ، الطبيعة ـ الحضارة ، الإنسان ـ البنية ، … الخ ) ، والعلاقة بين الدال والمدلول في هذه الثنائيات المتضادة تقليدية وليست منطقية ، وتختلف باختلاف السياق الواردة فيـه ، ويترتب على ذلك أنّ المعنى الأدبي لا يمكن أن يكون واحداً أو محدداً أو واضحاً ، حيث تعرض لنوع من التخالف لا التوافق ، والتفكيك لا التجميع .
إنّ التغيرات التي يعقدها الاختلاف هي تغيرات في سلوك المعنى ، لأنّ الدلالة تعتمد دائماً على الاختلافات ، وانتقال دريدا من الصائت ( e) إلى الصائت ( a) في كلمــــــة (Difference ) ، هو بمثابة ( حيلة ) قُصِد منها إبراز التعقيد الإشكالي للدلالة بإنتاجه التناقض أكثر من إنتاجه للمفاهيم ( Concepts ) (14).
ويشير دريدا إلى أنّ الانتقال بين الصوائت المتشابهة في النطق في إطار مفردة (Difference ) يحيل إلى مقاومة الاقتصاد في حضور الدلالة ، ويرتكز في ذلك على تفسيره الخاص لمعطيات هيجل في الديالكتيك ( Dialectic ) ، واللحظات الاقتصادية ، ويرى أيضاً أنّ اللعب في دلالة الاختلاف يضمن عدم خسارة الدلالة المهمة والضرورية ، والقصد هو بيان استراتيجية عمل الحضور والغياب ، والتخلي عن تركيز الأهمية على المنطوق قياساً للمكتوب ، فالأهمية ـ حسب دريدا ـ تكمن في المكتوب بصفته الحامل للتظاهرة النصية المكونة من مجموع العلامات والرموز (15).
ويُقدم المعطى الثاني من معطيات دريدا ( نقد التمركز ) ، إمكانية كبيرة في فحص منظومة الخطاب الفلسفي الغربيّ عبر قرونه الممتدة زمنياً ، والمكتسِبة لخصوصية معينة في كلّ لحظةٍ من لحظاتها ، بوصفها المراحل المتعاقبة للبناء التدريجي للفكر الأوربي الحديث ، ويكشف هذا المعطى في الوقت نفسه عن التأمل الفلسفي المتعالي ، ويعمل على تعريته ، وتمزيق أقنعته بوصفها رواسب حجبت صورة الحقيقة .
ويُصر دريدا على أنّ لكل تركيب مركزاً سواء كان تركيباً لسانياً أم غير لساني ، فلسفياً أم غير فلسفي ، وحمل التراكيب لمراكز محددة يعطي أهميةً لحركة الدوال ، لأنّ المركز ـ حسب دريدا ـ هو الجزء الحاسم من التركيب ، إنّه النقطة التي لا يمكن استبدالها بأي شيءٍ آخر (16) ويجب التفريق بين أهمية المركز بالنسبة للتركيب النصي ، وبين نقد التمركز ، فالمركز شيء إيجابي لحركة الدلالة والمعنى ، أما التمركز فهو شيءٌ مُفتعل يضفي المركزية على من هو ليس بمركز ، ويقود ذلك إلى احتكار التكثيف ( Decondense ) ، واستبداد النموذج (Exemplarity) بمعنى قيام بنية مركزية تدعي لوحداتها النموذج المتعالي الذي يصح تطبيقه على كلّ نص ، في زمان غير مقيّد ، وتَوجُه دريدا في هذا الإطار كان منصباً على نقد التمركز بوصفه دلالة سلبية ، ومدح المركز بوصفه العنصر المشع للدلالة ، والنقطة التي ينبثق منها اختلاف المعنى .
إنّ الجدلية القائمة بين المركز ( Center ) ، والتمركز ( Centricity ) هي جدلية بين فعل السلطة والتسلط ، أي أنّ المركز يمارس سياسته في تنشيط ( Activation ) حركة الدلالة ، وترتيب الأنساق ، ويتيح خلق بدائل مستمرة في أنظمة مختلفة ، أما التمركز فيمارس تسلطه ونفوذه ( Influence ) في الإحاطة ببعض مصادر إنتاج المعنى وتفعيله كالعقل ، والكتابة ، والصوت ، والوجود ، …الخ ، ويقود إلى تمحور الخطاب حول نموذج معين ، وهذا بالتحديد ما سعى دريدا إلى تقويضه ، وتفتيته ، وإزالة مقوماته ، وبيان مواطن الخلل والزلل في بنيته .
والحقيقة إنّ سعي دريدا لتقويض التمركز قاده إلى تحطيم كلّ المراكز ، وتفكيك أنظمتها بدءاً من مركز كلّ شيء وهو ( الإله ) وهو سبب مركزي لكل الأحداث ، مروراً بمركز الحقيقـة ، وانتهاءً بمركز العقلانية ، وقصدية دريدا هذه تتجه إلى مبدأ يقتضي عدّ العلامات في حالة حركة مستمرة لانهائية ، ومتحررة عن مراكزها ، وهذا يؤدي إلى تفعيل نشاط الأزواج المتغايرة ، أو الثنائيات المتناقضة ، وقد عدّ ( إلين ميجيل ) هذه المعطيات بمثابة ( نُبوءة ) جديـدة ، وبِشارة لاهوتية بولادة رسولٍ للقرن العشرين مع إخوانه الأنبياء الجُدد ( نيتشه ، وهيدجر ، وفوكو ) ـ على حدّ تعبير إلين في كتابه الذي حمل عنـوان : أنبياء ذوو شأن عظيـم ـ (17) .
وتتحدد رؤية التفكيك لفلسفة الميتافيزيقا الغربية على أنّها نظام مركزيّ من ناحية أنّ كلّ وحدة من وحداتها يرجع إلى مركزية ( الإله ) ، أو ( الإنسان ) ، أو ( العقل ) ، وقد دخلت هذه المراكز الثلاثة في علاقة جدلية عبر مراحل تطورها إلى أن وصلت إلى التفكيك ، ويمكن تحديد مراحل تطور تلك المراكز بأربع مراحل (18) :
1. مرحلة العصر المسيحي المُبكر إلى حدّ القرن الثامن عشر .
2. مرحلة القرن الثامن عشر وفلسفة التنوير إلى حدّ القرن التاسع عشر .
3. القرن التاسع عشر إلى منتصف القرن العشرين تقريباً .
4. المرحلة الأخيرة بدأت مع عام 1966 ، انبثاق معطيات دريدا النقدية .
اتسمت المرحلة الأولى بكون ( الإله ) هو مركز كلّ شيء ، وهو الأصل لكلّ الموجودات ، والنِتاجات : العلمية والدينية ، وفي المرحلة الثانية تخلخلت مركزية ( الإله ) ، واعتقد الإنسان أنّه يستطيع أن يتربع على عرش هذه المركزية ، وفي المرحلة الثالثة طردت العقلانية المركز ، وأصبح اللاوعي ، أو اللاعقلانية هي المركز وأصل الأشياء ، ووصلت المرحلة الأخيرة إلى شواطئ دريدا الذي أعلن ( بجرأة ) خلخلة كل تلك المراكز ، بحيث أصبح لكل تركيبٍ ونصٍ مركزاً خاصاً به ، يمثل المَعين الأساس للمصدر النهائي للمعنى ، ويُوصف باستحالته لإمكانية الاستبدال مع غيره .
وقد تركت كل مرحلة من تلك المراحل ـ تحديداً الثلاث الأوائل ـ أثراً في التحليل التفكيكي عند دريدا ، فالأولى تتسم بسيادة السلطة البابوية وسريان الحكم الكنسي الذي مزّق حضور الإنسان بإحالته المستمرة إلى الميتافيزيقا في كل تفاصيل إبداعه ومظاهره الاجتماعيـة ، أما المرحلة الثانية فتمثل ردّة فعلٍ على سلطة الكنيسة ، وتسلّم لإمكانية التواصل والإبداع بعيداً عن الاستناد إلى حكم يوظفه رجال الدين طبقاً لرغباتهم ، ولمصالح الأحكام اللاهوتية غير المُقنِعة ، وفي المرحلة الثالثة لم يستطع الإنسان قيادة رغباته وتطلعاتـه ، بل لم تقدم له عقلانيته مادةً يزدان بخططِها ، وتكون بمثابة طوق نجاةٍ لأزماته المتكررة ، وهذا ما دفعه إلى اللامعقول ، واللاوعي ، أو ممارسة فعل الأضداد على طول سلوكياته ، وتمثل هذه المرحلة تصورات ما بعد الإنسان ( Post-humain ) ، وتوصف بأنّها مرحلة تأليهٍ ( Divinisation ) لقدرات الإنسان ، وتأرجحٍ بين تمثيل وظيفة النص ، وإلغاء النموذجية الفردية الإنسانية التي هي أصل في خلق النص ، وانطلاقاً من ذلك اعتمد دريدا في نقده لمظاهر التمركز على فكرتين اثنتين هما :
1. التوجه نحو البنية والتركيب بشكل مستمر ، وكلّ الأنظمة والبنى تمتلك مركزاً ( نقطة للأصل ) .
2. كلّ الأنظمة أو التراكيب تتألف من أزواجٍ أو ثنائيات متعارضة ، وهذه الثنائيات هي الأصلُ في مشروع هدم التمركز ، وهناك ـ بشكلٍ دائمٍ ـ طرف له أهمية تفُوق أهمية الطرف الثاني في هذه الثنائيات .
ويؤكد دريدا أنّ مهمة الاستراتيجية التفكيكية هي تفادي تسكين المتعارضات الثنائية الميتافيزيقية ، فمن خلال اختلافها يتولد المعنى (19) ، وقد مثلت هذه المهمة الخطوة الأولى في نقد التمركز ، لأنّ ولادة المعنى كانت محكومة بسلطة اللوجوس ، والدلالات المتأتية من خلال هذه السلطة هي دلالات ذات صفة منطقية وعقلية ، وقد مثّل تفكيك دريدا لهذا التمركز تقويضاً للأصل الثابت وتصميماً في مسار مُلكية المعنى وانتقاله (20) .
إنّ إعلان دريدا عن هدم التمركز ، هو إعلان عن تدمير جميع الدلالات التي تجد مصدرها في دلالة اللوجوس ، وتفكيكها ، وتذويب رواسبها المتعاقبة ، انّ جميع التحديدات الميتافيزيقية الحقيقية ـ حسبما يقدر دريدا ـ هي غير قابلة للفصل عن هيئة اللوجوس الذي يحط من قيمة الكتابة المنظور إليها بوصفها وساطة لتحقيق القصد ، ويقود من ثمّ إلى السقوط في برانية المعنى أو خارجيته (21) .
ويهدف دريدا من نقد التمركز حول العقل ( Logoscenterism ) إلى تحطيم الأصل الثابت للمعنى بوصفه مصدراً ، وتقويضه وتحويل كل شيء إلى خطاب ، وتذويب الدلالة المركزية ، ومن خلال هذه العملية تتحول الكتابة إلى أهمية قصوى ، ويصبح الاهتمام بالكلام مضمحلاً ، ولا شك أنّ التمركز حول العقل في الفلسفة الأوربية قد نهض على الاهتمام بالكلام على حساب الكتابة ، وقد فتح هذا التوجه مركزاً آخر هو التمركز حول الصوت (Phonocenterism ) (22) .
وقد شكلت نقطة اللوجوس بحدّ ذاتها تشعباً دلالياً ، وتفرعاً إيحائياً ، نظراً لما تحمله من موروث فلسفي ولغوي ، وقد ربطها دريدا بالتمركز ، ووظفها لكشف تحيزات الفكر الغربي وتمركزه حول المنطوق على حساب المكتوب ، وتحيل مفردة اللوجوس التي تختص بقِوى التحكم بالكون ، وصفة من صفات الذات الإلهية ـ كما صوّرها الفكر الغربـي ـ تحيل إلى فضاءات ثلاثة : ( فضاء اللغة والتشكل اللساني ، وفضاء الفكر والعمليات الذهنية ، وفضاء الكون الحدسي) ، وتُشكل هذه الفضاءات المُعادل الحقيقي لمصدر العقلانية في الكون كلّه ، فضلاً عن أنّ المعنى الآخر للوجوس يتحدد بصفتي الحق والقانون ، بمعنى آخر : يتحدد بمبدأ الهيمنة والسيطرة ، والشعور بالسيادة والتعالي ، إنّه قضية فكرية ، وفلسفيـة ، وطروحات معرفية أشبه ما تكون بمتاهةٍ سادت بنية الفكر الغربي منذ عهده الأول مع اليونانيين وحتى عصر سيادة الكنيسة (23) .
ويتجه التفكيك لنقد المركزية الغربية وركائزها العقلية التي تمحورت حول فكرتيــن : ( التمركز حول العقل ، وفكرة الحضور ) ، وطمحَ هذا التوجه إلى تقويض كل المراكز الدلالية وبؤر المعاني التي تشكلت حولهما ، لأنّ الممارسة الفكرية الغربية حول اللوجوس أنتجت مركزاً عقلياً أقصى كل ممارسة فكرية لا تتمثل شروطه ، لأنّه ربط بينه وبين الحقيقـة ، وأنتج نظاماً مغلقاً من التفكير (24) ، وقد تواكبت فكرة الحضور مع فكرة اللوجــوس ، لذلك اتجه التحليل التفكيكي إلى نقضهما معاً ، أي نقض التمركز حول العقــل ، ونقض فكرة الحضور التي أطلق عليها دريدا : ميتافيزيقيا الحضور ( Metaphysics of Presence ) (25).
ويشير ( كيلر ) إلى أنّ طريقة دريدا في نقد التمركز كشفت عن أنّ الثنائيات المتراتبة والمتوالية في الفلسفة الميتافيزيقية تحلّ وتفتت نفسها ، ويخدم هذا التفتت استراتيجية التفكيك في الدعوة إلى ممارسة حرّة للأنظمة اللغوية ، للوصول من ثمّ إلى تعددٍ لا نهائيّ للمعنى ، وهذا المفهوم والتوجه قد ورد في سياق التحليل اللغوي عن سوسير ، إذ عكس مفهومه عن نظام الاختلافات مفهوم مضاد بقوة التمركز حول العقل ، لكن يبقى هذا المفهوم عند سوسير متمركزاً حول الصوت لأنّه يعتمد على علم العلامات القائم على الإمساك بثنائية الدال والمدلول بوصفها تمثلات حاضرة في سياق الكلام ( Contextualizing ) (26) .
ويشير المعطى الثالث ( نظرية اللعب ) إلى تمجيد التفكيكية لصيغة ( اللّعب الحرّ ) اللامتناهي لكتابة ليست منقطعة تماماً عن الإكراهات المغيّبة للحقيقة ، وتأكيد المعطى الثقافي للفكر والإدراك ، وغياب المعرفة السطحية المباشرة ، واستلهام أفق واسع من المرجعيات الفكرية المماثلة ، والفلسفية المعقدة ، والنظم المخبوءة ، وطرائق التحليل الخاصة ، وتتبنى التفكيكية في هذا السياق وبشكل واضح تطبيق استراتيجيات نصية وخطابية للقراءة تقلل من أهمية أيّة إحالة واثقة على منظومات ( الابستيمولوجيا ، والأخلاق ، والحكم الجمالي ) ليغدو التحليل التفكيكي ـ بعد ذلك ـ شعارات ، وكلمات سرٍّ مفرغة ـ على حدّ تعبير نورس ـ من أي مضمون معرفي أو أخلاقي أو جمالي (27) .
وبالرغم من الصيغة التي يرتضيها التحليل التفكيكي لنظرية اللعب القاضية بإحالة الدال إلى دال آخر مع تغييب متعمّد للمدلول ، إلاّ أنّ تلك الصيغة محكومة بمجموعة آليات ـ تشبه القوانيـن ـ يسطِّرها الناص ( الواضع ) ، ويستخدمها المتلقي ( اللاعب ) ، وقد حدّد ( بيتر هوجنسون ) تلك الآليات بما يأتي (28) : ( اللغز The Enigma ، التخطيط Adumbration ، الكناية Allegory ، الوهم Illusion ، الغموض Ambiguity ، المونتاج والكولاج Montage and Collage ، الأسطورة Myth ، الهذيان Nonsense ، والمفارقة Paradox ، والهزل Burlesque ، والتسلية Pastiche ، والأضحوكة Hoax ، والجناس Puns ، والإقتباس Quotation ، والرموز Symbols ) وتعمل هذه الآليات على تلّون الدوال ، وتعدد القراءات ، وتشظي الدلالة ، وانتشار المعنى بشكل متواصل ، وهذا ما دفع ( ميشال رورتي ) إلى القول : إنّ الجانب الجديد في التحليل والطرح والتنظير التفكيكي هو كونه مغامرة كشفية لامعة ، أو مجموعة من الدعايات ، والإحالات النصية ، والفواصل الفانتازية ، والمحاكاة التهكمية الأسلوبيـة ، والحوارات الفلسفية الزائفة (29) .
ولا تكاد المصطلحات والآليات السابقة تخلو من الدلالات السلبية في لحظة تموضعها في النص ، وقد أتاحت هذه الدلالات إمكانية إعادة توظيفها ضمن سياقات القصد التفكيكي القاضي " بحرية الرؤية ، واستخلاص المعاني من النص إمّا جِدّاً وإما هزلاً ، وإما حقيقة وإما تمثيلاً ، وبحرية حركة الذهن مع النص طالما أُستُبعِدت فكرة الإحالة إلى مركزٍ عقلي " Loges" (30) .
ونظرية اللعب عند دريداً لا تنفصل من نقد التمركز ، لأن حركة الدوال في داخل أي مركز يسميها دريداً بـ( اللعب Play ) ، وعند تفكيك المراكز تتمتع الدوال بحرية أكبر في عملية اللعـب ، مخترقة قانون صيانة اللعبة الأساس القاضي بإحالة الدوال إلى المدلول ، وصيانته بشكل جديد يقضي بإحالة الدال إلى دال آخر في متاهة ينتج عنها تغييب المعنى ، والإحالة إلى دلالات مستمرة لا نهائية ، وليس ذلك فحسب ، بل لقد اتسمت العلامات عند دريدا بإساءة الاستخدام (Misuse ) ، وتحولت نتيجة العلامات من المصدر النهائي للمعنى ـ كما كانت عند أصحاب السيميائية ـ إلى مصدرٍ مستمرٍ للّعب ، وانتقال المعنى بين الأزواج الثنائية المتغايرة والمتناقضة ، وقد عدّ أُمناء ( جامعة ستانفورد ) هذه النتائج انهياراً حقيقياً للبحوث والجهود التي تُبذل في دراسة اللغة ، ووصفوا سعي التحليل التفكيكي لترسيخ نظرية اللّعب بأنّه شيءٌ استفزازي يعيش على بعض الانقسامات من قبيل : ( شرعي ـ لا شرعي ) ، ( عقلاني ـ لا عقلاني ) ، (حقيقة ـ خيال ) ، ( بناء ـ تهشيم ) … الخ (31) .
وإذا كانت نظرية اللعب لا تنفصل عن نقد التمركز ، فإنّها كذلك لا تنفصل عن ثنائية الحضور والغياب ، ويذكر دريدا أنّه يمكن تفكيك أي نظام عن طريق إشارات تناقضاته ، وهذا يؤدي إلى اللعب بانتظام ، ويبرز دور ثنائية الحضور والغياب في قراءة الاستراتيجية التفكيكية الخصوصية ، التي تستند إلى قراءة الفجوات والهوامش في الخبرة البدهية للحقيقة وللنصوص ، فضلاً عن تنشيط حركة التفكيك في تفعيل دلالة التناقضات والازاحات المتوارية في النص (32) .
وتقدم نظرية اللّعب تفسيرات متعددة ، وتمنح احتمالات مستفيضة ، وتعكس هذه الإمكانيات الهائلة لنظرية اللعب ، الموقف المعارض لمسيرة اختزال الكتابة ، وتقزيم الدال ، الممثلين لنبرات التمركز حول العقل ، والتمركز حول الصوت (33) .
وقد تأتى موقف نظرية اللعب هذا من قصدية دريدا في التعامل مع النص بوصفه موضوعاً غير متجانس ، فيه قوى تعمل على تفكيكه باستمرار ، فضلاً عن طريقته في التموضع داخل البنية غير المتجانسة للنص ، والعثور على توترات أو تناقضات داخلية يقرأ النصُ من خلالها نفسَه ، ويفكك نفسه بنفسه ، إنّ بنية النص الداخلية حُبلى بالقِوى المتنافرة التي تكمن وظيفتها في تقويض النص وتجزئته ـ حسب دريدا ـ (34) .
إنّ القراءة الدقيقة لمعطيات دريدا في ظل ( نظرية اللعب ) تقدم تصعيداً دلالياً لمركزٍ مُهشـم ، وقراءة مخصوصة بنشاط الدال ، فضلاً عن الدخول في جدلية مع دلالات ( الجدّ ) التي يستبعدها دريدا ، مؤكداً على صفة التقابل بين ( الجدّ ) و ( اللعب ) ، لاغياً ذاتية اللعب وجوهـره ، ليدخل في بنية الاختلاف ، ويفتح إمكانية الازدواج والنسخ ، ويتتبع التضمين اللاهوتي المتخفي في انساق اللعب وخطواته ، ويبين دريدا أنّ النص لا يكون نصاً إذا لم يخفِ قانون تأليفه وقاعدة لعبته (35) ، ولا شك أنّ تخفيض نسبة الحضور في سياسة البناء النصية تزيد من فعالية القراءة وحضور المتلقي ، لأنّه هو المَعنيّ بثقافة الغياب التي يقصدها النص ، وهو المُدرِك لعملية تحول الاختلاف ، وتصيّد التغاير .
ويرتبط بمصطلح ( اللعب ) عند دريدا ، مصطلح المراوغة ( Indeterminacy ) الذي يقتضي مراوغة المدلول للدال بحيث تتحول العلامة اللغوية إلى علامة عائمة ( Floating ) يحاول القارئ تثبيتها للوصول إلى المعنى ، ولم تقتصر مراوغات دريدا على لعبة تفسير النص فحسب ، بل لقد تجاوزت ذلك إلى تفكيك المؤسسات والحكومات ، والتصدي للثقافات المهيمنة والمتعالية (36) .
إنّ الآفاق التي يريد دريدا تقديمها للنقد المعاصر تنطوي على أُسُسٍ خادعة ، ومداعبات يُطلق عليها ( الهرطقة ) ، إنّه يحاول توسيع مدار الفانتازيا النصية ليصل بالدوال إلى الحدود الدنيا للاتزان الدلالي ، إنّه يدفع المعنى إلى حقولٍ لا متناهية من التجنيد المعرفي والثقافي ، فالتفكيك ، والتقويض ، والتفتيت ، والتهشيم ، كلّها مفردات تحيل النص إلى ثقافة ظله ، الناتجة من تفكيك الأنظمة اللغوية ، إنّ التحول الدلالي في منهجية دريدا هو تحول من سجن اللغة (The Prison-House of Language ) ـ حسب تعبير جيمسون الواصف لسلوك التحليل البنيوي (37) ـ إلى سجنٍ آخر لا يقل خطورة عن السجن البنيوي الأول ، وهو سجن الدال ( The Prison-House of Signifier ) ، ويقتضي هذا التحول الإعلان عن سياق تحصيل المعنى بطريقة الدخول في لعبة الحاضر والمُغيّب ، والدخول في لعبة الإحالات الدالة التي تُقــــوم
ـ حسب دريدا ـ بتشكيل اللغة والسقوط فيها ، إنّها تتضمن تفعيل ممارسة الكتابة ، والنتيجة : تفعيل ممارسة اللّعب (38) .
أما المعطى الرابع ( علم الكتابة ) فيميل إلى منظومة دقيقة بنى عليها التفكيك أغلب مقولاتـه ، ونقدَ من خلالها مسيرة العقلانية النسبية ، وتشكل خطابها الفلسفي ، واستحداث هذه المنظومة يعبر عن موقف التحليل التفكيكي من عصور اختزال الكتابة ، وتهميش الدال ، ونزعة التمركز حول العقل والصوت ، ومجمل المعطى النقدي لعلم الكتابة ( Grammatology ) يعدّ نقداً لثنائية سوسير ( الدال والمدلول ) ، ورؤيته لدور العلامة وفاعليتها في بناء النص ، فالدال عند سوسير هو تشكّل سمعي وبصري ، وصورة لحمل الصوت ، وقد عدّ دريدا ذلك تمركزاً حول الصوت (39) ، وصورة واهمة لحمل المعنى ، وقد اقترح دريدا استبدال ( العلامة ) بمفهوم الأثر (Trace ) بوصفه الحامل لسمات الكتابة ، ولنشاط الدال (40) ، وقد تحولت اللغة وفقاً لذلك من نظام للعلامات ـ كما هي عند سوسير ـ إلى نظام للآثار ـ كما هي عند دريدا ـ وتعين تلك الآثار على ترسيخ مفهوم الكتابة ، وتوسيع اختلافات المعنى المُتحصل من نشاط دوالهـا ، لذلك عدّ دريدا علم الكتابة " بأنّه علم للاختلافات " (41) .
والأثر هو كلّ عنصرٍ يتأسس من آثار العناصر الأخرى في النسق ، عبر لعبة الاختلافات المتعددة التي تفضي إلى خلق فواصل بين عناصر اللغة ، وهذا يحيل إلى وجود الاختلاف في داخل انساق النص ، أي اختلاف وإرجاء وإزاحة ، ويطلق دريدا على هذا النسيج ( الكَتَبَة : Gramme ) أو وحدة الكتابة أو عنصر الكتابة ، ومفهوم الكتابة الأصلية عند دريدا لا يُحيل إلى أصل ، وإنّما إلى ما يسبق التقسيم الثنائي ( الدال والمدلول ) إلى عنصرِ دلالةٍ ماديّ ، إنّه وصفٌ لكتابةٍ تتجاوز القسمة التقليدية ( كلام ، وكتابة ) وتشكل رؤية جديدة لسيادة الكتابة على الكلام ، وتقوم هذه الفكرة بشكل أساس على تفكيك الميتافيزيقا الغربية التي أقامت صرحها حول تفعيل منزلة الكلام على حساب الكتابة ، والتَمحور حول العلامة اللغويـة ، التي امتازت بازدراء كبير لنشاط الكتابة وفاعليتها (42) ، وقد وسع دريدا من ميدان التحليل التفكيكي في إطار علم الكتابة ليشمل تحديد أصل العالم بوصفه أثراً (43) .
ويرتبط مفهوم الأثر في منظومة التفكيك بمفهوم الحضور ، ماحياً التوجه الميتافيزيقي ، ومكوناً التلاعب المتبادل بين ضدي المعنى ضمن حقل الاختلاف ، والأثر الأصل يرتكز على إدراك وظيفة الاختلاف ، وتصبح قضيته قضية الإدراك ذاته ، فالكلمات المُتسِمة بالنشاط الدلالي لا تظهر أبداً بذاتها دون الاختلاف والتضاد ، ودون بنية العلامة التي تمنح كل مفردة شكلها وهويتها ، إنّ فضاء الأثر الدلالي يستدعي التأمل في عملية الظهور ( الحضور ) المنطوية على بنية ضدية تجعل من الدوال كتابة قابلة للإدراك ، ومؤسسة على إمكانية تعدد المعنى من جهة ، ومحو حضور المرء ذاته من جهة أخرى (44) .
وقد جاءت مقولة ( الأثر ) لتمحو احتفاء الذات النقدية بالكلام ، وتجعل من تهميش الكتابة انطلاقة لها في بناء الموقف النقدي الجديد في ظل الطرح التفكيكي ، القاضي بقلب المعادلة الميتافيزيقية من ( الاحتفاء بالكلام وتهميش الكتابة ) إلى ( الاحتفاء بالكتابة وتهميش
الكـلام ) ، وقد تأتى ذلك بسبب سعي التحليل التفكيكي من التحرر من قيد الأحكام الإحصائية التي تغلغلت في ميادين البحث والتحليل اللغوي لاسيما في السيميائية ، ودراستها عن ماهية العلامة ووظيفتها ، وقد نُظِر إلى الأثر في هذا السياق بوصفه المفهوم البديل للعلامة ، والاختلاف المتواصل للدوال (45) ، والعملية المستمرة لتعدد المعاني ، ولذلك صرح ( كيلر ) بأنّ الكتابة عند دريدا تعود إلى مزيد من الكتابة المتواصلة من دون حدّ معينٍ لمعانيها (46) ، إنّها بمثابة المقطوعة الموسيقية ذات المواضيع المختلفة التي يطلق عليها ( Fugue ) .
إنّ الوحدة الإنتاجية لعلم الكتابة وهي ( الأثر ) تقود إلى بنودٍ أخرى في سلسلة الطرح التفكيكي ومن تلك البنود مصطلح الانتشار أو التشتيت ( Dissemination ) الذي يوحي بتكاثر المعنى وانتشاره بطريقة يصعب ضبطها والتحكم بها ، وهذا التكاثر يوحي باللّعب الحرّ ( Free Play ) الذي لا يتصف بقواعد تحدّ هذه الحرية بل هو في حركة مستمرة تبعث المتعة ، وتثير عدم الاستقرار وعدم الثبات ، ويتسم بالزيادة المفرطة " (47) ، ويتجلى ذلك في مصطلح (Pharmakon ) الذي يعني ( الدواء ، السم ، العلاج ، الترياق ، … الخ ) ، وقد ذكر دريدا أنّ ( Pharmakon ) يمارس علمه بالإغواء ، فهو يدفع كل القوانين المألوفة والطبيعية ، وهو متضمن في بنية اللوجوس ، وهذا التضمن إنّما هو تضمن هيمنة وقرار ، ولا يمكن السيطرة على نسقه النصي سيطرة مطلقة ، ودلالاته تستطيع نفي ذاتها من خلال اختلاف بنية حركاتها ، وتمثلاتها لمعانيها (48) .
ومن البنود الأخرى في هذا الإطار مصطلح : التكرارية ( Iterability ) الذي يشير بشكل أساس إلى قابلية اللغة على التكرار ، لا على معنى فعل الكلام ( Speech Act ) وتفريعاته ، والتكرارية قضية ترتبط بتكرارية الأصل ، مثل اعتماد الأثر على ( الأثر الأصـل ) ، واعتماد الاختلاف على ( الاختلاف الأصل ) ، وتُعدّ التكرارية أصل لكل ما يقبل الوجود ، وهي شرط إمكانية إعادة الإنتاج والتمثيل والاقتباس ، فضلاً عن أنّ احتمالية التكرار هي أساس احتمالية الغياب ، وتعدد المعنى ، وتغييب المدلول ، والتكرار هو أساس الهوية لأنّه يعتمد على إدراك علامات المشابهة بين الهوية وآخرها ، وتعتمد هذه العلامات في الوقت نفسه على قابليتها وقدرتها على الاستنساخ والتكرار ، حتى قيل : أنّ الهوية القابلة للتكرار هي الهوية المثالية ، وبدون التكرار لا وجود للحقيقة حسب الرؤية التفكيكية (49) .
ولا شك أنّ مصطلحات مثل : ( الأثر ) و ( التكرارية ) و ( الانتشار ـ التشتت ) قد أحالت إلى فضاءات التشكل الدلالي لقيمة الكتابة من جهة ، ولتعدد المعنى واختلافه من جهة أخرى ، هذه الفضاءات قد كشفت ميل اللوجوس وسيادته على الفكر الغربي لقرون عديدة ، إنّ علم الكتابة الذي اقترحه دريدا أثبت أنّ الخصائص الشكلية النحوية تقبل البناء والتقويض ، وأنّ النحو بخواصه القائمة على خدمة المعنى وتصوير الحقيقة والوجود ، قادر على خلخلة البنية الدلالية نفسها ، بل انّ النحو غدا المعادل الحقيقي لمفهوم الكتابة في علم الكتابة (Grammatology ) (50) ، وقد وُصِف هذا العلم ـ كما اقترحه دريدا ـ بأنّه نظام يُؤسِس العملية الأولية التي تنتج اللغة ، ويظهر هذا النظام على خلفية من نشاط البحث اللساني السيميائي ، ويطمح هذا العلم أن يحل محل السيميائية التي طرحها سوسير ، لأنّها تتضمن تمركزاً حول الصوت ، وقد استطاع دريدا نَقد هذا العلم الأخير ، وتقديم البديل له المتمثل بعلم الكتابة الذي يفترض عدم وجود شيء قبل اللغة أو بعدها ، فجميع المفاهيم الميتافيزيقية التي تدعي تمركزها وأسبقية وجودها على اللغة مثل ( الحقيقة ، والعقل ، … ) هي من نِتاج المجاز والاستعارة ، وبهذا تكون اللغة هي الأساس في تشكيلها ، لذلك سبق وجودها وجود تلك المفاهيم الميتافيزيقية (51) .
إنّ استخدام مصطلح علم الكتابة هو استكشاف لأبعاد التمركز حول الكلام الذي سار مع عصور الفلسفة الغربية منذ أفلاطون وإلى العصر الحديث ، وتحديداً ( منتصف القرن العشرين ) وقد تأتى تركيز الخطاب الفلسفي الغربي على عنصر الكلام وإهمال أو تهشيم الكتابة نتيجة كرهِهم لها ، وخشيتهم من قوتها بوصفها ذات إمكانيات كبيرة في توسيع الأفق الدلالي ، فضلاً عن قدرتها في تدمير الحقيقة الفلسفية التي يرى الفلاسفة أنّها حقيقة نفسية خالصة وشفافة ، ورأوا أيضاً أنّ تدوين الحقيقة بالكتابة هو بمثابة تدنيس لها ، وتُثّبِت الكتابة ـ حسب الخطاب الفلسفي ـ وَضعَاً جامداً للمعنى لأنّها تقوم بذلك بمعزل عن النسق الحيوي الذي يفترضه الكلام المعبر عن الحقيقة ، وقد رأى أفلاطون ( ـ 347 ق.م ) في هذا السياق أنّ الكتابة هي عاجزة بشكل دائم ، ومتطفلة على ميادين الكلام ، وهي محاكاة ميتة للفعل الكلامي (52) ، وفي هذا الإطار كانت الكتابة على الدوام تابعة لرتبة الكلام وخاضعة له ، في حين أعطى التحليل التفكيكي منزلة عظيمة لها ، وجعلها بمنزلة الكلام بل جعلها تتفوق عليه (53) ، وقد أكدّ تودوروف أنّ الكتابة تقدم اللغة بوصفها سلسلة من العلامات المرئية التي تعمل في غياب المتكلم ، وأنّ تلك العلامات تعمل على تقديم دلالاتها طبقاً لطابع الاختلاف الذي يسودها (54) ، وتمتاز تلك العلامات بخصائص مهمة تمتلكها الكتابة ولا يمتلكها الكلام ، منـها (55) :
1. يمكن تكرارها مع غياب سياقها .
2. قدرتها على تحطيم سياقها الحقيقي ، وقراءتها ضمن أنظمة سياقات جديــدة .
3. قابليتها على الانتقال إلى سلسلة جديدة من العلامات لتشكيل فضاءٍ جديدٍ للمعنى .
4. قدرتها على الانتقال من مرجع حاضر إلى مرجع آخر في السياق النصــيّ .
ومن المهم ذكر أنّ " حضور الكتابة وإنجازها لنفسها يُعدّ تهديداً لمركزية حضور العقـل ، ومركزية حضور السلطة ، ومركزية حضور الجسد خارجها ، وإذا كان ثمة حضورٍ للحقيقة فإنّه يتمثل في تفكيك الكتابة لكل هذه المراكز ، لا لتكون مركزاً بديلاً ، ولكن لتكون قراءة قد يطل منها الغائب والممتنع ، وما لم يُفكر فيه ، والهامشي ، والمنفي ، وما لم يتخلق جسداً على المحتمل والممكن … " (56) .
أما المعطى الأخير ( الحضور والغياب ) فيشكل تتويجاً نقدياً للمعطيات السابقة ، لأنّه يمثل الثمرة المعرفية للتحليل التفكيكي ، والهوية المحدِدة له ، وهو الأصل في الرصيد النقدي للطرح التفكيكي ، لأنّ جميع إجراءات المسيرة النقدية للتفكيك تخضع لحضور الدوال وتغييب المدلول ، فضلاً عن أنّ معطيات ( الاختلاف ، ونقد التمركز ، ونظرية اللعب ، والكتابة ) تبرز فيها بشكل مباشر ثنائية الحضور والغياب ، وقد انطلق دريدا من خلال هذه الثنائيــة ـ إلى جانب المعطيات السابقة ـ لنقد توجه الخطاب الفلسفيّ الغربيّ ، وتقويض أُسسِه من خلال كشف تناقضاته واللّعب بأنظمته وممارساته ، وتحويل معادلته المعرفية مـن
( ميتافيزيقيا الحضور ) ـ حسب مصطلح دريدا (57) ـ إلى غياب المعنى واختلافه وتعدده .
إنّ المراهنة التفكيكية تتجه صوب ( الغياب ) انطلاقاً من كون المعنى الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي غير مستقر ، وغير محدد ، ولذلك أسباب عديدة منها : انحدار النزعة الإنسانية وتلاشيها في أُطر التحليل المعاصر ( الفلسفي ، والنقدي ) ، وتعدد التحولات المعرفية القاضية بنشوء المذاهب والتيارات الجديدة المُحمّلة بالفكر والمعطى الثوري ، فضلاً عن إثارة بعض النزاعات المعرفية والثقافية القاضية بطرح تظاهرات فكرية ، ومعانٍ مختلفـة ، تقود إلى التحول والتناحر بين النصوص .
وقد عدّ جيمسون ثنائية الحضور والغياب ( حدثاً مركزياً : Central Event ) في الطرح التفكيكي عند دريدا (Derridean Fashion) (58) ، وتنهض هذه الثنائية بوصفها نتيجةً من نتائج الاختلاف ومظهراً له ، ومن أجل أن تعمل منظومة الحضور لابدّ أن تمتلك خصائص النقيض وهو الغياب ، وبذلك يتم التعامل مع الحضور على أنّه مظهرٌ من مظاهر الغياب والاختلاف (59) ، وقد استأثرت فكرة الحضور المخطط التفكيكي ، لأنها تواكب اللوجوس وتمثل مبدأً راسخاً يتحدد في كون الموجود يتجلى بوصفه حضوراً ، بمعنى أنّ الوجود يتمظهر حضوره في الأشياء (60) ، وهذا المبدأ استأثر به تاريخ الخطاب الغربيّ ليتمركز حول ذاته ، وليعلي من شأن تموضع مؤسساته الفكرية والمعرفية ، وليبرهن من ثمّ على تفوق ممارساته الخطابية التي أسندت لنفسها مهمة تحديد المعرفة واحتكارها ، وبذلك ظهرت الحيوية الذاتية للكائن الغربيّ ، بوصفها الوجود المتعالي القادر على تجهيز الحلول وترميم الأزمات في كل زمان ومكان ، وقد جاء عمل دريدا لتقويض هذا التمركز ، وإحلال مبدأ الغياب محل هذا الحضور ، وإسناد كل الأرصدة المعرفية إلى معانٍ متعددة ومختلفة .
وتنشأ مشكلة ثنائية الحضور والغياب من اختلاف دلالة التيقن وعدمه في مفردة الاختلاف ، فتعارض الدلالات التي يقوم عليها الاختلاف ، وحضور الدال وتعدد مدلولاته ، وغياب أو تغييب بعضها ، والمتوالية المؤجلة من سلسلة العلامات اللانهائية ، كلّ ذلك يؤكد أنّه ليس هناك حضور مادي للعلامة ، هناك لعبة اختلافات حسب ، وهناك سعيٌ وراء المُغيّب في اللغة ، والمعاني المُؤجلة بشكل لا نهائيّ ، وهذا يدفع إلى الحدّ من هيمنة فكرة الحضور (61) .
ويرتبط بثنائية الحضور والغياب مصطلحات ابتدعها التحليل التفكيكي منها : المتاهة (Aporia ) ، والزيادة ـ الإضافة ( Supplement ) ، وتسهم هذه المصطلحات ـ حسب إيكلتون ـ في تفعيل تكتيك النقد التفكيكي الذي يقوم على إظهار أنّ النصوص تضع أنظمتها في مطبّات عديدة ، ويُظهِر مسار هذا النقد أعراض تأزم النصوص ( Symptomatic ) ، وبنائها القائم على المتاهات ( Aporias ) ، ومأزق تصيّد المعاني ، ويؤدي هذا التوجه إلى اضطراب النصوص واهتزازها ، وممارسة مناقضة ذاتها بشكل مستمر (62) .
يرتكز مصطلح ( المتاهة ) على شرح القراءة المزدوجة ، فالتفكيك لا يسعى إلى الوصول إلى حقيقة معينة في معرض نقده للتمركز الغربيّ ، أو أنّه لا يسعى إلى تقديم بديل عن تناقضات هذا التمركز ، إنّما يمارس قراءة وكتابة نقدية مزدوجة تهدف للوصول إلى منطقة مغلقة تضفي التناقض على المعاني وتصبح غير قابلة للتحديد ، وتكون الحقيقة الوحيدة التي يستطيع التفكيك تقديمها هي : تمُوضع المتاهات في ثنايا النصوص وأنظمتها الدلالية (63) ، في حين يرتكز مصطلح الزيادة ـ الإضافة على تمييز الأصل الأولي بذاته عن كل ما يمكن إضافته إليه ، ولابدّ أن يتحدد هذا المصطلح وفقاً لذلك على أنّه سمةٌ أساسيةٌ في هوية الأصـل ، والوسيلة الوحيدة التي من خلالها يتأتى للأصل أن يتحدد ويتميز عن غيره ، وهذه الرؤية كانت تُشكل ـ قبل معطيات دريدا ـ خطراً معرفياً انطلاقاً من وصف حضور الكتابة على أنّه تهديدٌ مستقرٌ داخل حضور اللفظ ، بوصف الكتابة حضوراً لاختلافات المعنى ، وعلى هذا لابدّ أن تشبه الزيادة أو تختلف في آن عمّا يلحق بها أو عليها ، ولابد أن تستدعيها حالة نقص جوهري فيما أضيفت إليه ، ويكون ـ فضلاً عن ذلك ـ إضافة على الأصل الأولي ، واعتماداً على أسبقية الاختلاف يذوب امتياز هذا الأصل الأولي وفوقيته أمام هذه الزيادة الحاضرة (64) .
ويتبين من خلال المعطيات السابقة للتفكيك أنّ المنهج النقدي الذي خطّه التفكيك ورسم ملامحه ، وحدّدَ أُطره ، يُعدّ ثورةً على العلمية البنيوية أولاً ، وعلى الوصفية النقدية التقليدية ثانيـاً ، ويرى النص بوصفه الحامل لمعانٍ كثيرة ، وساذجة في الإطار نفسه ، بحيث وُضعت معطيات التفكيك بين خصوصية النص من جهة ، وخصوصية القارئ من جهة أخرى ، وبينت تلك المعطيات أنّ العلاقة وثيقةٌ بين النص والقارئ ، بوصف الأخير المُكوّن العقلاني لتشكيل المعنى الجديد المنطلق من حيثيات أنظمة النص ، وهذه المسألة كانت مدعاة عند التفكيك لإعادة النظر في منهجية النقد التقليدي لمرحلة ما قبل البنيوية ( Pre-structuralism ) ، ومرحلة البنيوية ، لبناء فكر نقديّ يقوم على وظائف دلالية تتوزع بين النص وقارئه ، فالأول ينهض بمهمة تغييب المعنى ، وانتشار الدوال ، وينهض الثاني بمهمة تلمس الاختلافات الناتجة من تعدد المعاني النصية ومتاهة مدلولاتها .
إنّ الركائز التي ينهض عليها المنهج التفكيكي تستند إلى فرضية نقدية مهمة تكمن في البحث عن البديل للكسل الذهني المحيط بالنصوص ، والخروج عن المألوف السائد ، وقد أتاحت هذه الفرضية تماسك أجزاء النقد التفكيكي ومعطياته ، بحيث لا يمكن فصلها إلاّ لأغراض التحليل والدراسة التي تتصيد الظواهر الجديدة ، وتكشف محتواها كلّ على حدة ، فالاختلاف المتأتي من ( خَلَفَ ) و ( إختَلَف ) الذي يحمل معنى التعدد ، ولا يحمل معنى الضدية بالضرورة هو المصطلح الذي يُصوِّر المعنى اللغوي المتعاقب ، الذي يمكن وصفه هنا بأنّه معنى ( متواليات ) ، أي بوصفه متوالية عددية يُشكل فيها المعنى اللاحق مُضاعفةً دلاليةً للمعنى السابق وهكذا دواليـك ، وقد وُصفت مهمة تحديد المعاني المتتابعة والمتوالية والمختلفة لاتجاه زاوية نظر القارئ ، بحيث يُؤلف هذا القارئ النص تأليفاُ جديداً ، منطلقاً من سلطة الإدراك التي تمنحه جواً مشحوناً بثقة عالية تستشف من خلالها جماليات النص ، ومنح سلطة الإدراك للقارئ لا يعني مطلقاً الاستهانة بالنص ، والحطّ من جمالياته ، بل تعني ـ من جملة ما تعني ـ الإمساك بزمام المعنى ، والمبادرة بكشف دلالة النص ، قبل سيطرة سحر النص وألاعيب حركة دواله على حركة القارئ وفاعليته .
ويمكن فهم دلالة المعاني المتعددة من وجهة نظر النقد التفكيكي من خلال عدّ اللغة شكلاً من أشكال الاتصال ، ولا حقيقة خارج هذه اللغة ، وكلّما جرت المحاولة للتخلص والإنس