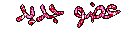مواقف رجل تعليم بالريف
مواقف1
"" قررت ،استجابة لطلب صديق حميم ،أن أنشر بعض المشاهد والمواقف ،كنت أحكيها له ،بالرغم من اقتناعي الأكيد بعدم أهميتها واستحقاقها للنشر.""
عشرون سنة مرت ، ومر معها عنفوان الشباب وزهرته وحماسته ، على أول وآخر تعيين لي ، في منطقة جبلية بنيابة الناظور بشمال المغرب .
عقدان من الزمن مرا على انتقال من وضع إلى وضع ،ومن حال إلى حال.انتقال من ليونة في الحياة إلى مشقة في ظروف العيش والتعايش مع نفسيات وأمزجة مختلفة ومتباعدة؛من هناء الصحة والفراغ والاستئناس بالأحباب إلى غبن الانشغال والبعد عن العائلة والأصدقاء؛من سواد في الشعر ونضارة في الوجه إلى علامات أحدثها الدهر ،لاينفع معها صبغ ولاتجميل عطار.انتقال من راحة بال العازب إلى مسؤولية الزوج والأب.
عشرون عاما ،رأيت خلالها أبوي يكبران ،وحملت أحدهما يوما على كتفي والقلب منفطر لفراقه وعدم الوفاء بحقه.بكيت يوم قرأت رسالة رثاء له، كتبتها ابنتي بنت العشر سنين.
عشرون حولا ، تمحو السعادة فيها ما يسبقها والحزن ما يتقدمه ، تعلمت فيها وخبرت أشياء إلا نفوس الناس وما ينتابها، ولي فيها تأثر بالغ من أحداث وتأثير قليل.
كنت منشغلا بتحضير كأس من الشاي عندما دخل علي أحد الزملاء ،الذي قضى سنين عددا قبلي في المؤسسة. نظر، بعد أن سلم علي ، إلى أرجاء المكان الذي لم يعد صالحا للتدريس ،واتخذته مسكنا ، على الرغم من طمع حارسة المدرسة في جعله خما لدجاجها.
تحدث الشاب إلي متأسفا على سنوات قضاها من عمره في قسم بنته إسبانيا ولم تكلف دولة الإستقلال نفسها عناء ترميمه وإصلاحه.تجاذبنا أطراف الحديث ، ونحن نرشف الشاي ،في كل شيء ولاشيء؛وفجأة عدل زميلي من جلسته ونظر إلي مستعدا للإفصاح عن كلام خطير.كان يتفحص وجهي، وهو يحدثني ، لمعرفة وقع كلامه من نفسي . كلام ، كنت أستقبله تارة بتبسم ،وتارات أخرى بالاستغراق في التفكر والحزن العميق.
فهم الزميل أنه جانب الصواب حين اقترح علي ادعاء الرغبة في الارتباط ،زواجا، بإحدى المعلمات الخمس اللاتي شاركنني التعيين بالمؤسسة ،بعد أن علم مني ،أثناء حديثنا ،عدم اقتناعي بالزواج بموظفة ،سواء في حقل التعليم أو في غيره .
تعجبت غاية العجب من قصده من وراء ذلك ،حيث لم يكن سوى الطمع في التنعم بازدراد الحلوى
والسباحة في* الحريرة*،كما قال، والتي علم، مني كذلك، أني أحبها وأفضلها على كثير مما يشتهيه أغلب الناس.
يتبع
مواقف (2)
ودعني محب الحلوى ، بعد أن قضى على مدخرات كنت أحسبها كافية لمؤونة أسبوع ،محذرا إياي من زواحف خطيرة ، ومما لايخطر على بال ، محيطة بالمكان تتخفى في واضحة النهار تنتظر غسق الليل لتتجول حرة منيعة ، تفعل ما تشاء بمن تشاء .
ضحكت في نفسي من كلامه وقلت : سبحان الله ،يأتي على زادي ويسعى إلى إخافتي، يخلق الله مايشاء .
نظرت إلى الشمعة وهي متشبثة بالعطاء . لاتريد أن تتركني لأحزاني ولا أن تزيد الظلام لظلمة المكان . دخلت فراشي ووضعت خدي الأيمن على كفي وأطلقت العنان لفكري . ولست أدري ما ذكرني تلك الليلة صاحبا لي في الدراسية الإعدادية ، كنت أحبه وأجد فيه الرفيق الأنيس المخلص .
كان شديد الحياء ، يبادلني المشاعر نفسها ، ولا يجد في نفسه حرجا مني إلا إذا تحدثت في شأن زميلة لنا في الدراسة ، جمع الله فيها ماتفرق في غيرها ؛ تفوق في التحصيل، و حسن في الوجه وفي القوام ،وحشمة في اللباس وفي الكلام .
كنت كلما نظرت إليه وجدته ينظر إليها . وكان إذا ذكر اسمها احمر وجهه وعرق جبينه ، وإذا مرت بنا تسارع خفقان قلبه ، ونشف ريقه ، واضطربت أطرافه ؛ أما إذا ما تحدثت إلينا فلا ينبس بكلمة وإذا مانطق لايكاد يبين .
ما بادرها بالكلام يوما ولا منها تقرب . وكان كلما اقتربت عطلة الصيف ذهب منه الشحم واللحم ، وكثر منه السهو والنسيان ، تحسبا لفراق طويل .
غادر صديقي الوطن رفقة والديه . ولست أعلم من أمره شيئا منذ ذلك الحين . لكني أذكره كلما قرأت تغزلا عذريا بامرأة في قصيدة شعر أو قصة حب ، وتحضرني صورته كلما سمعت حكاية عما جبلت عليه الأنفس من ميل بين النساء والرجال .
يتبع
مواقف (3)
كانت العين تأخذني ، مرة بعد مرة ، إلى مساكن متمسكة بحفاف الجبال ، وأخرى منتصبة على رؤوسها ؛ لانظير لبعضها ، لا في الحاضرة التي أتيت منها ، ولا في المدينة التي أقطن بالمرتفعات المتاخمة لها ؛ ولولا الحمير والبغال والمعز والخرفان ، وغياب جميع مرافق الحياة ، لخلت نفسك في مدينة يسكنها ، فقط ، الأغنياء ومتوسطو الحال . لاأثر للبادية ، لا في لباسهم ولا في نمط عيشهم . يتكلم معظمهم لغة عربية ، لم يتبق منها ، من كثرة اللحن ، إلا اسمها ؛ تعلمها الشباب في المدرسة والكهول والشيوخ في الأسواق والمساجد .
أخبر أحد الزملاء الثلاثة الذين كنت رفيقهم سائق سيارة الأجرة ، المتجهة بنا نحو مدينة مليلية ، أن مقر سكناي المثبت في بطاقة تعريفي هو مدينة وجدة وليس الناظور ، التي تسمح سلطات المستعمر الإسباني لأهلها بولوج المدينة دون حاجة إلى تأشيرة وجواز سفر . نظر إلي ، من خلال مرآة السيارة ، وطلب مني توسط جليسي وعدم إطالة النظر إلى حرس الحدود .
دخلنا المدينة بسلام آمنين ، ولا أدري لم أحسست بالاختناق وأنا أرى شوارعها الضيقة ودورها الصغيرة المتراصة . أحسست أني داخل علبة كبريت ، لا فضاءات واسعة غير حديقة ، لم تمر إلا دقائق معدودة على دخولنا إليها حتى وقف علينا شرطيان .
طلب منا ، أكبرهما سنا وأقصرهما قامة ، بطائق هوياتنا . تفحص التي تخصني مليا قبل أن يرجع الأخرى إلى أصحابها ويطلب مني مرافقته إلى سيارة الشرطة . رفضت الصعود لولا نصح أحد الزملاء ، والذي أخبرني فيما بعد ، أن سبب اشتياط الشرطي غضبا ، ورفضه شفاعة زميله لي ، وتمسكه بتسليمي إلى مخفر الشرطة ، هو مخاطبتي له باللغة الفرنسية وادعاء جهلي بالإسبانية .
رفعت ذراعي ، لأسمح لشقراء ، لم تتجاوز العقد الثالث ، بتفتيشي . أخذت وقتا كافيا قبل أن تشير إلى زميل لها بوضعي داخل الزنزانة .
نظرت إلى أصحاب السجن ، فرأيت وجوها ليست كالوجوه ، وأجساما غطيت أغلبها بالحيات والعقا رب وأسماء النساء ؛ معظمهم بين حالتي الحضور والغياب ، بين حالتي الصحو وفقدان الشعور ، في منزلة بين المنزلتين ، تنتاب أحدهم ، بين الفينة والأخرى حالات ، يقفز منها كالقرد تارة ، وينبح كالكلب تارات أخرى .
أخذت لنفسي مكانا بعيدا عن ذكور حسبتهم ، أول الأمر ، إناثا لطول شعرهم والأصباغ التي على وجوههم . لم يعرني أحد اهتماما حتى دخل ولدان ، ما لبثا أن أسرعا إلي محييين ، عرفا من خلال مظهري والنظارتين أني موظف وأغلب الظن أستاذ . سألتهما ، بعد أن هدأت من روعهما ، عن سبب اعتقالهما ؛ فعلمت ، من أنحفهما ، أنهما تلميذان داخليان بمدرسة إعدادية بجماعة فرخانة المجاورة ، دخلا المدينة ، في يوم العطلة الدراسية ، للترويح عن نفسيهما بالمشي والجلوس على الشاطىء ، فوقعا في قبضة شرطة استنفرت لحماية المصطافين في يوم نحس حا ر.
عادت الابتسامة لتعلو محييهما ، وهما يستمعان إلى حديث ، قصدته ، عن جمال وحسن قوام مرتادات الشاطىء من بنات الإسبان .
سلمنا ، بعد أن انتصف الليل ، إلى شرطة الحدود ببلدة بني انصار ، المجاورة للمدينة من جهة الشرق . أخلي سبيلي بعد كلمات قصار . أما صاحباي ، فلم يلحقا بي إلى مقهى البلدة حتى احمر وجهاهما بسيل من الصفعات . تمنيت لو تعلن الحرب ، ويفتح باب الجهاد ، فأعود إلى المدينة محررا ومقاوما للإسبان .
شربنا القهوة ، نحن والذباب ، وبحثنا عن سيارات الأجرة ، نحن والكلاب . رفضت أن أدفع له عشرة أضعاف الثمن ، فرحل الرجل بعد أن سب الدين والدنيا والناس أجمعين .
رفض الولدان البقاء ، وأصرا على الذهاب ، ولو سيرا على الأقدام ، خوفا من افتضاح أمرهما لدى الإدارة حين يحل الصباح . حاولت أن أثنيهما عن المغامرة حتى تأتي سيارة أخرى للأجرة ، يكون صاحبها أحن قلبا وأحسن خلقا .
لم أجد بدا من مرافقتها ، على الرغم من طول المسافة ووعورة الطريق وخطورة راكبيه وقطاعه .
مرت بنا سيارة ، ثلاث مرات ، ذهابا وإيابا . أحسست بالخوف على نفسي وعلى الطفلين ، وزاد قلقي لما بدأ أحد مرافقي يتمتم بأدعية ، لم أستبن منها ، غير كلمتي الله والنبي .
سلم الله ، بعد أن وقفت لنا سيارة أجرة ، رضي صاحبها ، الشهم الكريم، بخمسة أضعاف الثمن المعتاد .
انتظرت حتى تسلقا الجدار، ثم أكملت الطريق .
يتبع
مواقف (4)
اشتريت دراجة نارية ، بمعية صهري الخبير في الدراجات ، لتكون المركب الذي سيريحني من مشقة التنقل راجلا لسبعة كيلوميترات ، هي المسافة ، ذهابا وإيابا ، بين الفرعية المسند إلي فيها مهمة التدريس ،وبين الخم المأمول لدجيجات حارسة مدرستنا المركزية.
أفرغت جعبتها من البنزين صباح يوم إثنين ، واستعملتها كدراجة عادية للوصول إلى محطة سيارات الأجرة الرابطة بين مدينتي وجدة الحبيبة والناظور . سارت الأمور كما كان مخططا لها حتى محطة الوصول ، حيث سينبهني أحد الناصحين لخطورة الطريق، وصعوبة المرور وكلفته العالية ، دون خوذة، إلى بلدة فرخانة .
فكرت ثم قدرت أن الأسلم لي ولدراجتي ، والأقل تكلفة هو سيارة الأ جرة ، ثم التزود من فرخانة بالبنزين ومتابعة المسير . وكذلك كان.
كان الإياب أيسر من الذهاب . كنت أشفق من حالها وهي تتكبد عناء الصعود ، وأسعد لخفتها ونشاطها أثناء النزول .
رافقتني ، قرابة التسعة أشهر ، ولم تشتك يوما ، بالرغم من عدم اهتمامي الشديد بها . ألفها التلاميذ وتعودوا على رؤيتها أوعجلتها الأمامية خارج الفصل ،تستمع إلى قولهم وتنظر ، حين الاستراحة ، إلى أفعالهم .
كانوا سبعة وعشرين ، بين السبعة والأحد عشر عاما ، يلجون المدرسة أول مرة ، لا أحد منهم يفهم كلمة عربية ،ولايعرف مدرسهم من لغتهم الأم إلا كلمات . ملء أشداقهم يضحكون حين أحدثهم بالريفية ، يحسبونني أمازحهم والأمر لم يكن كما كانوا يظنون . تعلموا لساني ولم أتعلم لسانهم .
لست راضيا عما قدمته لهم ، فلم يكن النقص في الخبرة ودخول عالم التربية والتعليم بعد تكوين ، أقل مايقال عنه أنه هزيل وجد ضعيف ، هو السبب الوحيد .
كنت ، سواء في الصباح أو في المساء ، عند الصعود أو أثناء النزول ، أراها تتقدم ، يوما عن يوم ، بقطيعها نحو طريقي .
حدثت ، يوما ، زميلا لي عن جمالها وشبابها وحسن مظهرها وأشياء أخرى ، أستحي، بعد ما صرت إليه اليوم ، عن ذكرها بله نشرها والمجاهرة بها .
تعلق الزميل ، وهو من ساكنة الناظور ، براعية الغنم وأصر على مصاحبتي ورؤيتها والمنطقة التي تعيش بها .
اشترطت عليه ، بعد أن بالغ في الالحاح ، أن لايكلمها ، لا باللسان ولا بالإشارة ، وإذا ما أعجبته وانجذبت نفسه إليها ، نسلك الطريق الصحيح ونتبع السبيل المستقيم ونخاطب أهلها في أمرها .
نزلنا عن الدراجة غير بعيد منها . نظر إليها وأطال النظر ، ولكنها ما إن رأتنا حتى أشاحت وجهها عنا وأدارت لنا ظهرها وتشاغلت بخرفان لها . كانت أول وآخر مرة يزور فيها الفرعية إلى أن أبدله الله مكانا خيرا من مكاننا وأقرب إلى أهله وذويه .
كنت أعجب لجرأة زائدة ، في بنات المنطقة ، على الرجال ، فعلمت من بعضهم أن للنساء عليهم سطوة كبيرة ، لايقبلها ، كرما ، إلا قليل منهم ؛وبدا لي ، حينها ، أن أحد أصدقائي كان محقا عندما أخبرني أن للنساء قدرة عالية على معرفة وفك الرموز السرية للرجال .
كنا نجلس ، أغلبنا عزابا ، متحلقين حول أكواب الشاي ، لانتحدث ، لساعة أو أكثر ، إلا عن الجنس اللطيف وفيهن ، وكنت أسمع من بعضهم كلاما يضحكني وآخر يبكي من قلبه حجر أو أشد . وللرجال فيما يجذبهم إلى النساء اختلاف وتباين كبير .
فمن متعلق بالشعر الأسود الطويل إلى محب للبياض والطول إلى ميال إلى النحافة والقصر مع شيء من السمرة ويسر الحال . كنت كلما جمعنا مجلس إلا و تذكرت أحد الأصحاب ، سألني مرة ، ونحن جالسان في المقهى ، عن أحد الأشخاص يتتبع بعينيه كل طويلة قامة تمر بجانبه . قلت : لاأعرفه ، ولكن يبدو من خلال سنه وهندامه أنه متزوج وشبع زواجا . قال : نعم ، وزوجته امرأة صالحة ولكنها نحيفة وقصيرة . جزم بعد ذلك أن كل من تلحق عيناه نحيفة فالبدينة له ، في البيت ، بالمرصاد ، وكذلك الشأن بين من كان نصيبه الطول والذي له القصر . تأمل الجالسين من حولنا والرجل
ثم قال : لهذا السبب ، والله أعلم ، سمح الله للرجال بالتعداد ؛ فمن لم تكفه الواحدة أضاف حتى يكمل العدد أربعة .
لم أستسغ كلامه ولا منطقه ولكني لم أعترض عليه ، لما بدا لي من شدة اقتناعه بما توصل إليه .
لم تمض إلا سنوات قليلات حتى التحق باجتماعاتنا إخوة قدموا الدين والخلق وطيب النفس عن الجمال والنسب
والمال ، وتحولت مجالسنا إلى حلقات ذكر وعلم . كنا نتقاسم المواضيع ، حسب الميولات والاستعدادات ، ويلقي أحدنا موضوعه المختار ونمضي أكثر الوقت في مناقشة مضامينه .
أربع سنوات ستمر، بعد الوظيفة وتحصيل أول راتب ، لأجد نفسي مدفوعا ، غير مرغم ، إلى دخول القفص الذهبي ، وأصير ، بعد أن كنت خير الناس ، مثلي مثل الناس ، وأعوذ بالله العزيز المعز من سوء العاقبة، وأن أصير إلى المعرة بين الناس .
يتبع
مواقف (5)
بل خير لابد منه ، كان رد صديقي موثق عقود الزواج ، بعد أن قلت له : إنني مقبل على شر لابد منه .
وهكذا ، أصبحت رجلا مسؤولا عن رعيتي ، مسؤولا عن مأكلها ومشربها وملبسها وتوفير الظروف الضرورية لراحتها ، مسؤولا عن ادخال البهجة والسرور إلى نفسها والرفع من قيمتها ووضعها الاعتباري أمام عائلتي وعائلتها .
أصبحت مسؤولا عن أدائها للصلاة وتقريب وتبسيط مبادىء الدين ومفاهيمه إلى عقلها
وقلبها . كنت أقسو عليها ، من حين لآخر ، ليس طبعا أو حبا في الشدة ، ولكن تجنيبا لها ولهبات من الله لنا ، من سوء نتائج عادات تحكمت في الناس ، واعتبر بعضها من صلب الدين ، والأمر ليس كذلك ؛ لايستطيع الانفكاك منها وعنها إلا القليل ، خوفا أو حياء من الأهل والأحباب والمعارف والأصدقاء .
تعرفت طبعي ومزاجي ، ودارتني وتظاهرت ، أول الأمر ، في أشياء كثيرة ، إلا العلم والمعرفة وشؤون السياسة ؛ فلم تعرها ، وماتزال ، أدنى اهتمام أو اعتبار . تستمع إلي أشرح وأناقش أفكار العلماء ، أتحدث في قضايا الدين وأمور الدنيا ،وحبيب إلى قلبي أن ألج عقول المفكرين والعلماء ،أقطف من أزهار بساتينهم ما أشاء ومتى أشاء.
تهز رأسها مبدية شدة الاهتمام وحسن الانصات ، ولكني لم أر يوما سرور الفهم على وجهها ، تعتبر ذلك مضعية للوقت وانشغالا عن وصفة أكلة لذيذة أو مشاهدة مسلسل جدير بالمتابعة والاهتمام . تسوس ، وهذا ما يحيرني ، أبناءها وربما بعلها بحكمة وذكاء كبير . لم ترتح حتى وضعت حول عنقي سلسلة من خمس حلقات ، أربع إناث يتوسطهن ، كما يروق لها أن تردد، رجل البيت الصغير .
اتفقنا ، أنا وأخي الذي يصغرني بثلاث سنوات ، أن يكون عرسنا عرسا مباركا ، لاخمرة فيه ولااختلاط بين الرجال والنساء . كل فريق له حفل خاص به ، يرقص ، يغني ، يفعل ما يطيب له وما يشاء .
يبدأ حفل الزفاف ، ومدته في الغالب ثلاثة أيام ، بتقديم كبشين وبعض اللوازم إلى أهل العروس ،والموفقون هم من يحسنون اختيار الأقرنين الأملحين ،ملئا للأعين وإخراسا
للألسن . وقد تشترط العروس ، أو جدها ، كما حصل لأخ صديق عزيز ، عجلا سمينا ، وتصر على إنزاله ، من عربة النقل ، مئات من الأمتار عن منزلها . لم يجد صديقي وإخوته وأبوه الكبير في السن بدا من استئجار شاب قوي مفتول العضلات ، يقود العجل خوفا من هيجان أو انفلات يتبعه النطح والرفس لأصحاب المزامير و عباد الله من المدعوين ، من النساء والرجال ، الشيب والشباب . لم يصل العجل والتابعون له ، في ذلك اليوم المشمس الحار ، حتى بلغت قلوب الحناجر ، وتبينت لكل ذي علة علته . كان آخر من وصل الشيوخ والعجائز وأصحاب السكر والملح وضعف القلب .
ذهب كل منا إلى بيت عروسه في مساء اليوم الثاني ، لشرب الحليب وأكل التمر و التقاط الصور، واصطحاب ذات الجاه في آخر الليل إلى بيتها الجديد . و من عادة آخرين انتظار الليلة الثالثة لاستقدام زوجاتهم .
مر حفل النساء ، في ثالث الأيام ، في جو مرح ، فيه الرقص وفيه الغناء ، وفيه بركة من الله ، لايلحظها إلا قلة من ذوي الألباب . وجدت النسوة ، أغلبهن ، الوضع مريحا ، لاحرج ولا استحياء من إظهار ألوان من الفرح والانبساط .
كان حفل الليل خاصا بالرجال ، أحيته ، بعد العشاء والعشاء ، فرقة موسيقية إسلامية ، معظم فقرات برنامجها ، دون الأناشيد ، تهكم وضحك على أئمة المساجد والمفتين وسلوكات بعض المتدينين .
كنت أنظر لبعض الحاضرين مبتسما ، أرى رؤوسهم تهتز والأكتاف كلما بدأ الطبل والغناء ؛ وما لبثوا ، بعد أن رقص أخ لي ، أن توسطوا الحاضرين يبدون مهارات عالية في رقصات تتميز بها المنطقة الشرقية .
انتهى الحفل ، وذهب كل واحد إلى حال سبيله شبعانا يملأ الدجاج واللحم بطنه ، والرضى نفسه وقلبه ، حتى أولئك الذين قالوا لما علموا بضوابط الاحتفال : ألعرس تتم دعوتنا
أم لمأتم ؟ لم يضرب أحد ولا عنف . ولقد حضرت أعراسا ، على قلة عددها ، تحولت بفعل الخمرة والحشيش ، بعد أن كان العناق والقبلات والترحيب بالأهل والأحباب ، إلى مبارزات بالعصي والهراوات والسيوف والخناجر والسلاسل والحجر، يسب فيها الرجل والمرأة ، على السواء، الملة والعشيرة والبنات والأبناء .
يتبع
مواقف (6)
بشهر وبضعة أيام ، قبل قدوم خديجة ، والتي ستقضي تماما على النوم الهادئ والعميق لأبويها ، وتدخل البهجة إلى قلبي جدها وجدتها ، والسرور على أعمامها وعمتها ، وخاليها وخالاتها ، كنت مع صديق لي ، تعودنا ، بعد أن نضج كلانا وأصبحنا مسؤولين وتركنا لعب الورق ، على قضاء ما تيسر من وقت ليلتي آخر الأسبوع في لعب الشطرنج ، في مقهى جميل ، لاصغير ولاكبير ، يواجه باب المدينة القديمة الغربي ، ويبعد عنه بعدة أمتار .
كنا نجلس ساعة أو ساعتين ، أو أكثر من ذلك ، كل أسبوع ، نريض عقولنا، ونحتسي مرة قهوة سوداء ، ومرات نطلبها متسخة بشيء من الحليب ، وقد نعدل إلى المشروب الغازي أو نضيفه إذا ارتفعت الحرارة واشتد الظمأ ، ولا تنفك يدانا ، إلا قليلا ، عن سجائر التبغ .
كنا ندخن ، وأكثرنا من التدخين ذلك اليوم ، إلى أن نفذت علبتانا معا . نزلنا من الطابق العلوي ، حيث كان مجلسنا المفضل ، وقطعنا الطريق إلى كشك قريب ، بعد أن تركنا القطع والمشروبات تنتظرنا على الطاولة .
وضع الصديق مصطفى يده على كتفي ، بعد أن صرنا على بعد أمتار معدودة من بائع السجائر ، ونظر في وجهي مليا ثم قال : لوكانت مصلحة مهمة ما تركنا ، نحن الإثنين ، المقهى ونزلنا نسرع الخطى من أجلها ؛ إنها السجائر تجر صاحبها ، هكذا ، كالكلب .
أمسكت العلبة ، بعد أن دفعت ثمنها ، وقلت : ياصاحبي ، إنها الأخيرة ، فإما رجل وإما كما تفضلت وقلت .
هو كذلك ، قال بعد أن أشعل سيجارة ، أصفر لونها ، ثم اشترط ، بعد أن عدنا إلى مجلسنا سالمين ، واقتربت اللعبة على الانتهاء ، أنه من زاد ، منا ، على علبته ، دفع ثمن غذاء أو عشاء ، في مطعم ، قرب المدينة ، معروف بتقديم وجبات الشواء .
كانت الأخيرة ، تركت منها سيجارة واحدة ، وضعتها على طاولة في غرفة مسكن ، من البناء المفكك ، انتقلت إليه ، بعد أن تحسنت الأحوال ، رفقة خمسة من الأساتذة الشبان .
كنت كلما أحسست بالرغبة الشديدة في ملء صدري بدخانها ، أمررها قرب أنفي ، أشم رائحتها ، وأقسم بأغلظ الأيمان أن لن أكون ما نعتنا به الصديق أكرمه الله .
تركت التدخين ، غير آسف ، وعاد إليه مصطفى بعد مدة قصيرة . لم أطالبه ، لا بالغذاء ولا بالعشاء ، تمنيت فقط ، وما أزال ، أن تقوى عزيمته ويكبر إصراره ، فيتخلص منه ومن سمومه .
أصبح للأكل طعم ، غير الذي كان ، وعليه إقبال أكبر من الذي كان ، و أصبح للرائحة الزكية والطيب وقع أكبر على النفس مما كان .
كنت أمسك خديجة ألاعبها وأقبلها ، دون خوف من إيذائها برائحة كريهة ، في الفم كما في اللباس ، لم أعد أطيقها ولا الجلوس في المقاهي بسببها . كنت أتحاشى الوقوف إلى جنب المدخنين في صفوف الصلاة ، وأبحث ، في الولائم والمناسبات ، عن جليس ، أتوسم فيه ، من خلال لون الشفتين ، خيرا ورفقا .
سيكثر الصراخ ، بعد أقل من سنة ، في بيتنا ، وتجد البكر رفيقة لها ، تلعب بها ومعها ، تعينها وتتناوب معها على حرماني وأمهما من نوم مسترسل ، طويل أو قصير ، في الشتاء كما في الصيف .
ازدادت فرحة العائلة بهما ، وازدادت أعبائي ومتاعب أمهما . كنت أقضي ليلتين في الأسبوع ، وجميع أيام العطل المدرسية ، معهما ، أضحك لضحكهما وأفرح لفرحهما ، وغاية السعادة أسعد لرؤيتهما تكبران ؛ ألاحظ مسارعة الصاحبة لتلبية حاجاتهما ، وأعجب لصبرها ، مع ضجرها ، من بكائهما وكثرة مطالبهما .
عرفت منذئذ السر في وضع الله الجنة تحت أقدام الأمهات .
يتبع
مواقف (7)
هنأني قريب لي بالمولود الجديد المنتظر ، والذي سيتمرد على الترتيب المدبر، ويأتي في اليوم الأول من الشهر التاسع الميلادي ، على خلاف أخواته الأربع ، السابقتان له ،منهن ، واللاحقتان ، واللائي وعلى غرار أبيهن سيرين النور ويملأن الدنيا صراخا في الشهر السابع الميلادي ؛ شهر العطلة المدرسية الأول ، حيث لا التزامات العمل تشغل البال ، ولا تقلبات الطقس تعكر صفو النفس وجو الاحتفال .
حدثني القريب مطولا عن الذرية والأولاد ، وكان من أهم ما قال ، أن الذكور يولدون والفرحة بهم تغمر القلب وتملأه ، ثم تخبو محبتهم، بعد حين ، مع الكبر واشتداد العود ؛ على عكس الإناث يحجزن ، مع مرور الأيام وتوالي السنين ، موقعا متقدما لهن في قلب الإنسان ، وهن ، في الغالب ، على الأبوين أحن من البنين و أرق قلبا .
قلما تخطئ التحاليل ، في أيامنا هذه ، في تحديد جنس الأجنة قبل مغادرتها الأرحام بشهور . فما رأيت فرحتها تلك ، من بعد ، حين بشرت به. رأيت السعادة ، في كلامها وفي تصرفاتها ، ماثلة رأي العين . تبدد خوفها ، واطمأن قلبها ، وزاد علي التدلل وكثرت منها المراجعات .
علم بأمر محمد الأقارب و الأباعد . فما أخفت سره ، قبل المجيء ولا بعده ، على أحد . ومما عجبت له ولاأزال ، التكتم الشديد لبعض الناس وحذرهم الكبير من إفشاء سر من مثل هذه الأسرار، خوفا على الأولاد من العين ، السبب الرئيسي وراء إزهاق الأرواح أو النقص في العقل والأطراف . فكم من أعرج كانت عين عمته أو خالته السبب في بتر رجله أو اعوجاجها ، وكم من أعور فقئت عينه أو أعمى ذهب النور من عينيه بمشيئة جار أو قريب حسود حقود ، من الأولاد محروم .
وغريب أن يشترك في هذا الاعتقاد الأميون والمتعلمون ، والجاهلون والمثقفون ، وكثير من المتدينين . لقد التقيت أشخاصا يخافون على ملابسهم الجديدة من التقطع والنقصان بفعل العين والحسد ونفوس الأشرار، وجالست آخرين يعطون لأناس ما ليس لهم ولايحق من القدرات والطاقات والخوارق وما لا يتصوره بال . عجبت أيما عجب لما قرأت خبر مستشار كبير لرئيس دولة صغيرة ، يجلس في قاعة ينتظر دوره لرؤية شيخ يداوي الناس باللمس والبركات ، وزاد استغرابي لما سمعت ، من ثقات ، عن دكاترة وأساتذة يسلمون أجسادهم لأطباء شعبيين ملهمين مباركين يشفون العباد بالتفل والعض والقفز على الأبدان .
كانت نفسها ترتاح لما أحدثها عن قبولي بالأنثى كما بالذكر، لا فرق عندي ، وأنه من قلة الأدب مع الله أن أشترط عليه فيما يهب لي .
جميل وحسن، قالت يوما بعد تبسم ، ولكن كل الرجال ، أضافت ، يريدون وينتظرون الذكور؛ فنسلهم ، كما قلت يوما ، من يحمل أسماء الآباء والأجداد ويحافظ على استمرارها ؛ فمن تظن نفسك أنت ، تساءلت ضاحكة ، حتى تكون غير الناس ؟
قلت : لست من الصالحين وحبي لهم شديد ، وسعيي حثيث لصحبتهم ، ورجائي كبير أن أحشر معهم ؛ وأراني لست من المنافقين وكرهي لهم عظيم ، وأجد دوما في الابتعاد عنهم وعن صفاتهم ؛ وإيماني قوي راسخ بعدل الله ورحمته فيما قسم لعباده .
يتبع
مواقف (8)
نظر الحاج محمد إلى حفيده مطولا ، ثم قبله على جبينه . وضع ورقة بنكية زرقاء اللون على صدره ، بعد أن هنأ أمه به . هاهو إذا الذكر أخيرا بعد خمس حفيدات . ازدادت فرحتي بسعادته وابتهاجه لمقدم محمد . يبتسم ويلاعب الحفيدات ويتقبل التهانئ بسرور عارم باد .
لم أحزن ، فيما تقدم من حياتي ، كما حزنت لفراقه ، ولم أحس بلوعة الفراق إلا مع فراقه ، وما ندمت أشد من ندمي على تقصيري في حقه وواجبي نحوه ، وما عشت أصعب من اليوم الذي حملته فيه إلى مثواه ما قبل الأخير .
كنت مع أهلي ، بعيدا عنه بمئة وسبعين كيلومترا ، أتناول وجبة الغذاء في يوم ثلاثاء ، ولست أدري ما جعلني ، فجأة ، أطلب مفاتيح السيارة من زوجتي وأوصيها خيرا ببنتيها و بمحمد ذي الخمس سنوات .
شوق إليه كبيرجعلني أقصد مدينة وجدة مسرعا . سلمت عليه وعلى الملتفين حوله . أخذت بلحيته أداعبها وقلت له : لك السلامة يا أبتي . رد علي بصوت جد خافت : سلمك الله يا ولدي . نظر إلى خالتي وأومأ إليها أن تقوم تترك لي كرسيا تجلس عليه ملتصقا بسريره . اقتربت بأذنيها إلى فمه علها تسمع قوله . تبسم بعد أن لم تفهم مراده . لم تغادرني عيناه ، ينظر إلي وأنا أعاتبهم على عدم إخباري بتوعكه وزيادة مرضه . أخ لي ، وصل تلك الليلة من مدينة مكناس ، لم يخبره ، هو كذلك ، أحد ، ركب القطار ورجع دون سابق إعداد .
قبل آذان الفجر بساعتين ، سأقبل جبينه والدموع تنهمر من عيني . أسلم الروح إلى بارئها أحب الناس إلى قلبي ، وأقربهم ، هو وأمي ، إلى نفسي . قرأت عليه سورة يس وأنا جد متيقن أن القرآن إنما نزل للأحياء ، ولم ينزل ليقرأ على الأموات .
بكيته طيلة ذلك اليوم بكاء دون دموع ، حين رافقته إلى المسجد ، وحين صليت عليه ، وحين نظرت إليه وهو يوضع في التراب .
كان حلو اللسان ، قاصا بارعا ، يضحكني والأسرة حين يشاء ؛ يسرد علينا وعلي بالخصوص قصص الآباء والأجداد . عشت معه ، من كلامه ، مقاومة الاستعمار وعذاب السجن ومرارة ما بعد الاستقلال .
كان ملجأ العائلة ومصلح ذات البين ، سيدا حكيما إذا نطق ، ومحقا إذا غضب ، ومسامحا حليما ؛ كثيرا ما كان يردد أنه ما عصى لأبويه ، يوما ، أمرا ؛ يقول نعم ، نفذ أمرهما أم لم يفعل .
أخبرته ، يوما ، عن قريب لنا ، من جهته ، كان يحرضني عليه ، بعد أن حاولت ، دون توفيق ، دخول عالم التجارة معه . نبهني الرجل ، سامحه الله ، إلى تفريط أبي في شأني وعدم اهتمامه الكافي بمستقبلي .استمع إلي بإمعان ثم سألني إن كان القريب قد وفق في مراده . قلت : لا بالطبع لم يوفق ، لم يكن ولن يكون له ما أراد .تبسم رحمه الله وقال الحمد لله .
أسابيع ، بعد ذلك ، سيسلمني مبلغا من مال الزكاة ، ويطلب مني أن أوصله إلى الرجل الذي كان يريد بي وبه السوء . قلت : يا أبي ، أليس هو من كان يوقع بيني وبينك ؟ قال : نعم ، ولذلك به نبدأ .
كان لايحب الأكل إلا معنا . تضحك أمي ملء فيها حين يحدثنا عن النساء وما يفعلن بالرجال . ما سمعته سبها يوما ،ولا رأيته مد يده عليها . كان إذا غضب سكت . قامت به . حفظها الله ، أحسن قيام في أواخر أيامه . آلمني ، أشد ما يكون الألم ، يوما حين قال لي ، وأنا أساعده على المشي في بهو المنزل ، أنه متأسف على انشغالنا الكبير به وبمرضه .
وجدته ، يوما ، وكان قد جاوز السبعين ، يمسك بأحد السكارى يثبته على الحائط دفاعا عن جار طلب منه النصرة والشهادة . كان الجار عميدا للأمن ، واحتاج للعون والمؤازرة في زمن فسد فيه الحال ، وتأسد على الناس الضباع ومنعدمو الأخلاق .
رزقه الله عائشة وستة من الذكور . مات وهو عنهم راض . كانت البنت الأرجح عقلا ، والأطيب نفسا ، وأحن أولاده عليه وأكثرهم اهتماما به وبشؤونه . كان شديد الحب والاحترام لها ولزوجها . تزوره وتعوده ، مرة واحدة ، على الأقل ، في الأسبوع ، إلى أن وافاه الأجل ورحل كما يرحل جميع الناس .
ما زلت ، بعد خمس سنوات من غيابه ، أرى صورته الأخيرة تلك ، كلما نظرت إلى مكانه على السرير في غرفته . رأيت أمي ، بعد مدة من انتقاله إلى جوار ربه ، تمسك قميصا له بيديها ، قبلته ثم شرعت في البكاء . ربت على كتفها وانصرفت .
ثلاثة من الأمور استوقفتني يوم رحيله ، فلا صراخ ولا عويل ، إنما بكاء ودموع ، حتى من ابنة عمة لي ، كان من عادتها النواح ؛ بادرتها ، حين عزتني باكية ، بطلب الدعاء له بالرحمة والمغفرة . سكينة ذلك اليوم ، أحس بها الجميع وخففت من حزني وانفطار قلبي .
الأمر الثاني ، حين الذهاب به إلى المسجد وإلى المقبرة . توسطت وإخوتي به المشيعين ، فلا أذكار ولا حديث ، دعاء خفي تتحرك به الشفاه في صمت رهيب .
الأمر الثالث الذي استرعى انتباهي هو سؤال فقيه الحي ، وهو أخ وصديق كريم أحببته لعزة نفسه واجتهاده في دينه ودنياه ، عن اسم والدة أبي . جلس على قبره ، بعد أن تفرق الناس ، يثبته ويدعو الله له .
أذكره ، يرحمه الله ، حين أتذكره ، وأنا أقص القصص والحكايات ،التي سمعتها منه ، والطرائف والمواقف لأبنائي وبعض الأصدقاء . إنه لأصعب موقف على قلمي ، أمسك الدموع أقاوم رغبتها السيلان . إنا لله وإنا إليه راجعون .
يتبع