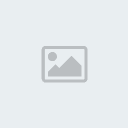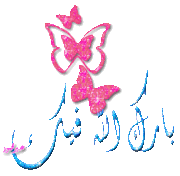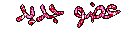- السياقان: اللغوي وغير اللغوي: هذا، ويقسم السياق إلى نوعين آخرين: لغوي وغير لغوي:
أما السياق اللغوي (أو الكلامي) فهو النص/الخطاب ذاته بمستوياته اللغوية المعهودة: النحوية والمعجمية والدلالية، وهو سياق داخلي “منبثق”، لا يخرج عن حدود العبارة اللغوية بكينونتها النصية، وهذا النوع يتضمن من القرائن النصية (اللفظية والمعنوية) ما يرشد إلى مراد المتكلم من الخطاب، ولا يكون في سلّمه الإجرائي أيُّ مكوّن خارجي للمعنى والتأويل.
أما السياق غير اللغوي فيراد به ظروف الخطاب وملابساته الخارجية والتي تشتمل على الطبقات المقامية المختلفة المتباينة التي ينجز ضمنها الخطاب، والتي سماها علماؤنا: سياق الحال، أو المقام، وقالوا: [لكل مقام مقال](17)، ويشمل ذلك الزمان والمكان وحال الأشخاص: المتكلمين والمخاطبين… وهذا النوع يشتمل على القرائن الحالية التي تسهم في الكشف عن المراد، ومنها ما سماه المفسرون: أسباب النزول، ويندرج ضمنها بالطبع “مراعاة حال المخاطَب” و”غرض المتكلم”.
وعليه فإن “البحث النصي” و”البحث السياقي القرائني” ليسا من مبتكرات عصرنا كما يروّج بعض من لا يريدون الخير للثقافة العربية، وإنما هي مفاهيم واردةٌ في كتب أسلافنا من نحاة وبلاغيين وأصوليين ومفسرين… غير أن التطورات المعرفية النوعية التي شهدها عصرنا قد طبعت هذه المفاهيم بطابع علمي صارم وأطرتها ضمن أطر علمية واضحة فخطت خطوة نوعية وانتقلت من مجرد مفاهيم بسيطة إلى إجراءات منهجية دقيقة، وصار البحث فيها مقصودا لذاته، ولم تعد-كما كانت في القديم- مجرد أدوات ومداخل يُراد بها غيرها من العلوم الأخرى.
نحوعلمٍ “للنص القرآني”
من الضرورات المعرفية والدعوية الملحّة التي تقع على عاتق القادرين من المسلمين اليوم إعادة تأسيس علم جديد، أو إحيائه ولكن بأدوات معرفية جديدة(18)؛ يمكن تسميته: علم النص القرآني ويكون همه تحديد دلالات الألفاظ القرآنية وفق الخبرات والإمكانات العلمية الجديدة، وضبط المناهج التفسيرية والتأويلية، ومِن ثَمَّ وضع الحدود المفاهيمية للمصطلحات القرآنية ولمنظومة القرآن/الإسلام المعرفية، في عصر يشهد تطورات نوعية أثرت بقوة وعنف على كل المنظومات الفكرية القديمة ومنها دون شك المنظومة المعرفية الإسلامية، ومن خيارات هذا العلم النصي أن يستعين أرقى النماذج التفسيرية/ التحليلية (أو التأويلية) للقرآن ذات التأسيس العلمي الرصين والتي ساهم بها بعض التأويليين القرآنيين المعاصرين ولا يقطع صلته بها.
وهذا العلم النصي القرآني المنشود (الذي ندعو إليه ونرى حاجة الإسلام والمسلمين إليه ماسة) لا يهمل، من الناحية المبدئية، التراث الإسلامي العظيم مثل كثير من مباحث علوم القرآن، والمباحث النحوية والبلاغية والأصولية وحتى الكلامية والفلسفية… ولا يحق له أن يرفضها فينبَتَّ عن أصوله ومصادره التاريخية بل يأخذ من هذا التراث الثري الغزير ما يخدم المنظومة الإسلامية في عصرنا، ولا سيما واجهتها الدعوية التي يخاطَب بها الغربيون، على أن يسعى إلى الفصل بين محليات القرآن وعالمياته، وظنياته وقطعياته، وظرفياته وأبدياته، مع حذره الواعي من محاذير الأخذ بنظريات تأويلية عربية قديمة أثبت علم اللغة المعاصر عدم كفايتها العلمية كـ”نظرية العامل النحوية”، كما لا يُهمل ما أنتجته المعرفة اللسانية المعاصرة (وحتى غير اللسانية)، بل يأخذ بها ولكن لا يتبنى كل مفاهيمها النظرية والإجرائية، وخاصة دلالاتها الفلسفية الوضعية المادية التعسفية.
فنحن نرى أن هذا العلم النصي القرآني كفيل بتشكيل وعي إسلامي هام وصناعة ثقافة إسلامية معاصرة. وإذا نجح المسلمون المعاصرون (أو الأجيال التي تأتي بعدهم) في تأسيس وبلورة مبادئ ومفاهيم هذا العلم القديم الذي من الضروري أن يجدد… وإذا ما قُدّرَ له أن يستقل عن غيره من العلوم الإسلامية التقليدية (مع أنه يمتاح منها)، فإنني آمل أنه ستترتب على ذلك كثير من النتائج الطيبة وأذكر منها:
أ- بناء منظومة معرفية إسلامية معاصرة تؤطر حركة ونشاط المسلمين المعاصرين على اختلاف طوائفهم وإيديولوجياتهم وتعيد إحياء وعيهم الديني والمعرفي والعلمي والحضاري.
ب- التقريب بين طوائف المسلمين المختلفة عقائديا على الصعيد العلمي والنفسي، ومن ثَمَّ التشريعي والاجتماعي، وتضييق هوة الخلاف بينهم.
ت- جعل هذا العلم، في مرحلة لاحقة من مسيرة نضجه، مصدرا يمد الساحة الدعوية والمعرفية والتشريعية بمعطيات جديدة مؤسَّسة علميا ومؤصلة إسلاميا.
ث- وضع حد لكثير من المحاولات الرديئة الغثة (وهي كثيرة في أيامنا…) التي تمارس تفسير القرآن وتَدَبُّره وتحليله دون استجماع أدواته الأساسية، القديمة والحديثة، وميزة هذه الأدوات أنها متجددة دائما، كما ألمحنا آنفا.
ج- تحقيق التجديد الديني والحضاري المنشود وإعادة النظر في الأحكام الشرعية الضعيفة والاجتهادات الخاطئة وتخليص الساحة الثقافية الإسلامية من الفوضى الفكرية السائدة فيها.
وعلى الجامعات التي توصف بـ”الإسلامية” في العالمين العربي والإسلامي أن تُدرج هذا العلم القديم/الجديد في برامجها وأن تحرص على الإفادة من معطياته، ولا سيما الأساتذة والطلبة المختصين في علوم القرآن والتفسير والدعوة؛ فحرامٌ ألا تستفيد أجيال المسلمين الحالية والقادمة من التطورات النوعية المعرفية الهائلة التي يشهدها عصرنا وألا توظفها في خدمة الدعوة بما يظهر إنسانية الإسلام وعالمية القرآن وخلوده وثراءه… فالناس الذين ينبغي أن نخاطبهم نحن المسلمين من الآن فصاعدا إنما نخاطبهم بالقرآن الذي يقنعهم ويبهرهم ويستوعب ما لديهم استيعابا يتجاوز موروثاتهم الروحية ويصحح ما فيها(19) ويقوّض بُناهم الدينية المحرَّفة ومنظوماتهم المهترئة، وليس لنا أن نقص عليهم قصص منامات السلف والخلف… بل لا تعيرنا البشرية أسماعها (ونخاف ألا تلتفت إلينا أجيالنا القادمة أيضا!) إذا ما حدّثناها أن أبا حامد الغزالي رُئي في المنام فقيل له: بم غفر لك ربُّك؟ أَبِكُتبك التي ألفتها؟ أم بتلاميذك الذين علّمتهم فصاروا علماء ينيرون ظلام الجهل وينيرون درب الأمة؟ أم بعفَّتك وتقواك؟ فقال: لا هذا ولا ذاك ولا تلك… ولكن غفر لي بأني كنت مرة رحيما بذبابة فتركتها تشرب- وكنت منهمكا في تأليف كتاب ! – من مداد القلم الذي كنت أكتب به ولم أزعجها حتى شبعت، فدخلت بذلك الجنة !!!
لم يعد في عالم اليوم من يستمع إلى قصص مناماتنا ولا حتى في أجيالنا القادمة، ولذلك نكرر أن الخطاب الذي يشد أبناء المسلمين وغير المسلمين إليه هو ما يلبي حاجة في نفوسهم ويملأ فراغا وجوديا وروحيا ومعرفيا حقيقيا عندهم، ويستجيب لتحديات ومقتضيات الوعي الكوني الراهن.
وهذا العلم المأمول تأسيسه أو تجديده، أيا ما كان ذلك، والذي لا يهمل أدوات الفهم وآلياته الاستكشافية وقواعده المنهجية التي أنجزها العقل البشري في عصوره المختلفة- كما قلنا- لا يجوز له، بل ليس من حقه، أن ينسى أن بعض تلك الخصائص والأدوات والقواعد المنهجية هي من وحي وتوجيه آيات الذكر الحكيم، فقد يكون من هذه الآليات والقواعد المنهجية ما هو توجيهٌ إلهيٌّ خالص في القرآن الكريم ذاته، فليس لدارس القرآن إلا أن يتقيد بها ويقف عندها ويسلّم أمره إليها، والتسليم للنصوص الإلهية القرآنية علمٌ وعِزّ…. وهذه خاصية هامة من خصائص القرآن الكريم، فهو “يحدثنا عن نفسه”، أي عن “بعض خصائصه وأدواته المنهجية والمعرفية-الإيبستيمولوجية”، ونذكر أهمها باختصار ودون شرح عسى أن تسنح فرصة أخرى للعودة إليها:
* كونه من عند الله تبارك وتعالى، وهذا يعني أنه ?لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنـزيل من حكيم حميد? (فُصِّلت- 42) وأن من صفاته أن ?تمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته? (الأنعام- 115)، وكيف يأذن الله أن تبدّل كلماته والحكمة الإلهية الربانية مودَعة في هذه الكلمات !؟ ومن ثَم تحققت لهذا الكتاب مميزات وخصائص لم تتوفر لكتاب قبله ولا بعده، ومنها هذه الخصائص: “المطلَقِيّة” و”الكونية” و”الإنسانية” و”الإعجاز” بوجوهه المختلفة، ولعل أهمها – في هذا العصر – الوجه “المعرفي الكوني الإنساني العميق” للإعجاز، بما أنه يحملهدايات الله الخاتمة للبشرية كافة.
* دعوة القرآن المتكررة إلى تدبر آياته، فالتدبر هو المفتاح الناجع الذي به تفتتح مغاليق الكتاب العزيز، وهو واجب على كل من يمتلك أدوات التدبر العلمية وشروطه، إضافة إلى من عنده الاستعداد الروحي/النفسي لمعانقة الآفاق النورانية القرآنية، قال عزّ من قائل: ?أفلا يتدبّرون القرآن? (النساء- 82) ?أفلم يدّبّروا القول? (المؤمنون- 68)…
* توجيه القرآن ذاته إلى أنه يؤخذ في كليته وأن من الخطأ العلمي والديني تجزئته لأن ذلك يحول دون فهمه ودون الإيمان به، وقد يكون ذلك التجْزِيءُ إخفاءً لما أنزل الله: ?كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عِضِين? (الحجر- 91)، وتعضين القرآن: تجزيئه وتقطيعه أجزاء ثم الإيمان ببعضه دون بعض. وهذا المعنى قريب من قوله تعالى: ?قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا? (الأنعام-91)، إلا أن الآية الثانية مقصودٌ به التوراة، والأولى القرآن.
* خلوه من الاختلاف والتناقض ?ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا? (النساء- 82) مما يدل على انسجامه المعرفي (الاصطلاحي والمفهومي) من أول كلمة فيه إلى آخر كلمة، سواء من جهة ترتيب النزول أو من جهة ترتيب المصحف. وهذه الميزة ناجمة عما قبلها؛ أي أن الذي يأخذ هذا الكتاب العظيم في كليته هو الذي يصل إلى خاصية الانسجام الكلي والتناغم التام الذي يطبعه. …الخ (يتبع)
الهوامش
* أستاذ جـامعي ،وكاتب . [2]له عدد من المؤلفات المنشورة .
(1) انظر: روبار دو بوغراند و وولفغانغ دراسلر، النص والخطاب والإجراء، تر: تمام حسان، ص 36. وانظر أيضا: وولفغانغ هاينه من وديتر فيهفايغر، مدخل إلى علم اللغة النصي، تر: فالح بن شبيب العجمي، نشر جامعة الملك سعود، الرياض- المملكة العربية السعودية، 1996، ص 123.
(2) سعيد حسن بحيري، علم لغة النص/المفاهيم والاتجاهات، الشركة المصرية العامة للنشر، القاهرة، 1997، ص 109.
(3) محمد بن إدريس الشافعي، الرسالة، تح: أحمد محمد شاكر، المكتبة العلمية، ص 14.
(4) انظر: – ابن حزم الظاهري، الإحكام في أصول الأحكام، مج 1، ج 3، ص 391. وأبو حامد الغزالي، المستصفى من علم الأصول، دار الفكر، ج1، ص 14.
(5) عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، تح: ياسين الأيوبي، المكتبة العصرية، صيدا، 2000، ص 388.
(6) لمن أراد التفصيل يمكن الرجوع إلى: مسعود صحراوي، الأفعال الكلامية عند الأصوليين/ دراسة في ضوء اللسانيات التداولية، بحث ألقي في ملتقى “علم النص والتداولية” المنعقد بتاريخ: 9-10- 11/ ديسمبر 2003، بجامعة الجزائر/ قسم اللغة العربية وآدابها.
(7) انظر: مسعود صحراوي، المنحى الوظيفي في التراث اللغوي العربي (مقالة)، نشرت في: مجلة الدراسات اللغوية، إصدار: مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات والإسلامية، الرياض، المملكة العربية السعودية، المجلد الخامس/ العدد الأول، 2003، ص 11/44.
(8) بدر الدين الزركشي، البرهان في علوم القرآن، دار الجيل بيروت، ج2، ص 175.
(9) أحمد مختار عمر، علم الدلالة، مكتبة دار العروبة للنشر والتوزيع، 1982، ص 68.
(10) نفس المرجع، ص 68.
(11) ابن قيم الجوزية، بدائع الفوائد، دار الكتب العربية، بيروت، ج 4، ص 9-10. ويبدو أنه نقله عن أستاذه ابن تيمية، انظر: أحمد ابن تيمية، أصول التفسير، ص 93.
(12) انظر: عبد الجبار توامي، نقد ترجمات القرآن في ضوء المنهج السياقي (مقالة)، نشرت في: مجلة الدراسات اللغوية، إصدار: مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات والإسلامية، المجلد الخامس/ العدد الأول، 2003، ص 257/297.
(13) انظر: – محمد الطاهر ابن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر، تونس، 1984، ج 1، ص 81.
(14) انظر: جلال الدين السسيوطي، الإتقان في علوم القرآن، مكتبة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، ط4، ج2، ص225.
(15) يوسف القرضاوي، كيف نتعامل مع القرآن العظيم؟، دار الشروق، القاهرة، 2000، ص 217.
(16) انظر مثلا تفسيره لقوله تعالى: ?إن هو إلا وحيٌ يُوحى? (النجم – 4).
(17) انظر: مسعود صحراوي، المنحى الوظيفي في التراث اللغوي العربي، ص 5/42.
(18) من الذين دعوا إلى إعادة إحياء وتجديد مناهج التفسير بما يتلاءم مع معطيات العصر المعرفية الفيلسوف المرحوم مالك بن نبي في كتابه القيِّم: الظاهرة القرآنية، دار الفكر،1981، الصفحات من 57 إلى 67.
(19) أبو القاسم الحاج حمد، العالمية الإسلامية الثانية، دار المسيرة، بيروت، 1995، ج 1، ص 135.