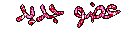ألف ليلة وليلة.. التراث وَقراءة جَديُدة - حَسن حَميد
-1-
أكادُ أجزم أن كثيراً من المؤلفات العربية ذات الصلة الشديدة بالتراث ما تزال مجهولة لأسباب متعددة ومختلفة، وأن المعروف منها لم يَنل الحظوة والاعتبار الجديرين بها أيضاً. واننا، كمتلقين، نظلُّ- للأسف الشديد- ننتظر واحداً من المستشرفين أياً كان شأنه أو الجهة التي وجهته، أو المكان الذي قدم منه، ولأي الغايات والرؤى يعمل ويجتهد؛ أقول نظلُّ ننتظر هذا المستشرق ليكشف لنا أسرار كتاب من كتب من تراثنا المجهولة، أو ليقوّم كتاباً من كتب تراثنا المعروفة لدينا عنواناً لا محتوى، بعدما أكلها الغبار، وطواها النسيان، فنمضي وراءه مرددين قولاته وأفكاره، ومؤيدين لأحكامه، ومصفقين للميزان الذي زان به كتابنا.
والغريب العجيب أن عمر هذا الانتظار للسادة المستشرفين ما زال مستمراً وقائماً وحاضراً منذ قرون عدة وحتى يومنا الراهن وإلى ما يشاء الله من أيام قابلة دون أن يكوّن لدينا احترام لمواهبنا الجديدة، أو ثقةٌ تؤهلنا وتقودنا إلى معرفة التراث معرفة عميقة بعيدة عن الهوى والمذهبيات المسبقة.
والأكثر غرابة وعجباً أننا، وفي أغلب الأحيان، نستعيد تراثنا على تعدد ألوانه واختلاف أنماطه، وبعده العميق في الأزمان، وقدرَ كتابنا وأعلامنا من عند الغرب تحديداً، ووفقاً لما يقوله مستشرقوهم، لما يروجونه في وسائل الاعلام والاتصال معاً.
والمدهش أن مفهوم العودة إلى تراثنا يظل مفهوماً اشكالياً ومربكاً، وذلك ليس من ناحية أحقية هذه العودة وضرورتها، ولا من ناحية تجاهل هذه العودة والعزوف عنها لان لا طائل من ورائها، وليس أيضاً من باب (انظرْ إلى الوراء بغضب)، كما أنه ليس بسبب محبة التراث والدعوة إلى ملازمته إلى حد التماهي معه تحت عنوان (لا جديد لمن لا قديم له)، وإنما لأن هذه العودة لا تأتي بوعي نابع من ذواتنا، ولا بدوافع من حاجاتنا إليها، وإنما تأتي هذه العودة بإشارة من رجال الغرب وحسب أهوائهم ورغائبهم وتحقيقاً لها؛ والمؤسف أننا نكتفي ونقتنع بما يقوله المستشرفون ولا نضيف إليه جديداً، وكأن ما توصل إليه المستشرفون هو آخر الكشوفات التي لا زيادة عليها لأي مستزيد، وإلا فبماذا نفسر اكتفاءنا بأخبار الحلاج ومؤلفاته وقولاته التي جاء بها ماسينيون منذ أن كشف عن قصته وعصره في أوائل قرننا العشرين الراهن، وبماذا نفسر تصديقنا لأكثر الروايات والأخبار التي ساقها المستشرفون حول مقتل المتنبي مثلاً، أو حول الحاكم بأمر الله، أو حول قراقوش، وقارون، وغيرهم؟!
إن مفهوم العودة إلى التراث مفهوم كوني؛ فما من أمة من أمم الأرض قاطبة إلاّ ولها عودتها إلى تراثها تنظر فيه لتجلو معانيه، وتأخذ منه لتعزيز الجوانب الاعتبارية والمادية للشخصية، ولتوكيد التطور والحضور في الراهن والآتي في وقت واحد. والاشكالي في عودتنا العربية إلى تراثنا نابعة من أننا لا نمتلك كل تراثنا بعدما تفرّق وتوزّع على العديد من المكتبات والمتاحف العالمية في مختلف بلدان العالم، خصوصاً تلك البلدان التي استعمرت أوطاننا لسنوات طويلة، وقد نهبت الكثير من تراثنا واحتجزته عندها في الأدراج والبنوك والمتاحف، والخزائن، ذلك التراث الذين لم يفصح بعد عن مكنوناته، وكمياته، وأهميته. فثمة خرائط قديمة وضعها علماء الجغرافية العرب، وثمة مخطوطات في الأدب، والفلسفة، وعلم الكلام، ومدونات كيماوية طبية موصوفة ومحررة، وقطع أثرية كشّافة لتواريخ وأعلام ورسائل، ومعاملات، وتواصل، وحضارة، وهناك طرائق فلكية وحسابية كان لها شأنها وأسبقيتها في الإبداع والريادة؛ كل ذلك ما زال طيّ الغيب والجهل لبعد اليد العربية عنه، وقد لا نعرف عنه شيئاً ما لم يكشفه المستشرفون لنا. والارتباك في أمر معالجة تراثنا نابع من عدم اهتمامنا به الاهتمام اللائق والمحرض على الغوص والتبحر فيه وقناعتنا تكاد تكون راسخة بأن قراءتنا لتراثنا انتهت إلى حيث انتهى المستشرفون، وهذه- لعمري- فاجعة تضاف إلى فواجعنا الكثيرة الولود!
-2-
والمؤسي، والباعث على الألم، ونحن نرى إلى تراثنا الذي صار ممتلكاً لغيرنا، أننا بتنا نؤمن مطلقاً بالتحييد. كأن نقول بأن هذه المؤلفات أو الكتب لجماعة السنة، وتلك لجماعة الشيعة، وأن هذا الكتاب مذهبي باطني للفرقة الفلانية، وأن الهوى والعدوانية والأحقاد تلّف مؤلفات فلان من الاعلام، أو أن نقول بأن هذا التاريخ أو التأريخ عند فلان هو غرضي أو رسمي حابى ولوّن على هواه، وهكذا إلى آخر التوصيفات وإلى أن نصل إلى التحييد والإبعاد، وعدم القراءة الجديدة، أو الاستكشافية الراهنة البعيدة عن السلط، والعسس، والمؤثرات الواقعية التي كانت سائدة في أزمان تلك المؤلفات.
أقول هذا، وأنا لا أنكر أن التحييد والعزل خاصية علمية لا بد من اللجوء إليها، والأخذ بها كي لا يظلَّ التراث ركاماً أو بيدراً فيه القمح والزؤان، أو منجماً فيها الخسيس والنفيس معاً. لكنني ضد التحييد والعزل والابعاد في القراءة والاستكشاف والمطالعات ذات الهوى، والمذهبيات المسبقة أو التحييد بسبب الاطمئنان إلى الأقوال والآراء السابقة دون الوقوف على فجواها واستبطاناتها وغاياتها بمناهج وأدوات ورؤى جديدة طازجة.
إن مستشرفي الغرب، وليومنا الراهن، لم يقولوا بعد كلمتهم في سيرة (ذات الهمة) المؤلفة الصفحات، والهائلة في مادتها، وأخبارها، وحوادثها، وتواريخها، ونوادرها، وأوصافها، وأعلامها، وغرائبها، ومطابقاتها لما سبقها من الحادثات والوقائع، والمفارقة لها، والجديد الذي تختزنه. ولذلك، ولهذا السبب عيناً، لم تأخذ سيرة ذات الهمة حقها، وحظوتها في حواراتنا، وكتاباتنا، وأذهاننا، وأفئدة أولادنا الوردية، وإنني على يقين تام بأن نسبة عالية جداً من مثقفينا أصحاب التحصيل العالي لا علم لهم بسيرة ذات الهمة، ولا بعصرها،ولا بمكانتها، ولا بمواقع أحداثها، ولا بتواريخها، فكيف لهم أن يقعوا على غاياتها. وعندي أن الكارثة أعم وأشمل وأكثر مأساوية في انغلاقها حين يقف مثقفونا ساخرين بأن أغلب حروب العرب، ومعاركهم، وغزواتهم كانت لأسباب تتعلق بالحيوانات، كحرب داحس والغبراء، أو حرب البسوس، أو غزوات البحث عن المراعي الجديدة للدواب.. الخ. إن هذه السخرية المرة الهادفة إلى الطعن بتاريخ العرب، والمؤكدة على تسطيح عقولهم، ومرئياتهم، وعدم علاقتهم بأي معنى من معاني العمق والتحليل إنما هي كارثة قومية.
والسبب في ذلك أننا صدقنا الخبريات الصغيرة التي مرت في تضاعيف بعض الكتب العربية المؤرخة، وبعض قولات المستشرقين دون أن نعمل عقولنا كما يجب، أو كما يقتضيه الواجب، ومحبة الوطن، ودون أن نسعى إلى كتابة تاريخ عربي حقيقي خلو من الأحقاد والضغائن، والمذهبيات المرعبة، والاطمئنان الهش والبارد لكل ما قال به الأجانب في حق تراثنا. والحق إن نفراًً من المستشرقين كانوا على قدر واف من الموضوعية وهم يعالجون ويبحثون في تراثنا، ولكن هؤلاء قلة، والطائفة الكبرى منهم كانت غرضية في أهوائها، حاقدة في تطلعاتها، كريهة في أنفاسها، موتورة في آرائها، وموقنة بأن العرب لا قدرة لهم على إبداع شيء، نعم يستطيعون التعامل مع إبداع الغير ولكنهم ليسوا مبدعين، ومن أسف أن كثيرين منا صدقوا ذلك، واقتنعوا به ضاربين بأعلام العرب وتاريخهم، وابداعاتهم، وصولاتهم، واجتهاداتهم عرض الحائط.
إنها كارثة حقاً!
ولكن في المقابل، ألا نقول بأننا مقصرون جداً في مطالعة تراثنا، وأننا- على الرغم من الدعوات العديدة، والصيحات العالية والكثيرة جداً للعودة إلى التراث- لم نقف بعد على الكثير الهام من تراثنا. وإننا اقتنعنا اقتناعاً مطلقاً بأن عنترة عبد أسود، كانت له قوته الجبارة، ومن هنا جاءت اسطورته. ترى ماذا لو قلنا إنّ عنترة هذا لم يكن عبداً، ولا أسود الجلد، وإنما كان ملكاً من ملوك العرب المشاهير، وأملاكه كانت كذا وكذا، ودياره كانت في المكان الفلاني، وأن لا وجود لمخلوقة اسمها عبلة، ولا لكائن اسمه شيبوب وأن اسطورة عنترة آتية من عدله ومهابته أو أنها آتية من سطوته وجبروته وطغيانه على الحق؟! أسئلة مفزعة لا بدّ منها لنصل إلى الحقائق بأيدينا، وبروح بعيدة عن الأغراض الدنيوية والدونية معاً.
إن هذه العودة إلى تراثنا، وبهذه الروح الخلاّقة المبدعة لا تعني الهدم، أو النبذ، أو تصفية الحسابات، وإنما تعني إظهار الحقيقة وجلوها بعيداً عن الأقوال المحفوظة، والأخبار الباردة، والتواريخ الرسمية التي خضعت للرقابات الشديدة في أزمان مختلفة لتوافق رؤى وغايات أولي الأمر سواء أكانوا صالحين نافعين للناس والمجتمع أم طغاة سفلة، كانت الحياة تعني لهم الثراء، والابهار، واللذة حتى ولو أحاطت بهم بحيرات الدم البشري ليل نهار!.
وكي لا نظل في أبهاء التعميم أقول من منا يعرف أين دارت معارك تغلب وبكر، وأين كانت معسكرات المهلهل الزير سالم، وما قابلها من معسكرات جساس. وهل ذلك اسطورة أو حقيقة؟ وما السبيل إلى معرفة اليقين؟!
ومن منا يعرف أين هي مواقع النعمان، وما صلته الحقيقية بملوك الأعاجم وأمرائهم؟! وما الأسباب الدافعة للتغريبة الهلالية؟! أكانت خلاصاً من شر واقع، أم أنها كانت جولان بحث عن الماء والكلأ، أم أنها كانت بحثاً عن طمأنينة بعيداً عن الأحقاد والحروب الصغيرة والكبيرة؟!
أسئلة ليست من أجل الشك في الترث، أو نقضه، وإنما هي من أجل صياغة التراث صياغة أمينة للأصيل فيه، والدافع لنا لمواصلة العطاء دونما دونية، أو مخاوف، أو انبهار بحضارة الغرب الراهنة، ودونما ترديد أجوف بأن حضارة الغرب هذه قامت على حضارتنا البائدة.
لا شك في أن الغرب ظلمنا، مع جملة من الشعوب الإنسانية الأخرى كأفريقيا وأهلها، وآسيا وأناسها، وأمريكا اللاتينية وحضارتها؛ الظلم دائماً، وفي التاريخ البشري كان واقعاً، وكان المطلوب على الدوام أيضاً رفعه أو التقليل من شراسته. بل إن الغرب ظلم الكثيرين من أهله في فترات عديدة من حياة البشر وتاريخهم، وهل ننسى حروب ألمانيا، وبريطانيا، واسبانيا، وأمريكا، قديماً وراهناً، وربما مستقبلاً. وأياً كان شأن الأمر، فإن الظلم الذي وقع علينا نحن العرب كان كبيراً وفادحاً ومستقبلياً بمعنى أنه سيستمر في آثاره إلى أجيال قادمة وأزمان قابلة، فالغرب لم يسهم في تكريس الأمية تكريساً أزلياً فقط، وهو لم يربط اقتصادنا باقتصاده وحسب، كما أنه لم يسرق تاريخنا وتراثنا بعدما سرق جغرافيتنا سنوات طويلة فقط، وانما زرع جملة من الجراثيم الفكرية، والقولات الحامضية، وأسسَّ سلوكات وقناعات غاياتها ليست لنا، وكل هذا قد يحتاج إلى عشرات السنوات لمحوه من الأذهان أولاً والبناء عليه ثانياً.
لكن السؤال الجوهري والحارق. هل بدأنا فعلاً في مكاشفة تراثنا، هل اقتنعنا حقاً بأن الغرب ما زال لليوم يسرق الحضارة العربية والاسلامية.
ألم يكشف بعد أبناؤنا الذاهبون إلى أستاذ اللسانيات الأمريكي اليهودي (نعوم تشومسكي) بأن نظرياته في توليد اللغة، وعيوب اللغة، وطرائق اكتساب اللغة هي قولات ونظريات عالمنا الكبير الجاحظ؟! ترى أما زالت كتبنا في التربية تصرّ على أن تشومسكي هوسيد اللسانيات في العالم وأستاذها؟!
بلى، وما زال أبناؤها في بعض البلاد العربية يذهبون للتخصص في اللسانيات بأمريكا وعلى يد (تشومسكي) ليأخذوا منه معلومات هي لجدنا الجاحظ، وقد سبق (تشومسكي) وأضرابه بسنوات عديدة. ترى لماذا لا نعيد الأمور إلى نصابها، لماذا لا تقودنا ثقتنا بأنفسنا لنكاشف هؤلاء بالحقائق التاريخية الموجودة في خزائنهم هم بعدما سرقوها أيام الانتدابات العجيبة، أو بعدما أخذوها بالمال حيناً، وبالاحتيال حيناً آخر، وباسم البحث والاطلاع حيناً آخر؟!
لماذا لا يقول نقّادنا الذين يذهبون إلى فرنسا وأمريكا بأن ما يقول به (تودورف)، و(رولان بارت) من أفكار وقولات نقدية كشفية لماهية النص هي قولات وأفكار الجرجاني، وابن جني، والقرطاجني، وجعفر بن قدامة وغيرهم من علماء اللغة والأدب العرب الذين سبقوهم بسنوات كثيرة؟!
ولماذا لا نجاهر بالقول بأن العديد من أجناس الأدب كالرواية والقصة والمسرحية هي أجناس عربية، ولم تكن مستورة من الغرب بعدما شيَّع أعلامنا ذلك، وبعدما نفضوا أيديهم وأقرّوا بالقول بأن العرب لم يعرفوا لا القصة ولا الرواية ولا المسرحية.
وإلا فماذا نسمي ألف ليلة وليلة، وحواريات الشطار، وأخبار الحوادث، وقصص العشاق، وقصص الجن!! ترى ألا تكون القصة قصة إلا بالمقاييس والمعايير الغربية؟! ليعرف من يؤكدون هذه الآراء، أن أدباء الغرب يتعلمون الأساليب، والجدة، والغرائبية من قصصنا، ورواياتنا، وحوارياتنا، وهم أنفسهم لا ينكرون هذا، فهل نعتبر؟!