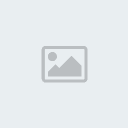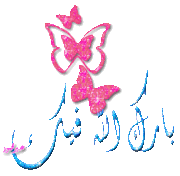أهمية الحديث النبوي في الدراسات اللغوية والنحوية
د. ياسر درويش
(من موقع الألوكة الثقافية)
إنَّ من المعروف لدى المهتمِّين بعلوم العربيَّة وعلوم الدين: أنَّ القرآن وعلومه أسبقُها إلى التَّدوين، ثم لما دُوِّن القرآن وحُفظ من الضياع، بوشر بالاهتمام بِحفظ الحديث وتدوينِه؛ خوفًا عليه من الضَّياع، وهذا ليس هدمًا لما سنستنتجُه في الفصْل الأوَّل ، من أنَّ الحديث كان يدوَّن منذُ زمن النبي - صلى الله عليه وسلَّم - ولكنَّنا نقصد هنا التَّدوين الرسْمي الجماعي الذي كان على رأْس المائة الأولى للهجرة.
وبعد أن دوِّن الحديث وحُفظ، عكَف العلماء على دراسة هذيْن المصدرين المهمَّين من مصادر التَّشريع؛ لأنَّ كلاًّ منهما مكمِّل للآخر، فالقرآن هو كلام الله المتعبَّدُ بتلاوته، الذي أُنزلت فيه قوانين الحياة وأحكام شريعتها، والحديث الشريف هو كلام النبي الذي أُنزل عليه القُرآن، فكان جلُّ كلامه، بل كل حياته، خدمة وتفسيرًا لمراد الله في كتابه، وهو القائل - عزَّ وجلَّ -: {وأنزَلنا إلَيكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ للنَّاسِ} [النحل: 44].
إذاً؛ فمهمَّة الحديث النبوي أوَّلاً وأخيرًا هي شرح كلام الله وتِبيان معانيه، بالإضافة إلى أنَّه المصدر الثاني للتشريع بعد القرآن الكريم، فلا يمكن أن يتضمَّن القرآن آياتٍ تشرح كيفيَّة الوضوء والصلاة، وأحكام الحجِّ والزكاة، واختلاف الظروف والمناسبات، ومن هنا اكتسب الحديث صفةً قدسيَّة؛ نظرًا للمهمَّة التشريعية التي يقوم بها، ومن هنا أيضًا جاء الاهتِمام بتدوينه بعد تدوين القرآن الكريم مباشرة، ذلك أنَّ الصَّحابة الذين عاشوا مع النَّبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - وسمِعوا أحاديثه وعرفوا قيمَتَها، عندما كانوا يحتجُّون بها في أحكام دينهم، تبيَّنت لهم أهميَّتها وأهميَّة تدوينها.
فإذا ما عرفنا هذه الأهميَّة للحديث النبوي وعلومِه تأكَّدت لدينا حقيقةٌ أكيدة لا مِرية فيها، وهي أنَّ الحديث كانت له سمة واضحة، وأثر بيِّن في مختلف علوم الإسلام، سواء منها علوم الدين وعلوم العربيَّة وغيرها.
ذلك أنَّ القارئ لنصوص الحديثِ الشريف يستطيعُ أن يضع يدَه على نصوصٍ نبويَّة كثيرة، فيها الحضُّ على العلم وطلبِه؛ فقد قال معلِّمُ الناسِ الخيرَ - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((طَلَبُ العِلمِ فَرِيضةٌ على كُلِّ مُسلِمٍ ))[1]، وقال: ((إنَّ العُلَماءَ هُم وَرَثةُ الأنبِياءِ))[2]، وقال: ((لا حَسَدَ إلاَّ في اثنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مالاً فَسُلِّطَ على هَلكَتِه في الحَقِّ، ورَجُلٌ آتاهُ اللهُ الحِكْمَةَ، فهُوَ يَقْضِي بِها ويُعَلِّمُها))[3]، إلى غير ذلك من الأحاديث النبويَّة الشريفة التي تشير إلى فضْل العلم والحث على طلبه.
وإنَّنا لنعلم أنَّ أوَّل ما بدأ به علمُ الحديث هو الرِّحلة في طلبِه[4]، وهي التي شقَّت الطريق أمام العلماء، وفتحت لهم آفاقًا رحيبة؛ إذ إنَّ علماء الحديث كانوا يرحلون في طلَب الحديث الواحد المسافات الشَّاسعة؛ بل ربَّما قطع الواحد منهم فيافيَ الجزيرة العربيَّة من أجل كلِمة واحدة، أو رواية أخرى لحديث يعرفونه ويَحفظونه، حتَّى قال الشعبي: "لو أنَّ رجلاً سافر من أقصى الشَّام إلى أقصى اليمن ليسمعَ حكمة، ما رأيت أنَّ سفره ضاع"[url=http://www.ta5atub.com/#حاشية 5][5][/url].
وقد أشاعت هذه الظاهرة - وأعني: ظاهرة الرحلة في طلب الحديث - جوًّا من الرغبة في التَّحصيل والتَّعلُّم والتَّدقيق في العلوم وتتبُّعها، حتَّى غدت الأساسَ الذي قامتْ عليه العلوم الأخرى، على نَحو ما نعلم عند عُلماء العربيَّة ورحلاتِهم إلى بَوادي الحجاز ونَجد، وقبائل وسط الجزيرة العربيَّة، وكان الأساسُ الذي انطلقت عليه رحلة علماء العربيَّة هو الأساسَ الذي خطَّه من قبلُ علماء الحديث، وأخذه عنهم كلُّ من قلَّدهم في تدوين العلوم المختلفة وتقعيدها.
وقد كان أوَّل العلوم تأثُّرًا بعلم الحديث هو علْمَ التَّفسير وعلوم القرآن؛ ذلك أنَّ وفاة النبيِّ الذي كان يفسِّر للصَّحابة معانيَ القرآن ويفصِّل لهم أحكامه - ألجأهم إلى أحاديثِه وسنَّتِه؛ إذ إنَّه أعلم النَّاس بكتابٍ أُنزل عليه، فراحوا يفسِّرون الكتاب بالسنَّة، وهو ما يسمَّى التَّفسير بالإسناد، الذي كان الإمام مالك بن أنس أوَّلَ من صنَّف فيه، وقد ظل علمُ التفسير، حتى بعد أن استقلَّ واكتمل علمًا قائمًا بذاته، "شديدَ الارتباط بحديث الرسول، ولو في جانب منه على الأقل، وهو جانب التفسير بالمأثور"[6].
وحتى تتبين شدَّة الارتباط بين هذين العِلْمين نقول: إنَّه قد ظهر من بين المحدِّثين كثير من القرَّاء، كما كان منهم - على ما سنرى - كثيرٌ من علماء العربية، نحوِها وصرفِها ولغتها، وقد ذكر ابن قتيبة في كتابه "المعارف" عددًا من هؤلاء القرَّاء المحدِّثين، أمثال الأعمش (ت148 هـ)، وحُمَيد الأعرج (ت130 هـ) وسواهما[7]، وهكذا فقد نشأ علم التَّفسير في ظلِّ الحديث النبوي وبعيْن رعايتِه، وعلى هديٍ من قوانينِه وأُسُسِه التي كان لها الأثر الملحوظ في علوم الدين والعربيَّة.
وقد كان الفقه من العلوم التي تأثَّرت بالحديث، وهو ما دعا بعضَ العلماء إلى أن يدعوهما علمًا واحدًا باسم "علم الفقه والحديث"، ثم استقلَّ علم الفقه عن علم الحديث، ولكنَّه ظلَّ متأثرًا به؛ لأنَّ الكثير من هؤلاء الفقهاء كانوا في الأصل مُحَدِّثين، ومن ثَمَّ فقد طُبقت أسُس علم الحديث وقوانينه وقواعده في علم الفقْه، حتى صحَّ القول: "لولا الحديث لما كان الفقه علمًا مذكورًا"[8].
أمَّا أثر الحديث في علوم العربية، فهو أيضًا من الحقائق التي لا يتطرَّق إليها أدنى شك، ذلك أنَّ الناس لما ابتعدوا عن العصر الذي نزل فيه القرآن وقيل فيه الحديث، كانت الحاجة تبدو مُلِحَّة لشرح كلٍّ منهما، ومن هنا بدأ العمل في ميدان العربية ومعاجمها، ونحن نقرأُ في مقدمات معاجم العربيَّة الكبرى فنرى كلامًا لمؤلِّفيها لا نشتمُّ منه إلا رائحةَ الغَيْرة على القُرآن الكريم، ورغبة في حِفْظِه وتفسير معانيه وتبْيين دقائقه، استمِعْ إلى ابن منظور، صاحب المعجم الذي هو من أكبر معاجم العربيَّة، وهو يقول: "فإنَّني لم أقصد سوى حِفظِ أُصولِ هذه اللغةِ النبويةِ وضبطِ فضلها، إذ عليها مَدارُ أحكامِ الكتابِ العزيز والسُّنَّة النبويَّة؛ وذلك لِما رأيتُهُ قد غلب في هذا الأوان من اختلاف الألسنة والألوان، حتَّى لقد أصبح اللَّحنُ في الكلام يُعَدُّ لحنًا مردودًا، وصار النطقُ بالعربيةِ من المَعايِبِ معدودًا"[9].
وإذا ما طالعنا كتُبَهم ومعاجمهم هالَنا ذلك الكم الهائل من الآيات القرآنية التي دارت عليْها مواد معاجمهم، وهذا لا يدلُّ إلا على شيء واحد، وهو رغبة صادقة في الحفاظ على لغة القرآن والسنَّة.
وللحق نقول: إنَّ الجهابذة من علماء الحديث كان لهم الفضل على علماء العربيَّة ومختلف العلوم الأخرى؛ إذ عنهم أُخذت القواعد والأسس التي يُنطَلَق منها في تدوين كل علم، وإن نظرة متفحصة إلى علوم العربية ونشأتها تبيِّن مدى الارتِباط بين الحديث النبوي كعِلْم، وبين مختلف علوم العربيَّة؛ إذ كان "العصر الذي نشِطت فيه الحركة النحويَّة، ودُوِّنت فيه كتب النحو كان متأثرًا بما نشط فيه من علوم الدين من حديثٍ وفقه، وعلوم العقل من جدل وكلام"[10].
كما كان للحديث والفقه والأصول أكبر الأثر في علْم النحو ونشوئه، فقد كان بيْنهما "من المناسبة ما لا يخفى؛ لأنَّ النحو معقول من منقول، كما أنَّ الفقه معقول من منقول، ويعلم حقيقةَ هذا أربابُ المعرفة بهما"[11]، وإنَّ نظرة متفحِّصة لكتُب النحو قادرةٌ على اكتِشاف العلائق الوثيقة بينهما، بل إنَّنا نستطيع أن نستشعر ذلك من عناوين كتُبِهم في النحو، كـ"الأشباه والنظائر"، و"الاقتراح" للسيوطي، و"المفصَّل" للزمخشري، و"البحر المحيط" لأبي حيان الأندلسي، وغير ذلك، ونحن نعلم أنَّ سيبويه - أبا النحو العربي - كان مبدأ أمرِه في حلقات الحديث، وكان هذا شأنَ معظم علماء النحو والعربية.
وقد أبدى علماء النحو إعجابَهم بقواعد المحدِّثين والأصوليين، وأسسهم التي أقاموا عليْها علمهم، فقد نظر الخليل في فقْه أبي حنيفة (ت150 هـ)، فقيل له: كيف تراه؟ قال: "أرى جِدًّا وطريق جد، ونحن في هزْل وطريق هزل"[12]، وقد رُوي أنَّ الجَرْمي (ت225 هـ) ظلَّ يُفْتي الناس في الفقْه من كتاب سيبويه ثلاثين عامًا[13].
وعندما أخذت العلوم يستقلُّ بعضُها عن بعض، وتتوطَّد أركان كلِّ علم على حدة، وتتَّضح سماته - "ظلت أفكار النحاة عالقة بأساليب الفقهاء وأحكامهم، لا يذكرون القاعدة اللُّغوية أو النحوية حتى يبادروا إلى الفقه يلتمسون فيه الشَّبِيهَ والنَّظِير"[14]، وهكذا فقد قامت نظريَّات النحاة وقوانينهم في أساسها على مثال نظريات وقوانين أهل الحديث، الذين يقول عنهم ابن جني: "وهم عِيارُ هذا الشأنِ وأساسُ هذا البنيانِ"[15]، فكان النحاة يقسمون النقْل إلى تواتر وآحاد، كأصحاب الحديث.
قال ابن الأنباري: "اعلم أنَّ النقل ينقسم إلى قسمين: تواترٍ، وآحادٍ"[16]، ثمَّ يذكر تعريفَ المتواتر وشروط نقل التواتر تمامًا كما يذهب إليه أصحاب الحديث[17].
وعندما كان اللغويون يتكلَّمون على مَن تُقْبل روايتُه في اللغة ومن تُرَدّ، كانوا يتكلَّمون على طريقة أهل الحديث، قال ابن فارس: "تؤخذ اللغة من الرُّواة الثقات، ذوي الصدق والأمانة، ويُتَّقى المظْنون"[18]، وقال في موضعٍ آخَر: "يشترط في ناقل اللُّغة أن يكون عدْلاً، رجُلاً كان أو امرأة، حرًّا كان أو عبدًا، كما يشترط في نقل الحديث، وإن لم تكن الفضيلة من شكله"[19].
أمَّا طرق تحمُّل الرواية عند اللغويين، فهي نفسها عند المحدثين، ولا تختلف عنها إلا في القليل النادر، فقد كانت عند المحدِّثين على ثمانية أنواع، هي: السماع من الشيخ، والقراءة عليه، والإجازة، والمناولة، والإعلام، والوصية، والمكاتبة، والوِجادة، وهي عند اللغويِّين ستَّة أنواع، هي: السماع من لفْظ الشَّيخ، أو العربي، أو الملقن، أو الرواة، والقِراءة على الشيخ، والسماع من الشيخ بقراءة غيره، والإجازة، والكتابة، والوجدان، فزاد المحدِّثون المناولة والإعلام والوصيَّة.
وهكذا تتبيَّن لنا العلاقة القائمة بين علوم الدين عامَّة والحديث على وجه الخصوص، وبين علوم العربيَّة على اختلاف أنواعها، حتَّى صدق قولُ السيوطي: "علم الحديث واللغة أَخوان يجريان من وادٍ واحد"[20].
[1] سنن ابن ماجه، الحديث ذو الرقم 224.
[2] مسند الدارمي، الحديث ذو الرقم 342.
[3] صحيح البخاري، الحديث ذو الرقم 73.
[4] ]تعليق الألوكة]: إن كان مقصود الكاتب منها: أن علماء الحديث كانوا يبدؤون بالرحلة، فهذا غير صحيح؛ لكونهم ما كانوا يرحلون إلا بعد أن يسمعوا من علماء بلدهم أوَّلاً، وقد يكون مقصوده - وهو الظاهر - أنَّ علم الحديث هو أوَّل العلوم التي فتحت مجال الرِّحْلة في الطلب، وهذا يحتاج إلى تأصيل تاريخي، وإن كان من المعلوم من التَّاريخ بالضَّرورة أنَّ علماء الحديث هم أكثر النَّاس نشاطًا في الرحلة في طلب العلم، وهم الذين شهروها.
[5] جامع بيان العلم وفضله، ابن عبد البر 1: 114.
[6] علوم الحديث، صبحي الصالح ص 316.
[7] المعارف، ابن قتيبة ص 529-532.
[8] علوم الحديث، صبحي الصالح ص 316.
[9] مقدمة اللسان ص 13.
[10] النحو العربي، مازن المبارك ص80.
[11] نزهة الألباء، أبو البركات بن الأنباري ص76.
[12] مراتب النحويين، أبو الطيب اللغوي ص65.
[13] الكتاب 1: 5-6.
[14] النحو العربي، مازن المبارك ص 83.
[15] الخصائص، ابن جني 3: 313.
[16] الإغراب في جدل الإعراب ص 83.
[17] الدراسات اللغوية والنحوية، فاضل السامرائي ص60.
[18] الصاحبي، ابن فارس ص 62-63.
[19] البلغة في أصول اللغة، القنوجي ص 138، والمزهر للسيوطي 1: 140.
[20] المزهر 2: 312.