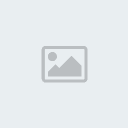ينبغي أن تعالج اللغة البشرية: "بكيفية مماثلة لتلك التي سيدرس بها عضو مثل العين أو القلب، ساعيا إلى تحديد: 1) خاصياته لدى فرد معين، 2) خصائصه العامة التي لا تتغير من نوع لآخر، بغض النظر عن كل نقص واضح، 3) موقعه ضمن نسق بنيات من هذا النمط، 4) مجرى نموه لدى الفرد المعني، 5) الأساس المحدد تحديدا وراثيا لهذا النمو، 6) العوامل التي أدت إلى ظهور هذا العضو الذهني أثناء النمو". إذا كان انشغال النحو التوليدي بفطرية المعرفة البشرية يشكل النواة الصلبة لبرنامجه، فإن تشومسكي لا يفتأ يشدد على القطيعة مع التصورات الميتافيزيقية التي ترجع المعرفة التي يطورها ذهن الإنسان إلى ذات متعالية، وليس إلى أسباب وراثية متعلقة بالنوع البشري، فإذا كانت التصورات العقلانية مكسبا هاما في تاريخ الأنساق المذهبية للفكر الأوروبي، فإن التوجه الذي ينبغي أن يسلكه الدرس اللساني لمقاربة بنيات الفهم عن الإنسان يجب أن يكون استمرارا لذلك التاريخ من جهة اقتراضه للمواقف التي على اللسانيات أن تسلكها لفهم بنية الدماغ البشري، وانفصالا عنه من جهة تحويل النظر من المتعالي إلى الواقعي أي الأسباب الوراثية والنوعية المتعلقة بالجنس البشري والتي تؤدي إلى استعمال خلاق للغة، وحاصل الأمر، لم تحصل تلك القطيعة إلا بموجب تفاعلات وأزمات حصلت في مجال العلوم الطبيعية وبالضبط في حقل البيولوجيا وعلم الوراثة والفيزيولوجيا، والتي أفرزت محاور جديدة في الفكر العلمي، دفعت البرنامج العقالني إلى تحويل مستويات النظر من المتعالي إلى المتجسد. ومن ثمة لا يمكن فهم المقدمات المعرفية في النحو التوليدي إلا حينما نكشف عن تلك الأزمات الفعلية في الفكر العقلاني الأوروبي، لذلك نزعم أن الإمساك بتلك اللحظات في تاريخ البرنامج العقلاني سبيلا إلى حصر الأصول العلمية للدرس التوليدي، ومن هذه الزاوية تأتي مشروعية التحليل المحوري للعلوم، سنحاول إذن تتبع المفاهيم المحورية للبرنامج العقلاني بدءا من القرن 18 وصولا إلى بداية القرن 20، وهدفنا موضعة الفكر التوليدي داخل إرث نظري وملامسة مياسم التقاطع من جهة المفاهيم والمناهج: 1) يمكن التمييز بين برنامجين علميين سادا في نهاية القرن 19 وبداية القرن 20 انصب مجال تفاسيرهما على الخصائص المعقدة للكائن الحي، أحد هذين البرنامجين ينطلق من فرضية أساسية وهي أن العضويات مزودة بشفرة وراثية تحدد الخصائص المطردة للنوع، وأن تلك الخصائص لا تأتي من الخارج أو المحيط، وإنما تنبثق من الطبيعة الداخلية والمبرمجة للنوع. بينما يسلك البرنامج الثاني طريقا مغايرا لتفسير الخصائص الظاهرية، ويعتقد أن البنية المنتظمة تأتي نتيجة سيرورة إعادة الضبط الذاتي المستمرة من خلال تفاعل بين البنيات الداخلية والتي ليست مهيأة وراثيا بكل الخصائص الملاحظة، لتصل إلى حالة التوازن النهائية.
2 – ظهر محور البنيات القبلية مع جوسييه في مجال علم النباتات، حيث تم إحداث أنموذج جديد لتوجيه التفسير العلمي يتمحور حسب بالماريني حول: -معالجة البنية الميكروسكوبية أو الصغرية للكائنات، أو التمظهرات الجزئية والنوعية للعضويات- كل تغيير في البنيات الداخلية، يعود نفسيره إلى القوانين الذاتية للعالم-الصغري أو الجزئي للكائنات، ولا يمكن إرجاعه إلى المحيط الخارجي، والقطيعة الإبستمولوجية حدثت مع العالم الطبيعي ويشمان: "ولأن الجزئيات الفرضية لا يمكن أن تنظم حسب اختيارات عشوائية، ولكن حسب خضوعها للقاعدة محددة سلفا وحسب علمي، لا يمكن لعالم أن يعزو هذا النظام المنسجم إلى قوة إلاهية.. وإنما إلى قوانين طبيعية داخلية". وسرعان ما استطاعت العلوم أن تحل لغز هذا النظام مع الاكتشاف الرائد للصبغيات، والثنائية المفهومية: النموذج الوراثي والطبع الوراثي أو الظاهر، والتي استثمرها تشومسكي في نظريته تحت مفهومي النحو الكلي والخاص، فالنحو الكلي هو مجموعة القوانين الوراثية التي يتقاسمها البشر، ومن هذه الجهة يماثل مفهوم النموذج الوراثي الضروري لبناء النموذج النوعي المكتسب، كما أن النحو الكلي ضروري لاكتساب لغة معينة من خلال إثبات برامترات تحددها التجربة المحيطية، كان النموذج الوراثي ذا أهمية لتطور العضويات في تفاعلها مع الوسط. فالقدرة الوراثية تدمج جميع إمكانيات التحقق المتعلقة بالنوع، ويبقى دور المتغيرات محصورا في تحديد تحقق نوعي وخاص لجل الإمكانيات التي يتيحها النسق الوراثي. لهذا كانت لاكتشافات واتسن وكريك في حقل علم الوراثة دلالة كبيرة بالنظر إلى التصورات السابقة، إذ حاول ضبط البنية الداخلية لتلك القدرة الوراثية الداخلية وتحديد قوانينها التأليفية السابقة على كل تفاعل مع المحيط الخارجي، ويبقى دور التجربة المحيطة محصورا في إثارة تلك البنية الداخلية، لتحدث تأليفات جديدة بين العناصر الوراثية المبرمجة في الكائن الحي، مما يؤدي إلى الاختلافات السطحية، ومن هذه الجهة نلمس تشابها في الأجهزة الاصطلاحية الموضفة عند البيولوجيين وتشومسكي، حيث يستعمل هذا الأخير مصطلح الإثارة للدلالة على نفس الشيء، ويستعمل البيولوجيون مصطلح التقلبات التذبذبية، إذا مجال التفسير في الدرس التوليدي هو البنية الداخلية للمتكلم-المستمع المثالي، كما أن البيولوجيين حصروا موضوعهم في إطار المنطق الداخلي للبنيات الوراثية المبرمجة مسبقا في الكائنات الحية. وأخيرا نلحظ التشابه في فرضيات العمل بين كل من البرنامجين، فالتوليدي يعطي الأسبقية المنهجية لدراسة التنظيمات الممكنة أي النحو الكلي التي تنتج عنه أنحاء خاصة بموجب شروط محيطية محددة، على كل دراسة لتحققاته المتعددة وتمظهراته الخاصة، وهدف البيولوجي الوصول إلى القوانين الكلية المنظمة للنموذج الوراثي، وهذا التشابه يؤدي في منظورنا إلى إبراز تقاطع قوي بين اللسانيات التوليدية وبرنامج البحث العلمي في مجال البيولوجيا، وهذا التقاطع يبرز في عدة مستويات:
أ) من جهة المفاهيم المقترضة والتي استثمرها تشومسكي نظرا لانسجامها مع أهداف النظرية التوليدية، ولا ينبغي على الاختلاف الملحوظ في المصطلحات أن يخفي وحدة المفاهيم ووحدة الاتجاه.
ب)من جهة فرضيات العمل، إذ يمكن استنتاج اتصال النظرية التوليدية ببرامج البحث العلمية المعاصرة، حيث ترمي إلى استثمار نتائجها في دراسة البنيات المعرفية عند الإنسان، وانفصال عن الأفق المعرفي للأنساق العقلانية الفلسفية التي تربط فطريات المقولات الذهنية بمفاهيم متعالية، ولا تستضمر في برنامجها أي إمكانية للدراسة التجريبية لتلك الخصائص الفطرية المزعومة. وجماع الأمر نعتبر بعد بالماريني أن الدرس التوليدي وريث فكر عقلاني ظهرت مياسمه العلمية مع انطلاق الطبيعية في نهاية القرن 18 وبداية القرن 19، ومن ثم تهدف المقاربة للنظرية التوليدية إلى الحفر في الأصول العلمية والمعرفية للسانيات الديكارتية، وللتدليل على كون هذه اللسانيات تمتح من جهة المصطلحات ومناهج البحث العلمي من ذلك الإرث العلمي. لقد اعتبرنا من جهتنا أن ذلك الموروث العلمي استمرار لمحورية مفهومية عرفها الفكر الفلسفي عبر تاريخه، أي محورية العقلانية، والتي حول مجالها من المتعالي إلى التجريبي، ولم يحدث هذا التحول إلا موجب التقدم الحاصل في العلوم الطبيعية. ولأن برنامج هامبولت وياسبرسن وسابير..، انشغل بمسالة الكليات اللغوية كإطار لتوجيه البحث اللساني لم تكن عندهم اللسانيات جزءا من علم البيولوجيا، ولأن الدرس اللساني ظل حبيس التصورات الفلسفية للنحو العام، لم يكن بالإمكان وضع برنامج علمي متسق لدرس النحو الكلي، ولذلك كانت الانطلاقة التوليدية دالة في تاريخ اللسانيات الكارتيزية فهي استمرار للبرنامج أعلاه ولكن هذه الاستمرارية ليست ممكنة إلا من جهة تقاطع اللسانيات والبرنامج العقلاني في العلوم المعاصرة وذلك ما تستعلن عنه كتابات تشومسكي صراحة أو ضمنا، ومن هذه الجهة نشاطر الأستاذ الفهري في نعته للدرس التوليدي بالثورة المعرفية الحديثة، إذ ساهم بدراسته للغة البشرية وفق المنحى الديكارتي في الإبانة عن طبيعة أنساق المعرفة والاعتقاد في الذهن البشري، بل له التقدم التقني للحوسبة وأساليب بناء النماذج الصورية.
تتسم خصوصية المقاربة المحورية للسانيات التوليدية، كما قدمت من خلال اللساني الإيطالي بالماريني، في إدماج مستوى جديد للتحليل ينضاف إلى المستوى الوصفي والمستوى الميتودولوجي من منظور الإبستمولوجيين الوضعيين، وهو المستوى المحوري، فإذا كانت المفاهيم الواصفة والقضايا العلمية لها إسقاطات على البعد التجريبي من حيث جواز روزها وإبطالها، وإسقاطات تحليلية من منظور رياضي-صوري من جهة اتساقها الداخلي وتوظيفها لآليات منطقية ونمذجية معمول بها في العشيرة العلمية، فإن البعد المحوري يظل مهمشا في تاريخ المقاربات الإبستمولوجية للعلوم. لذلك لن تتكامل الرؤية المتسقة لبرنامج البحث العلمي في اللسانيات إلا بإدخال مستوى محوري، وهذه الرؤية تنسحب على الخطابات الإبستمولوجية التي تناولت الدرس التوليدي من جهة مقدماته الفلسفي والتصورية، ومن جهة آلياته الاستدلالي، وهمشت الأصول المحورية التي شكلت الركيزة الأساسية للبرنامج التوليدي وهي محاور العقلانية المعاصرة في صيغتها المعدلة مع البيولوجيين وعلم النفس المعرفي.
مثل هذا التحليل يمكن أن تستثمر نتائجه لدراسة تاريخ اللسانيات، إذ الغاية من إقامة تأريخ للفكر اللغوي، لا تنحصر في الوقوف عند القضايا اللسانية المناقشة وإنما في الكشف عن الأفكار والمحاور الموجهة للبحث اللغوي، وهكذا قد يبدو أن تاريخ الأفكار اللسانية يضم اتجاهات متعارضة، إلا أن الأصول والمقدمات التي تؤسس عليها أقوالها العلمية قد تكون واحدة، إذا كانت تجمعها محاور موحدة، وعلى العكس نفهم القطيعة في تاريخ اللسانيات على أنها تأسيس لمحاور جديدة في الدرس اللغوي، كمحورية اللسان كموضوع مجرد ومبنين ومتمفصلة مستوياته، ومحورية النحو كموضوع للسانيات بدل اللغة..
يندرج هذا الهاجس ضمن إشكاليات اللسانيات العربية التي تروم: "بناء نظرية تؤرخ للفكر اللغوي العربي، بعيدا عن الإسقاطات الظرفية، بتبني منهجية المحاور والنفاذ إلى الأفكار الدالة والمبادئ المحورية الموجهة للدرس اللغوي عند العربي". إذ قد نجد محوريات قديمة تتكرر في خطابات حديثة، كمشكل علاقة الوظيفة بالدور الدلالي، والإعراب بالدور الدلالي، وعلاقة الشكل بالمعنى والبنية بالوظيفة التداولية، وهي مشاكل نظرية نعثر عليها في جل الأنحاء القديمة عربية أو غير عربية: "هناك تقارب على مستوى المحاور [بين اللسانيات القديمة والحديثة]، إنما على مستوى الظواهر وعلى مستوى صيغ ووسائل مقاربتها، هناك في كثير من الأحيان قطيعة".
ـ كاستون كرانجر: من إبستمولوجيا اللسانيات إلى إبستمولوجيا الأنساق الرمزية للغات.
إن تطور إبستمولوجية اللغة مشروط بحالة العلوم التي تجعل من المعطيات الرمزية موضوعا لها من أجل وصفها أو بنائها. ويبدو أن طرح إبستمولوجية اللغة أتى كاستجابة لتحولات في فلسفة الأنساق الرمزية، نجملها [ التحولات ] في:
1 – بروز المنطق الرياضي كدراسة نقدية وبنائية للنماذج الصورية؛ فقد أدى تكون هذا الفرع المعرفي إلى تجديد بعض المسائل القديمة المتعلقة بفلسفة الأشكال الرمزية على وجه العموم، وتوجيه عناية اللغويين ببنية اللغات الطبيعية على ضوء التجديدات التي لحقت النماذج الصورية والرياضية .
2 – ظهور دلالة شكلية من طرف تارسكي وبولزانو، مما أدى إلى مساءلة دور المنطق في أنسقة الأوصاف الدلالية للغات الطبيعية، أما باعتباره أداة لبناء الأنحاء أو باعتباره نموذجا لهذه الأنحاء، وهكذا فالمساجلات في الأدبيات اللسانية بهذا الشأن تفضي إلى التمييز بين موقفين:
أ- الأول يعتبر المنطق أداة لصوغ نحو للغة الطبيعية، ويستبعد نموذجية المنطق بالنظر إلى اللسانيات، ولذلك ينكر على الأنساق الشكلية للمنطق دور النموذج المثالي للغات الطبيعية، ففحص بنية اللغة الطبيعية المدروسة هو وحده الذي يمكن أن يمدنا بقاعدة لتبرير اختيار نسق شكلي كنموذج للغة الطبيعية . والحجة الثانية تتعلق بافتقاد الأنساق الشكلية للقدرات التعبيرية الغنية في اللغات الطبيعية .
ب – الموقف الثاني يشدد على كون المنطق جزءا من نظرية اللغة، يقترح بارهيل إدماج المنطق في علم الدلالة الكلي وفي قواعد الدلالة ويستبدل مونطاك مفهوم البنية العميقة بمفهوم الشكل المنطقي، وهكذا يصبح المنطق في منظور مونطاك وسكوت جزءا مكونا لنظرية اللغة نفسها، مما يستبعد كل تصور أداتي له في علاقته باللسانيات.
3 – كان لفكرة بناء خوارزمي للأنساق الشكلية والمطبقة على اللغات الطبيعية، كقيد بول على التحليلية، ونظرية المجموعات والمتواليات، تأثير على نظرية البنيات الصورية الممكنة للغة الطبيعية. وجماع الأمر، لقد ساهمت التطورات المعرفية في حقل المنطق الرياضي في بلورة قضايا إبستمولوجية مدارها اللغة الطبيعة والنماذج الصورية الممكنة لتمثيلها. إلا أن هذا التحول أتى بموجب التجديد الحاصل في اللسانيات نفسها، إذ لم يكن بالإمكان صياغة تلك القضايا، لولا النظر إلى موضوع اللسانيات كبنية شكلية مجردة ومبنينة في مختلف المستويات اللغوية (الصوتية والصرفية والتركيبية..): "فالنتيجة الضمنية لهذا الطرح، تتعلق بتقييد المقاربة العلمية للغة لبناء النماذج المجردة لتلك المستويات ولإمكانيات تمفصلها المبنين مع هيلمسليف ومارتيني، إلى حد نفي قدرة المعطيات على دحض أو تأكيد نظرية لسانية، فدور النظرية عند هيلمسليف هو تحقيق الشمولية وعدم التناقض والانسجام، فهي مرجع بسيط للوصف، واستراتيجية لاختزال المفاهيم".
لكن مسار الدرس اللساني المعاصر يقدم لنا نظريات متضاربة، تختلف بالنظر إلى ما تعده نموذج مجرد للبنية اللغوية، وهذا التعدد في الأنساق الرمزية يستدعي تدخل إبستمولوجية للنماذج الصورية تبين قدرتها على دراسة الخصائص والمبادئ الانتظامية المفترضة في اللغات الطبيعية، وتقويم مفترضاتها النظرية حول سيرورة التواصل اللغوي. يرى كرانجر أن هدف إبستمولوجية اللسانيات الإجابة عن الأسئلة التالية، وتحديد حلول مناسبة للقضايا المتصلة بها:
1 – ما هي الخصائص التي يجب على كل نموذج مجرد لتمثيل اللغة كنسق أن يستجيب لها؟
2 – هل يمكن بلورة بنية كلية للغات الطبيعية مع التنوع الواقعي للغات الطبيعية وتعقيد الأنحاء؟
3 – ينبغي المفاضلة بين ثلاثة نماذج للغة الطبيعية: نموذج استقرائي يصف نسق اللغة ونموذج تأليفي يأخذ بعين الاعتبار تعقيد انتظام اللسان من الناحية التركيبية أو الصوتية أو الصرفية، ونموذج كلوسيماتي غارق في التجريد، إذ يعود أمر المفاضلة إلى إبستمولوجية اللغة الرمزية التي تصوغ قيودا وفرضيات صارمة حول نسق وتبنين الألسن الطبيعية.
4 – على هذه الإبستمولوجية أن تكون شاملة وعامة، إذ ينبغي أن تقطع مع الدراسات التي حاولت صورنة الأنساق –الفرعية في تعابير اللغات الطبيعية، من أجل بلورة منطق نوعي لها (مثل دراسة منطق الزمن أو منطق الجهة في لغة ما).
5 – إقامة إبستمولوجية مقارنة بين الأنساق الرمزية اللسانية وغير اللسانية لحصر حدود إمكانية استفادة الأولى من الثانية.
6 – تنطلق هذه الإبستمولوجية من فرضية موجهة، تنظر إلى اللغة كنسق رمزي معقد من الناحية البنيوية والوظيفية، وأن السبيل الوحيد لمقاربته هو تقسيم اللغة إلى مستويات تمثيلية متمايزة ومتمفصلة في الآن نفسه كالمستوى الصوتي والتركيبي والتداولي، ومحاولة ضبط انتظامات هذه المستويات والقوانين الثاوية فيها، يقول كرانجر في هذا الشأن: "ولأن اللغة محددة تحديدا مضاعفا ينبغي على الفكر الشكلي المنمذج لها أن ينفصل إلى أنساق متنوعة تصف أو تفسر مستويات انتظامها"، ووفق هذا التحديد لن تعود النماذج الرمزية مجرد أدوات صورية لإجراء التمثيلات اللسانية، وإنما ستغدو البنية المحايثة للغة نفسها، لأن اللغة الواصفة تترجم على المستوى المفاهيمي التمفصلات المبنينة في الألسن الطبيعية. ومن هذه الجهة تنصهر اللغة الواصفة في النظام اللغوي، خلافا للطروحات اللسانية التوليدية التي تقوم على اعتبار المفاهيم الواصفة خارجة عن هذا النظام، ولذلك أمكن لإبستمولوجية اللغة أن تقترض مفاهيما لضبط موضوعها من علم البيولوجيا ومن النظرية الكارثية لروني توم: كمفهوم الضبط الذاتي والانتظام والاستقرار، وهي مفاهيم تعكس الخصائص البنيوية المجردة للأنساق الرمزية سواء كانت عضوية أو غير عضوية لذلك فهي تندرج في إطار سيميوطيقا عامة.
تنفرد نظرية كرانجر بمميزات خاصة، تبرر الاختلاف بينها وبين النظريات الإبستمولوجية السابقة، لكن تجمعها والإبستمولوجية الوضعية خصائص مشتركة تبرز خصوصية البرنامج الوضعي في كليته من ذلك:
أ – إبستمولوجية اللسانيات موضوعها لغة العلم، وأساليبها البرهانية والقياسية، لذلك حصرت إبستمولوجية كرنجر موضوعها في نطاق الأنساق الرمزية وكفايتها في النظريات اللسانية، وأن هدف اللسانيات ليس الوصول إلى كليات لغوية مزعومة، وإنما الكشف عن الخصائص الداخلية التي تجعل من اللغة نسقا مبنينا بامتياز.
ب – يتحصل من كل ما سلف أن كرانجر لا يخضع اللسانيات إلى معايير علمية سابقة عن كل نشاط عقلاني كما هو الشأن عند بوطا، بل إن إبستمولوجية هذه اللسانيات جزء لا يتجزء من الطبيعة البنيوية للنماذج الرمزية على وجه العموم، ومن النسق الداخلي والمحايث للغة على وجه الخصوص والذي على الإبستمولوجية أن تحدد خصائصه للنظر بعد ذلك في إمكانية وحدود النماذج اللسانية والرياضية على تمثيلها صوريا.
ج – يؤاسر كرانجر طروحات كريسيفا من جهة وعيه بكون نشأة إبستمولوجية اللسانيات أتت كاتسجابة لشروط إبيستيمية تتعلق بتطور علم المنطق وبتطور اللسانيات نفسها، ولهذا أتت نشأتها كاستجابة لضرورة معرفية.

دحماني بختة







 دحماني بختة
دحماني بختة