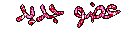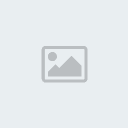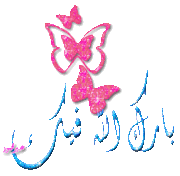مكونات السرد في النص القصصي
الجزائري الجديد
في البداية…
لا أحد ينكر أن القصة العربية قد مرت بمراحل عدة، وهي تسعى لتشكيل خطابها المتميز سواء على المستوى الفني أو المضموني وهي بذلك لم تخرج عن دائرة تطور فن القص العالمي، خاصة بعد تطور مناهج العلوم، والنقد الحداثي بطروحاته الجديدة.
ولعل منطق التطور يفرض أن القصة في الجزائر لا يمكن لها أن تكون خارج هذه الدائرة، فلقد مرت بمراحل تواكبت مع نمو الوعي الثقافي، حيث كان حضورها قوياً في كل ما تعلق بالواقع الجزائري آنذاك. ولقد تلمست هذه الظواهر بعض الدراسات النقدية التي تتبعت الخط البياني لتوجه هذا الجنس الأدبي واهتماماته، وكان التركيز منصباً خصوصاً على فترة الأعوام السبعين التي عكست فيها القصة الجزائرية التحولات الاجتماعية والسياسية في الجزائر.
وأعتقد أن فترة ما بعد هذه التحولات قد عرفت الجديد، بحيث فتر عنف المضمون في الكتابات النثرية خاصة، وتم التراجع عن بعض الأفكار التي شهدها العالم، وقد انعكس ذلك على ميدان الأدب والدراسات النقدية، وبدأ خطاب جديد يتشكل وفق هذه المتغيرات يحمل خصوصياته المتفردة، إلا أن ما كتب من قصص بعد المرحلة المذكورة سواء منها المطبوع في مجموعات أو المنشور عبر الدوريات مجزءاً بقي خارج الدراسة بمعناها العلمي عدا ما يتصدر صفحات الجرائد غير المتخصصة، وهي وقفات انطباعية، لم تستطع أن تضعها في سياق تطورها، انطلاقاً من منطق التطور كما أشرنا…
ومن هنا كان اهتمامي كبيراً لمساءلة هذا الموضوع مع علمي أن جيلاً جديداً يكتب القصة بمنظور مخالف لمن سبقه، وهو بذلك يبلور تجربة جديدة، يحاول من خلالها التمرد على كلاسيكية الطرح، وقيود الشكل التي حاصرت قصص المرحلة السابقة.
وقد كنت متحمساً لطرق هذا الموضوع –على الأقل- لأظهر من خلال دراسة بعض النماذج أن ما كتب في هذه الفترة هو مخالف لسابقتها، وبتأطير زمني ومكاني، واختلاف في التوجه والرؤية، إلى جانب ما تطرحه المثاقفة والتناصية في فترة تعرف فيها العلوم الإنسانية أوج تطورها. ولقد كان حتمياً أن تدرس هذه المرحلة، ومميزات فن القصة فيها لأنه –وفي حدود معرفتي- أن القصة العربية جميعها قد عرفت تحولات في هذه الفترة، ولا ينبغي، بل ولا يعقل أن لا يشمل التغير فن القصة في الجزائر.
وقد أدرجت في هذا الكتاب نصوصاً من مجموعات قصصية وبعضاً مما هو منشور بصحف ومجلات وطنية، رأيت أنها تمثل النموذج لوجه الاختلاف بين المرحلتين، وهي لمبدعين أراهم يتعاملون مع الإبداع أولاً، قبل أن ينشغلوا بالمضامين التي أساءت إلى القصة الجزائرية في الفترة السابقة، وقد تتبعت فن القصة الجزائرية منذ بداية تشكلها ومراحل تطورها، وما تطرقت له من هموم المجتمع، ثم ركزت على الأعوام السبعين، وهي فترة تميزت فيها القصة الجزائرية بعنايتها بالمضمون خاصة.
ثم عرجت إلى بنية اللغة في القصة الجديدة، حيث أظهرت من خلال نماذج تطبيقية أن اللغة عند هذا الجيل، هي كشف وتجاوز للمثال، فهي وسيلة للإيحاء وليست أداة لنقل معان محددة، وقد استطاع هؤلاء الكتاب التخلص من أسر المضمون الكابح، بحيث توصلوا من خلال تجربتهم الجديدة إلى أن الفصل بين لغة الأثر الأدبي ومضمونه من شأن أن يحول دون النفاذ إلى صميم نوعيته فكانت اللغة عندهم هي الوسيلة والغاية في آن واحد. لأنهم –الجيل الجديد- أسسوا من خلالها خطابهم القصصي المتميز.
ولعل تركيزي على اللغة يعني شيئاً واحداً، أنها المفتاح والأداة التي تجعل النص ينفتح على عوالم شتى حيث يتشكل المضمون وفق رؤى انزياحية يلعب فيها الرمز وجدليات المكان والزمان الدور الأكبر.
وقد أفضى بي ذلك إلى تحليل بنية السرد حيث درست البنية السردية في الخطاب القصصي الجديد فوجدتها تتشكل وفق رؤية حداثية تتكسر فيها النمطية الخطية، ويخضع النص فيها لجدلية المغايرة والإدهاش، وانمحاء النمطية سواء على مستوى الضمائر أو الشخصيات التي تفرض حضورها في النص التقليدي إلى جانب ما عرفته القصة الجديدة بشكل عام من تقنيات حداثية كطرائق الحكي، وانفتاحية النص على عوالم غاية في الغموض.
ثم أشرت إلى تقنيات التعامل مع الزمان في قصص هذا الجيل، بحيث أصبح الزمن ومع ما أضافته الدراسات الحداثية لـه، والفلسفية خاصة، من تقنيات غاية في التجريد، أصبح لـه مفهوم آخر، فلم يعد ذلك الزمن الكرنولوجي، التعاقبي الذي يسير متواطئاً مع الحدث إلى آخر المطاف، بل أضحى يشاكس الأحداث ويتجاوزها متماوجاً بين النفسي والأسطوري والغيبي، وهو ما جعل القصة الجديدة لا تستقر على حال مما يستدعي قراءة فطنة وحذرة تؤطرها التجربة.
وكنت دائماً أشير إلى أن هذه التشكيلات الفنية الجديدة إنما تخضع لتحولات ثقافية ونفسية أطرت عالم الكتابة، بحيث انتقلت من سلطة النموذج إلى فاعلية التجريب. ومهما يكن الأمر، فهذه دراسة تبقى مجرد محاولة لمساءلة فترة تميزت بكتابات قصصية كثيرة نسبياً دون أن يسايرها نقد يؤطر مسيرتها، ويوجهها ولعلها تكون فاتحة لمساءلات أخرى أكثر انفتاحية وأشد صرامة.
بشار ماي 2000
عبد القادر بن سالم
بداية تشكل القصة العربية
في الجزائر
أولاً : ملامحها إبان الثورة
ثانياً : البنية الفنية لقصص الثورة
ثالثاً : بنية الخطاب القصصي بعد الاستقلال
أ-فترة ما قبل الثمانينات
ب-ملامح القصة الثمانينية
1-فتور عنف المرحلة وتراجع محور المضمون
2-تطور مناهج العلوم وتأثيرها على الخطاب القصصي
3-تراجع النقد عن المفهوم السوسيولوجي
إن الحديث عن القصة الجزائرية القصيرة يحيلنا إلى تتبع المحطات التي سلكتها حتى وصلت إلى ما هي عليه الآن. ولعلنا لا نضيف جديداً في هذه الوقفة بقدر ما نمهد لموضوعنا الذي لا ينبغي أن يؤسس بمعزل عن هذه الخلفية المنهجية التي يتطلبها البحث.
أقول هذا لأن كثيراً من التوطئات التاريخية قد أحاطت بموضوع القصة العربية في الجزائر إلى جانب دراسات أكاديمية أخرى تمحورت حول شكلها ومضمونها من قبل أساتذة مختصين كعبد الملك مرتاض وعبد الله الركيبي وآخرين. وفي الحقيقة أن الدارس للقصة الجزائرية والمتتبع لأطوار نموها لا يجد صعوبة كبرى في الوقوف على ملامحها سواء من حيث المضامين التي تناولتها أو من حيث شكلها، لأنها نشأت في الأدب الجزائري متأخرة إذا قورنت بجنس الشعر الذي لقي اهتماماً كبيراً من قبل المؤسسات الثقافية آنذاك.
فمفهوم الأدب الذي كان منطبعاً في الأذهان هو جنس الشعر، كونه يعود إلى الارتباط اللاشعوري بالبيئة العربية القديمة التي كانت تتنفس الشعر في حلها وترحالها وتعده المرجعية الأساس لكل تعبير ثقافي "فلم يكن هناك أصلاً اهتمام بالقصة كفن قائم بذاته، بل أن مفهوم الأدب كان ينحصر في الشعر وحده"(1).
ومما زاد في تعميق هذه الهوة وإبعاد كل ما هو نثر ذلك الارتباط القوي بفضاء الشعر والذي يعود –كما أشرنا- إلى فكرة: الشعر ديوان العرب.
وقد رسخت بعض الجرائد آنذاك هذا المشهد فكانت جريدة البصائر مثلاً تخصص بابا للأدب الجزائري لا تنشر فيه إلا الشعر… مما فرض غربة على فن النثر، وشعور كتابه بالحيف، وفي هذا المعنى يشير عبد الملك مرتاض إلى "أن هذا الفن كان غربياً في الجزائر لدرجة أن البعض كان يوقع قصصه باسم مستعار"(2).
وهذا ما يجعلنا نقر أن ظروفاً كانت وراء تخلف جنس القصة في الجزائر مقارنة بمثيلتها في المشرق العربي التي بدأت في تشكيل خطابها المتميز لتزاحم في ذلك الشعر "ففي الوقت الذي كان من الممكن أن تستفيد القصة الجزائرية من القصة العربية تأخرت إلى ما بعد الحرب العالمية الأولى بسبب تأخر الثقافة في الجزائر"(3).
وهكذا استمر هذا الشعور مرافقاً لأغلب كتاب النثر الجزائري حتى امتزج بتبلور الشعر الوطني بعد الحرب العالمية الأولى وظهور الحركات السياسية والوطنية ثم مناداة الحركات الإصلاحية بالرجوع إلى التراث القومي من لغة وتاريخ ثم الاتصال مع الشرق، وهكذا… وهو ما تؤكده مقولة الهادي السنوسي:
"من منا معشر الأدباء الجزائريين من لم يفتح عينيه منذ انتهت الحرب الأولى الكبرى على آثار مدرسة إسماعيل صبري وحافظ وشوقي، وطه وأحمد أمين"(4). فالفن القصصي كان خلال العقد الرابع من هذا القرن في الجزائر لا يزال يدرج درجاناً فيه كثير من الخجل والفتور، ولم يعرف النثر الأدبي في الجزائر قبل الحرب العالمية الثانية قصة واحدة فنية بكل ما يحمل اللفظ من مدلول الفنية في الأدب "بيد أنه من الظلم إنكار ما كان لظهور بعض المحاولات من آثار طيبة على حياة الفن القصصي فيما بعد الحرب الثانية، فقد أقامت هذه المحاولات الأساس ومهدت الطريق ورسمت بعض المعالم"(5).
يؤرخ عبد الملك مرتاض ميلاد أول قصة على يد محمد سعيد الزاهري الذي نشر محاولة بعنوان فرانسوا والرشيد، وهي محاولة "نالت إعجابا شديداً لدى المثقفين الجزائريين، وأثارت ضجة أدبية كبرى لموضوعها الجريء"(6). ومنذ ذلك الوقت وهي "تدرج ثم تحبو على يد الرعيل الأول من أمثال الزاهري وعابد الجلالي، وأحمد بن عاشور"(7).
وفي الواقع أن الدافع إلى كتابة هذه المحاولات التي تفتقر إلى مفهوم القصة بمعناها الفني، والتي كانت في نفس الوقت المرجع في تشكيل هذا الجنس الأدبي في الجزائر "لم يكن دافعاً أدبياً بقدر ما كان دافعاً لخدمة الفكر والدعوة الإصلاحية، وشرح أفكارها بأسلوب قصصي يمكن القارئ من أن يتلقى الأفكار الإصلاحية ويتفهمها"(8).
وهو ما ظهر جلياً في محاولات الزاهري في كتابه: "الإسلام في حاجة إلى دعاية وتبشير" وهي إرهاصات أولية تتوفر بشكل نسبي على عنصر القص، حاول كتابها أن يميزوها عن المقال الخطابي الضيق، غير أن النظرة السلفية للأدب تظافرت مع الذوق السائد للحيلولة دون أن تصل محاولاتهم إلى ما كانوا يصبون إليه(9). فلم تبرح دائرة التصوير الفج، والنظرة السطحية فكانت نماذج يغلب عليها تقليد الأشكال القصصية القديمة كالمقامة، أو أدب الرحلات. وقد يعود هذا الانتكاس إلى اللغة نفسها بحيث لم تشهد تطوراً، ومرونة بعد أن ارتبطت بالحركات الإصلاحية السلفية التي كان همها أن تعود اللغة كما كانت في سالف العصر، لغة شعر وخطابة(10). وهكذا استمرت هذه "المحاولات المحتشمة تتأرجح بين الصورة القصصية والحكايات"(11) موظفة عنصري السرد والحوار الخارجي الذي تلتصق جذوره بالقصص الشعبي… وهذا نص يحيلنا إلى شكل من هذه الأشكال القصصية التي ظهرت في تلك الفترة، يقول محمد بن العابد الجلالي: فقال هو: "ما الذي تعنين بلفظ الإنسانية هذا، يجب الاحتراز في فهم معنى اللفظ، إذا كان لفظ الإنسانية في نظرك يشمل تلك الطبقات المنحطة الجاهلة، فأديسون، وماركوني أعقل من يجهدا أفكارهما في إسعاد تلك الكمشة المبتذلة التي ما خلقت إلا للسحرة"(12).
أما بعد الحرب العالمية الثانية، فقد قويت الثقافية مع المشرق العربي بالبعثات والوفود، وكان لهذا الانفتاح أثره في تغيير النظرة السلفية للأدب بشكل عام، وللخطاب بشكل خاص. فغدا الكتاب يحاولون بشيء من الجرأة اقتحام هذا الجنس الأدبي بنظرة تجاوزية، بحيث ابتعدوا عن تلك الرؤية السكونية التي يغيب فيها عنصر الحيوية، وسمات الشخصية، فكان أن هزت هذه الانتفاضة الثقافية مشاعر الكتاب الجزائريين لتمدهم بديناميكية جديدة خرجوا على إثرها من دائرة النمطية المغلقة ليعانقوا أفقاً أرحب في مجال الإبداع، وهكذا ظهر جيل جديد طرح قضايا ما كانت لتطرح في تلك الفترة كقضية المرأة مثلاً، التي تبناها أحمد رضا حوحو.
وهو أول من خصص لها مقالات منفردة، ثم زهور ونيسي، وآخرون بعد أن اقتنعوا بأن فن القصة في الجزائر يجب أن يخطو خطوات إلى الأمام كما هو عليه في المشرق.
ولعل هذا الوعي بتخلف فن القصة في الجزائر هو الذي أدى برضا حوحو إلى أن ينشر مقالاً بجريدة البصائر يطلب فيه من الكتاب أن يهتموا بكتابة القصة لهدفين:
الأول : النهوض بالأدب بشكل عام.
الثاني : هو ما أطلق عليه التقويم الخلقي والاجتماعي(13).
وهذا الاعتراف من الكاتب أحمد رضا حوحو كاف ليظهر أن فن القصة العربية في الجزائر كان يمكن له أن يقوم بالكثير لو ترك له المجال، ولم يهمش أيام الحركة الإصلاحية، حيث الشعر هو السيد، وقد عجز وحده عن احتضان هموم الإنسان الجزائري وقضاياه الاجتماعية الحساسة في تلك الفترة الصعبة. وهكذا بقي هذا الجنس النثري يتراوح بين الحكايات والصور القصصية، التي حاولت أن تقبض على الزمن القصصي بمعطياته الفنية، لكنها عجزت، فكانت قصة غير ناضجة "يمكن اعتبارها تأسيساً لجنس القصة بمفهومها الجمالي في ما بعد"(14).
واستمرت هذه النمطية في الكتابات مع اندفاع حماسي أحياناً في محاولة لتطوير هذا الفن وتخليصه من ثقل الأسلوب وتحجر اللغة، "فكانت الدعوة صريحة لجرأة قلمية، وتهجم فكري على ما لم يسبق طرقه من
المواضيع"(15).
وعلى هذا يمكن الحديث عن تطور نسبي لفن القصة في الجزائر بعد الحرب العالمية الثانية حيث انتشرت الصحافة العربية في الجزائر، وعادت الحياة إلى سيرتها الطبيعية "فظهر كتاب جدد، أخذوا يعالجون الفن القصصي ويتعاطونه بشيء من الفهم والنجاح معاً كرضا حوحو، أحمد بن عاشور وأبو القاسم سعد الله، وعلى أيديهم اتسعت المضامين، فشملت الوطني الاجتماعي والنفسي"(16).
وقد كان لذلك تأثيره في اقتحام الكتابة في مجال القصة. ومن المرتكز نفسه يمكن اعتبار هذه المرحلة جديدة سواء على مستوى المضامين أو على مستوى النضج الفني الذي ظهرت فيه قصص هذه الفترة، وهذا شيء طبيعي لأن ميلاد القصة الفنية في الجزائر لم يأت إلا بعد مراحل، "فلم يكن تطورها مفاجئاً، وإنما سارت في طريق التطور ببطء"(17).
أولاً: ملامحها إبان الثورة
إن علاقة الأدب الجزائري بالثورة التحريرية لم يعد شيئاً يحتاج إلى تأكيد، كون هذه العلاقة كانت ولا تزال حميمية. فالكاتب الجزائري هذا الممتزج بالأرض روحاً ودماً قد سخر قلمه لينفث من ذاته أجمل ما تقوله الكلمة اعترافاً لهذا الوطن بجميله.
وكان فن القصة قد أطلق من أسره لينافس الشعر، بل وليتجاوزه بخطاب أكثر مصداقية وواقعية، بعد أن وجد الأرضية التي طالما بحث عنها والفضاء الذي اكتفى لأن يكون كمتنفس، وهكذا يمكن الحديث عن قصة بدأت تتلمس بعض عناصر الفنية مع الثورة التحريرية "باعتبار أن هذه الثورة كانت الحلم العذب الذي طالما راود النفوس"(18). وقد فتقت مواهب الكتاب فكانت لهم الدافع لخوض غمار الكتابة في هذا الجنس الأدبي، بعد أن كانوا لا يريدون الحديث عن فن يسمى القصة. تاركين المجال للشعر، حتى غدا الأدب في الجزائر هو الشعر وكفى.. إن الثورة التحريرية قد دفعت بالقصة خطوات إلى الأمام بأن جعلتها تتجه إلى الواقع، تستمد منه مضامينها وموضوعاتها، فتحول محور الارتكاز من التقاليد والحب والمرأة إلى الإنسان والنضال والروح الجماعية، وقد مثل هذه المرحلة أدباء، أبرزهم عبد الحميد بن هدوقة والطاهر وطار وعثمان سعدي.
ثانياً: البنية الفنية لقصص الثورة
حين أشرنا إلى أن القصة العربية في الجزائر قد بدأت تعرف النضج مع بداية الثورة، حيث أطلق أسرها وتخلصت من عقدة الشعر إلى جانب الانفتاح الثقافي على العالم العربي فإن ذلك لا يعني الجزم أنها أصبحت تتوفر على السمات الفنية الكاملة لجنس القصة، فقد حافظت في هذه المرحلة على البناء الكلاسيكي ولم تتخلص كلياً من بعض السقطات كاللغة الوصفية الموغلة في التقريرية، والحوار الخارجي الذي ظل يطفو على السطح، ولم يمس عمق الذات، ثم البقاء في دائرة المضمون الثوري الذي أثر على تطورها فنياً.
وقد عبر عن ذلك محمد مصائف فيما يتعلق بكتابات الطاهر وطار، حين يقول:
"إن وطار كاتب فكرة بالدرجة الأولى، وهو أن كتب قصة، فإنما ليعبر عن موقف فكري يشغله منذ زمن، ولعل هذا ما يسمح له أحياناً باعتبار شخصياته شخصيات واسطة"(19).
وهذه الوسطية –في رأينا- هي التي جعلت فن القصة في الجزائر في تلك الآونة يخضع لنمطية سكونية لا يبرحها "فإذا بحثنا عن الحدود الفنية لهذا الجنس ألفينا الحياة الاجتماعية والاهتمامات القومية تطل جميعها على القارئ الواعي من كل سطر من سطور القصة"(20). وهذا ما أثر على بناء القصة فنياً باعتراف النقاد الجزائريين.
ثالثاً: بنية الخطاب القصصي بعد الاستقلال
أ-فترة ما قبل الثمانينيات
هل يمكن الحديث عن ملامح قصة جزائرية متميزة فنياً عن القصة التي كتبت إبان الثورة. الحقيقة أنه لا يمكن ذلك لأن الجيل الذي كتبها في هذه الفترة هو نفسه الذي مارس كتابتها بعد الاستقلال، حيث كان خطابها يحمل الهم ذاته، إن لم نقل أنه ازداد تشعباً فالمضامين التي وجدت القصة نفسها في مواجهتها كانت أكبر مما يتصور، ولذا لا نخال الدارس يحتاج إلى طول تأمل من أجل أن يقتنع بطغيان المحور الاجتماعي على مضمون ما صدر من مجموعات قصصية، حتى كادت هذه الكتابات أن تتوحد في صوت واحد لترسم خطها البياني في عمق التحولات التي كان المجتمع الجزائري مقبلاً عليها، بحيث طغى مصطلح الالتزام الذي يستند –كما هو معروف- إلى خلفية أيديولوجية، هي وليدة تحولات مدارسية شهدتها أوربا مطلع هذا القرن فكان التزام الأديب الجزائري كما يرى وطار "نابعاً من اقتناعه في إطار الأيديولوجية الاشتراكية، وأن يكون كالتزام العامل المناضل الذي لا ييأس من صلاح الأوضاع، ويتحمل من أجل المحافظة على الخط الاشتراكي كل ما يصيبه من أتعاب"(21).
إن هذا النزوح المجتمعي الحاد الذي طبع آفاق عشريتين بعد الاستقلال كان يستمد مرجعيته من متن اجتماعي توحدت فيه كل الرؤى والتصورات "لتنتهي إلى الواقعية منهجاً في معالجة القضايا الحيوية المختلفة"(22). وهي معالجة لم تخرج عن الرصد السطحي لنوعية الصراع، فاعتمدت على الخطاب المباشر "مما أسقطها في الشعارية والسطحية، فابتعدت عن الفن وعن
الجمالية"(23).
ولعل ما يكشف هذا التوحد تحت وطأة عنف المضمون الذي شمل هذا الجنس الأدبي في الجزائر، وجعله يئن تحت سلطة محمول اجتماعي مباشر، وغاية موجهة ما ذهب إليه الطاهر وطار، حيث يشير في مقدمة روايته "اللاز" إلى قولـه: "سأقتطع من عمري سنوات أخرى ساعة، فساعة، لأصنع رسماً جميلاً لبلادي الثائرة بلاد التسيير الذاتي، والثورة الزراعية، وتأميم جميع الثروات الطبيعية والمسيطرة على تجارتها الخارجية والمتصنعة والتثقيفية، والواقفة إلى جانب جميع الشعوب المكافحة في العالم"(24). ومن أجل كل ذلك "نلفي ظل هذه الثورة لا يكاد يزايل كاتباً من الكتاب الجزائريين فمنهم من يؤثر فيه أشد التأثير ومنهم من يؤثر فيه تأثيراً عابراً، لكنه ثابت ملموس"(25).
ولعل الدراسة التي قدمها عبد الملك مرتاض في كتابه القصة الجزائرية المعاصرة، والتي توصل من خلالها –وبدقة إحصائية- إلى عنف المضمون وطغيان البعد الاجتماعي في سبع مجموعات قصصية لكتاب نخالهم يمثلون –بحق- القصة الجزائرية بعد الاستقلال. إن هذه الدراسة لا تترك أمامنا مجالاً للشك في ما أشرنا إليه سلفاً، بحيث استنتج الباحث تقاطع هذه الأعمال في محاور مشتركة لم تخرج في مجملها عن دائرة الفقر، والهجرة،
والأرض"(26). كما توضحه هذه الرسمة.
مج(1)
مج(4)
مج (7)
(فقر+ جهل+ هجرة…)
إن الحديث عن هذا الجيل وإن لم يستطع التخلص من ثقل مرحلة الثورة والتحولات الجديدة التي سايرت الأدب في تلك الفترة لا ينفي عنه كونه حاول أن يتمثل بعض التجارب الفنية التي وصلت إليها القصة العربية على الأقل، مما أدى ببعض كتابها إلى مراعاة المزاوجة بين الإبداعي والمضموني المجتمعي من خلال إطلاعهم على الروافد الفكرية والاحتكاك بالجامعة وطغيان المناهج الحداثية التي ركزت على الجمالية وتعاملت مع اللغة بوصفها بنية فعالة مؤثرة في السياق(27). لكن أغلب هذه الكتابات لم تفلح في الخروج من دائرة هذا الاجتماعي الطاغي، وهي فكرة يدعمها محمد مصائف حيث يشير إلى أن "معظم مواضيع القصة الجزائرية بعد الاستقلال لا تبرح الثورة وما يتصل بها من حديث عن الهجرة خارج الوطن، وآثار الاستعمار كما هو عليه في مجموعة زهور ونيسي-الرصيف النائم- ودودو في –بحيرة الزيتون- ووطار في الطعنات"(28). ولم تبرح القصة خلال هاتين العشريتين إطارها الذي رسمته لنفسها منذ بداية تشكلها مما يدفعنا إلى القول إنها لم تحدد لنفسها خصوصية، وسمات تميزها، مما جعلها تؤول إلى نمطية آلية وتكرارية مقيتة في خضم الواقع برصد أفقي، حتى أن الدارس لقصص هذه المرحلة لا يجد إلا صوتاً واحداً يتكرر عبر هذا التراكم الكتابي وقد ملت الأذن سماعه لأنه خطاب بات يعيد نفسه عبر عشرات القصص المنشورة هنا وهناك، وقد افتقرت إلى ذلك التصور الفني كمفهوم شامل للكتابة، "والاعتماد على الحالات الفردية والجماعية وتحركها المتواصل كتجسيد لمختلف المفاهيم النظرية والأيديولوجية، بل يكتفي بالرصد السطحي(29).
إن قصص هذه المرحلة لم تستطع أن تبلور تجربة فنية متميزة تتمظهر فيها التجليات الجمالية، بل راحت تؤسس التجربة المضمونية بكل عنف وتؤرخ مجتمعة لصيرورة البنية الاجتماعية مما جعل هذا العنف يسمو على كل تفكير في البناء الفني، ويطغى على كل تجريب يخص هذا الفن النثري.
ولعل أقرب شيء يمكن ملاحظته في عقم هذه المرحلة من حيث بنيتها الفنية هو عجز اللغة كأداة قوية في تثوير النص، والسير به بعيداً في عمق الأحداث فكانت غائبة عن ديناميكية الحدث، بحيث لا نشعر بأن هذا الرصف من الجمل إنما يتوحد ويشكل كلا متكاملاً مع تجربة الكاتب، بل نحس أن هناك انفصالاً رهيباً بين هذه اللغة المحكية كنسيج فني، وبين أحداث العمل القصصي.
وعليه فاللغة لم تسهم في كشف الأبعاد الدرامية للموضوع المتناول.
"فبدل أن تكون وسيلة للكشف، وتنمية الموقف الدرامي، فقد أصبحت عائقاً كبيراً يسهم بشكل مباشر في عملية الهروب من التشكيلات الجديدة للغة"(30).
فظلت بعيدة كل البعد في الكثير من المجموعات القصصية عن أداء دورها الفعلي، فهي سطحية لا تتجاوز لغتها البعد المعجمي، ولم تكن ذات ظلال وأبعاد نفسية يكشف من خلالها الكاتب عن أغوار الذات وتناقضات المواقف التي عالجها في تلك النصوص وبالتالي ظلت جامدة تحس أنها موظفة قسراً في كثير من الأحيان بل "أنك لواجد استخدام القاموسية الكلاسيكية، أو الكلام الميسور الأقرب إلى الأذن"(31).
ولعل ما يؤكد أن قصص هاتين العشريتين كانت كائنة بالمادة الاجتماعية أنها لم تكن تملك وعياً فنياً متكاملاً، لأن الصدق الاجتماعي والتاريخي في نظر كتاب هذه المرحلة هو الذي يغذي وينمي الصدق الفني. "ويتيح له الرؤية العميقة، والمضمون المؤثر الفعال"(32).
مع أن الأدب مهما زعم الزاعمون حول مفهومه ورسالته ووظيفته يظل جنساً ينتمي إلى الفن قبل كل شيء، والفن في أدنى مفهوم له يظل محتفظاً بطائفة من القيم الجمالية التي تضفي على الواقع سمة هي التي تكسبه في الحقيقة القدرة على التأثير في النفس. وهذه الانطوائية المضمونية هي التي جعلت فن القصة خلال المرحلة المذكورة يصنف ضمن الأدب الواقعي الحرفي، والذي كان أميناً للمرحلة، مما ولد نقداً مسايراً تمحورت رؤاه حول الطروح الاجتماعية الظرفية، فكان أن تواطأ- على الرغم من تواضعه- مع تلك الكتابات فلم يضايقها، أو يدخل معها في أسئلة الإبداع والنقد الحقيقيين.
وقد أرجع بعض الدارسين ذلك إلى أن الذين كانوا يمارسون الكتابة هم –أغلبهم- الذين مارسوا عملية النقد، مما أنتج تراكمات في الكتابات القصصية والنقدية تتقاطع جميعاً في محور الأدب والمجتمع وخطاباً ذا منظور إيحائي ضعيف، أسقط النص في تكرارية ونمطية "قللت من إنتاجيته الفنية نظراً لفقر الكتابة وعدم أصالتها وربما مدرسيتها"(33). وهذا كله حال دون تمثل –وبعمق- التجارب الفنية المتأصلة التي أثراها النقد الجديد وتلقفها كتاب القصة سواء في العالم العربي أو في غيره، فحتى التراث الذي هو امتداد للحاضر وقراءة في الماضي لم يستطيع كتاب القصة الجزائرية خلال هذه المرحلة امتصاصه على الرغم من إقبالهم عليه، "مما جعله عائقاً في وجه التقدم الفني لخلق لوحة جمالية معاصرة للواقع"(34).
كل هذا جعل فن القصة العربية في الجزائر بعد الاستقلال "خليطاً من القصص لا ملامح لها أو سمات تدل على اتجاه، أو اتجاهات واضحة وهذه الذبذبة بين أساليب مختلفة لا تعطي طابعاً خاصاً للقصة في مرحلة ما بعد الاستقلال"(35).
ب-ملامح القصة الثمانينية:
إن هذا المشهد الموحد للقصة الجزائرية خلال هذه الفترة التي تعرضت لها أو افتقارها إلى الخصوصية الفنية والاكتفاء بالبعد المضموني في أكثر الأحيان، هو ما جعلني أتلمس تجربة جديدة لكتاب جيل الثمانينات الذين –ومن خلال إطلاعي على بعض المجموعات القصصية وقصص منشورة بجرائد ومجلات وطنية- وجدت أنهم يمثلون تجربة جديدة مقارنة بمن سبقهم، ولعل ذلك لا يخلو من منطق فكري وثقافي، اتسمت به مرحلة هذا الجيل نشير إليها في الآتي:
1-فتور عنف المرحلة وتراجع محور المضمون:
إن القصة العربية الجزائرية في مرحلة ما قبل الثمانينيات كانت تعيش فضاءً متميزاً، طغى عليه عنف المضمون، ووظيفة الأدب، حتى غدا هم الكتاب الأوحد هو إخراج أعمالهم في ثوب اجتماعي سواء آمنوا بالفكرة أو لم يؤمنوا، يدفعهم في ذلك التشجيع الذي وجدوه من قبل وسائل النشر ذات التوجه الاجتماعي هي الأخرى حتى أننا أصبحنا أمام قصص هي مجرد بيانات سياسية، أو مقالات فكرية تعبر عن الواقع من خلال العام، دون أن تتوصل قبل ذلك أو من خلال ذلك إلى عقد صلة ما بين هذا العام، وبين الأجزاء، والمكونات الخاصة لهذا الواقع.
"فتصبح بذلك عاجزة عن إقناع غير المنتمين إلى نفس خط كتابها الفكري أو السياسي دون أن يتوافر فيها ذلك الإقناع الفني المفروض فيه أن يتوجه إلى كل الناس"(36). إلا أنه ومع بداية الثمانينات، ونتيجة التحولات الاجتماعية والفكرية التي شهدها العالم، وتقهقر الأنظمة الاشتراكية التي رسخت فكرها وأدبها عبر أنحاء العالم، بدأت الكتابات تتحرر من ربقة هذا التوجه سواء من قبل كتاب سبق لهم وأن تأثروا بهذا الاتجاه أو آخرين تمثلوا المرحلة الجديدة بكل محمولاتها الفكرية والجمالية، فراحوا يخوضون غمار التجريب على مستوى اللغة وتقنيات الكتابة القصصية، وقد تخلصوا من مضايقة المرحلة الأولى التي وحدت مضامين تلك الكتابات.
2-تطور مناهج العلوم وتأثيرها على الخطاب القصصي:
لا نشك لحظة في أن الجامعة الجزائرية قد أدت رسالتها الثقافية على الرغم من الانتقادات بحيث أسهمت في إثراء الدراسات الإنسانية، وإقحام مناهج حداثية كان لها الأثر الكبير في توسيع الرؤى والإقبال على النقد الجديد، وما يطرحه من طموحات في الميدان الفكري والإبداعي، ثم الاحتكاك بالقصة الجديدة أجنبية كانت، أم عربية، وهذا التحول الفكري والاجتماعي في نفس الوقت هو الذي أبرز جيلاً جديداً من القصاصين في تشكيل التجربة القصصية الحداثية بمحمولاتها المضمونية الجمالية وقد استطاعت هذه التجربة أن تؤسس لنفسها فضاءً فنياً لا يمكن تجاهله.
وهذا التحول يمثل –بحق- البعد الجمالي والتجريبي لقصة بدأت تخرج عن المألوف بحيث تخلصت من كثير من طروح سبقتها على المستويين، وتمكنت من توظيف رموز التجديد والحداثة، كما القصة المتطورة بعد اليوم، من تراث وأسطورة وغيرها إلى جانب تقنيات الكتابة الجديدة من سرد وحوار والتي لا يمكن للقصة الحديثة التخلي عنها للخروج من أسر الكلاسيكية.
3-تراجع النقد عن المفهوم السوسيولوجي:
يمكن إرجاع تحول القصة الثمانينية من المنظور الاجتماعي الموحد إلى التجريب على المستويات الفنية إلى تراجع النقد الجزائري عن دفاعه عن المضامين بعد اقتحام المناهج الحداثية عالم الكتابة والتنظير لخصوصيات الخطاب الأدبي، بحيث تخلص بعض النقاد العرب والذين يشكلون الخلفية الأيديولوجية لنقادنا الاجتماعيين من ذلك الهوس المتعلق بمضمون النص الأدبي، وهو ما يشير إليه حسين مروة حيث يقول:
"أنه لا بد أن أشير إلى خطأ شاب عملنا النقدي، وقد اعترفنا به أكثر من مرة، وهو أننا أولينا الجانب المضموني من العمل الأدبي الاهتمام الأكثر على حساب الجانب الفني"(37).
وهذا التحول في الخطاب النقدي المهيمن خلال فترة ما قبل الثمانينات هو الذي جعل القصة العربية في الجزائر تطمح إلى تمثل التجارب الفنية العربية والعالمية، بعيداً عن مضايقة النقد السوسيولوجي الذي بارك نصوصاً تفتقد إلى أدنى شروط الأدبية كونها تواطأت معه في التبشير لمضامين المرحلة. وعلى هذا بدأت التجربة القصصية الجديدة تتشكل حتى تؤسس لنفسها صوتها المتميز، وفضاءها الفني في خضم تحولات أدبية وفكرية مست عوالم الإبداع بشكل عام، وفن القصة بشكل خاص، وهذه الظروف الموضوعية التي سادت الحقبة الثقافية في الجزائر هي التي وجهت الأدب توجيهاً جديداً، وجعلته يقبل على مرحلة مختلفة من الكتابة.
ولذا لا نستغرب حين نجد أن فن القصة في هذه المرحلة قد أعاد تشكيل خطابه السلفي ليعانق فضاء التجريب ويمارس طقوس الإبداع بحرية تطفح بالرؤى التجاوزية والثورية على نمطية المضمون الكسيح الذي غدا عنواناً لفن القصة خلال عشريتين كاملتين. ولعل المعطيات نفسها بمعية الظروف التي أحاطت بالأديب، والتي أسهمت في هذا التحول هي التي تظهر جلياً من خلال الخطاب الأدبي لهذه المجموعات القصصية التي تعبر عن مرحلة أدبية في فن القصص، تتمرد على النمطية المعيارية، وتأخذ من اللغة البنية الأساس لإغناء التجربة الفنية.
ولا نخال دارس هذه المرحلة ينفي هذه الطروح، أو يتجاهل هذا التحول الملحوظ على مستوى اللغة والمضامين. فإذا كانت اللغة قد تخلصت من أسرها، ومن محدودية الدال، وأصبحت نسيجاً في فضاء سيميائي لا محدود، فإن المضمون هو الآخر قد تبنى جدلية عنف الطرح. ولم يعد أسير اللغة التي كانت رهينة مدلولات مرحلة تواطأ فيها –كما أسلفنا- المضمون في تشكيل خطاب موحد همه التبشير بأفكار موجهة إلى متلق كان هو الآخر أسير هذه الجدلية.
إن المضمون في هذه القصص الجديدة لم يعد مغلقاً يبدأ من عالم موحد ضيق الأفق، تحمله لغة لا تعدو أن تكون وسيطاً جافاً ثم تنتهي في قراءة موحدة هي الأخرى وذات مرجعية متصورة مسبقاً. لقد غدا هذا المضمون الجديد مساحة بقدر مساحة اللغة المتمردة على قوانين القاموس، تمرد على الإلزامية السلفية التي خنقت إبداعية القاص في المرحلة السابقة، وجعلته يتنكر لطبيعة الإبداع.
وهكذا جاء الخطاب القصصي الجديد ثائراً متحرراً من السكونية الماضوية وكأنه يريد أن يعانق الأرحب، وأن يتلمس روح الإنسان في جوهره لا في جانب، أو حيز صغير من ذاته ولعل اعتماده –الخطاب- على اللغة الجديدة التي تتخذ من الانزياح مرفأ لها، هو الذي زاد من عنفوانه. وعليه فالخطاب القصصي الجديد من خلال هذا الجيل من الكتاب يمكن اعتباره بنية مؤسسة لمرحلة أخرى في القصة العربية الجزائرية المعاصرة، تخرج عن سلطة النموذج إلى فاعلية التجريب والانفتاح، وتدمير الخطاب الأيديولوجي ذا الطبيعة الأحادية الدغمائية، فتتوحد فنياً لنمذجة حركة تحويلة تناهض الجاهز، وتطمح إلى فاعلية التأويل، بل إلى تدمير الميثاق السردي الكلاسيكي للوصول إلى زمن المغايرة والإدهاش، والقفز فوق الفصل بين الأجناس، أي إلى شعرية الخطاب القصصي.
"إن النقد المتحرر من مطاردة التفسيرات الخارجية التي تقدمها المعارف التاريخية والأخلاقية والنفسية والاجتماعية، والتركيز على قيمة العمل الجمالية"38- قد مس الحركة الأدبية الجزائرية بشكل عام، بعد أن أطر النقد الاجتماعي النص الإبداعي- النثري خاصة- فترة طويلة. ولعل تراجعه عن عنف الخطاب المضموني يعود –كما سبقت الإشارة- إلى تحولات فكرية واجتماعية مست الكتابة بشكل ملحوظ.
وفي خضم هذا التحرر من أسر هذا الاجتماعي المقنن، عاد كتاب القصة الجدد يفتحون آفاقاً واسعة للإبداع، بحيث تميزت القصة عندهم بعنف خطابي شمل المضمون والشكل في آن. فمن حيث المضامين ألفينا أغلب هذه الأعمال تتطرق إلى مواضيع جديدة ومتعددة مفتوحة على العالم والذات، فهي لا تتقيد بما استهلك من طروح عالجها أغلب كتاب المرحلة المتقدمة. بحيث نجدها مواضيع إنسانية تنأى عن المحلية الضيقة وتنشد عالماً أرحب تتقاسم فيه البشرية همومها، وقد تجلى ذلك في قصص محمد دحو وعلال سنقوقة، ومفتي بشير وكذلك حسين فيلالي.
ولعل المظهرية الفنية التي فتحت لهم المجال واسعاً في ذلك، هي ثورتهم على طروح الشكل والمضمون التي بنى عليها النقد السوسيولوجي أفكاره وإدراكهم أن النص الأدبي كل متكامل تسهم في تشكيله عدة معطيات، وبالتالي اكتسبت هذه الكتابات جرأة في الطرح لم تتوفر في سابقاتها من خلال بنائها الفني المتميز بالتجريب على مستويات اللغة وطرائف السرد.
إن مضامين هذه القصص الجديدة قد تطرقت إلى أصغر الجزئيات في حياة الناس والمجتمع ولكن ليس بتلك الطريقة الفجة التي توظف المباشرة، وسذاجة الطرح "بل إلى شعور المبدع أنه يعيش دائماً في حركة تدفعه إلى أن يكون دائماً غير ذاته وغير الآخرين"39-.
وقد يقودنا هذا التصور للعملية الإبداعية عن هذا الجيل إلى فهم جديد للشكل على خلاف مفهومه عند الجيل السابق فهو لم يعد مجرد لغة وجمل ذات إيقاع خاص، بل تعدى ذلك إلى تمرد على القاموسية اللفظية، وبالتالي تغيرت نظرتهم للكون، "فلم يعودوا ينظرون إليه من حيث هو مجموعة من الأشياء المخلوقة، بل أصبحوا على العكس ينظرون إليه من حيث هو مجموعة من الإشارات والرموز والصور، ولم يعد العالم مكتوباً في نص أصلي أولي بشكل نهائي، وإنما أصبح على العكس كتاباً يكتب باستمرار"40.
وبالتالي فالرؤية الإبداعية لهذا الجيل قد كونت قاموسها الخاص وأبجدية كتاباتها، بحيث قربت مفهوم الفن وطبيعة الإبداع ذاته إلى هذه الأعمال، فكان أن غيبت سلطة الواقع الذي كان يثقل النص بمحمولات فكرية وسياسية كثيرة. ولعل من مميزات النص القصصي الجديد على مستوى المضامين هو عنفها وتنوع مشاربها حتى أن الكتاب التفتوا إلى جزئيات صغيرة تهم الإنسان في عوالمه الداخلية، ولم يكتفوا برسم الظاهر وكأنهم أدركوا –وهذا مؤكد- "أن الفن ليس نسخاً للواقع، وليس نسخاً للطبيعة إنه إبداع في إطار علاقة جدلية بين الداخل والخارج بين التجربة الشخصية والمعطى الموضوعي، بين الخاص والعام، إنه إعادة إنتاج ذاتية كلياً لموضوع ليس ذاتياً كلياً"41-. وهي فلسفة دعمتها نظريات الأدب المتجددة التي حاولت الإبداع والفن عامة، بحيث لم يعد تعبيراً في فراغ، وهو ما يشير إليه بيلنسكي الذي يرى "أن الفن ليس ثمرة فراغ أو نزوة إنه يكلف الفنان عملاً وهو نفسه لا يعرف كيف تنشأ في روحه غرسة العمل الفني الجديد"42. وعليه "تبقي اللغة مرتبطة بالثقافة الإنسانية، وإن الحاجة الاتصالية هي السبب الحقيقي لإنتاجها"43.
إحالات:
1-عبد الله الركيبي –تطور النثر الجزائري الحديث- ليبيا 78 ص163.
2-ع الملك مرتاض- فنون النثر الأدبي في الجزائر –د.م.ج الجزائر 38 ص167.
3-ع الله الركيبي- القصة الجزائرية القصيرة. القاهرة 69 ص10.
4-المرجع ص36.
5-فنون النثر الأدبي في الجزائري ص174.
6-المرجع ص163.
7-ع الملك مرتاض –القصة الجزائرية المعاصرة الجزائر 90-7.
8-سالم الحديني –ملامح القصة القصيرة في الجزائر –الأقلام عدد 7 ص30.
9-ينظر أحمد طالب الالتزام في القصة الجزائرية المعاصرة د.م.ج الجزائر 89
ص35.
10-المرجع ص36.
11-القصة الجزائرية القصيرة ص19.
12-الالتزام في القصة الجزائرية المعاصرة ص45.
13-تطور النثر الجزائري الحديث ص172.
14-المرجع ص167.
15-القصة الجزائرية القصيرة ص47.
16-فنون النثر الأدبي في الجزائري ص175.
17-تطور النثر الجزائري الحديث ص170.
18-عمر بن قينة –المسار النضالي في القصة الجزائرية –الحياة الثقافية تونس عدد 32، ص109.
19-محمد مصائف: القصة القصيرة العربية الجزائرية في عهد الاستقلال. الجزائر 82، ص97.
20-المرجع ص15.
21-المرجع ص12-13.
22-المرجع ص95.
23-محمد ساري –البحث عن النقد الجديد. دار الحداثة بيروت 84، ص119.
24-هذه مقدمة جاءت متصدرة روايته المعروفة "اللاز".
25-القصة الجزائرية المعاصرة ص 414.
26-المرجع ص19.
27-يظهر ذلك في بعض كتابات الأعرج واسيني، وعمار بلحسن وحتى عرعار محمد العالي.
28-تطور النثر الجزائري الحديث ص179-180.
29-البحث عن النقد الأدبي الجديد. ص72.
30-الأعرج واسيني- اتجاهات الرواية العربية في الجزائر، الجزائر 86، ص337.
31-أسئلة الإبداع في الأدب العربي المعاصر ص47.
32-محمود أمين العالم ملاحظات حول نظرية الأدب. الجزائر
33-عمار بلحسن –الرواية والتاريخ في الجزائر. التبين عدد 7 ص105.
34-الالتزام في القصة القصيرة الجزائرية المعاصرة ص42.
35-تطور النثر الجزائري الحديث ص178.
36-انظر بول شاوول –علامات من الثقافة المغربية الحديثة بيروت 79، ص88.
37-فاطمة أزرويل –مفاهيم نقد الرواية المغربية ص74، حوار مع حسين مروة بجريدة الاتحاد الاشتراكي فبراير 84.
38-إبراهيم حمادة. مقالات في النقد الأدبي. القاهرة 882، ص65.
39-أدونيس –الثابت والمتحول- صدمة الحداثة- بيروت 79، ص266.
40-المرجع ص 267.
41-انظر محمد شفيق شيا –في الأدب الفلسفي لبنان 86، ص49.
42-بيلنسكي –الممارسة النقدية- ترجمة فؤاد مرعي ومالك صقور بيروت 82، ص24.
43- Claude Norman –avant saussure ص132.
أولاً : في مفهوم السرد:
يذهب عبد الملك مرتاض إلى أن أصل السرد في اللغة العربية هو التتابع الماضي على سيرة واحدة وسرد الحديث والقراءة من هذا المنطلق الاشتقاقي، ثم أصبح السرد يطلق في الأعمال القصصية على كل ما خالف الحوار، ثم لم يلبث أن تطور مفهوم السرد على أيامنا هذه في الغرب إلى معنى اصطلاحي أهم، وأشمل بحيث أصبح يطلق على النص الحكائي، أو الروائي أو القصصي برمته، فكأنه الطريقة التي يختارها الراوي أو القاص، أو حتى المبدع الشعبي ليقدم بها الحدث إلى المتلقي، فكان السرد إذن نسيج الكلام، ولكن في صورة حكي"(1)
ولقد تطور هذا المفهوم مع الكتابات النثرية الجديدة مدعوماً بطروح النقد الحداثي فكانت القصة أقرب الأجناس الأدبية لتمثل هذه التقنية خاصة مع تغيير نظرة كتابها في التعامل مع اللغة، وزمن الحدث، وفضاء الحكي "فإن كانت السردية في مفهومها التقليدي تعني وظيفة يؤديها السارد ويقوم بها وفق أنظمة لغوية، ورمزية فإنها قد اتخذت مفهوماً واسعاً ومغايرا يتصل بعلاقة السارد بالمسرود له، وبالشخصيات الساردة"(2).
ويعني ذلك تقنية جديدة قد غزت الكتابات النثرية القصصية بحيث لم يعد يستهويها ذلك السرد التقليدي الذي يشرع في وصف لديكور مألوف وعادي، وصف يبعث في القارئ الاطمئنان دون أن يصدمه"(3).
ولعل مشهدية الخطاب الحديث كان من الروافد التي عمقت المفهوم الجمالي للنص القصصي، وأضفت عليه أبعاداً فنية أخرجته من أسر التقليدية الصورية التي حكمت منطق الحكي، وأرغمته على السير في منظور كلاسيكي، ولم تعمق، بل ولم تولي خصوصيات عناصر القصة من حدث وزمان وشخصيات أي اهتمام، وهذه العناصر قد أضحت انفتاحية ومفتوحة في آن واحد على بنيات عدة من منظور السردانية الحديثة.
ثانياً البنية السردية في الخطاب القصصي الجديد:
لا يمكن فصل، أو تجزئة علاقة اللغة بالسرد الذي هو خطاب شفوي، أو مكتوب "يحكي قصة تتشكل من مجموعة الأحداث المروية (4). فحين أشرنا إلى أن اللغة في الخطاب القصصي الجديد، قد تجاوزت بعدها القاموسي وأضحت تحاور أبعادها السيميائية لتشكل فضاءها الجمالي التأويلي، فإن ذلك يعني أنها أصبحت تؤسس بهذا الانقلاب، أو تولد بنيات جديدة على مستوى تشكيل النص القصصي، أقلها، تكسير عمودية السرد التقليدي الذي كان يتعامل مع لغة تبدو محنطة لا تسمح له ببسط ظلاله كما يشاء وبالتالي فالتفاعل بين اللغة الجديدة وحداثة السرد يظهر قوياً.
وسنحاول أن نظهر ذلك من خلال نصوص قصصية نبين من خلالها هذه الخصوصيات كاسبعاد ظاهرة الوصف المثقلة التي لا تترك المجال للسرد كفاعلية حكائية خاصة إذا علمنا أن الزمن يتحرر مع السرد بمفهومه الحديث ولم يعد ذلك الزمن التقليدي الدال على الأزمنة النحوية، وقد تجلى ذلك في أكثر قصص جمال فوغالي، ومحمد دحو وخليفة قرطي، ففي "الجفاف" لدحو نقرأ.
"وبينما أنا في أحد الليالي المقمرة، الهادئة، مستلق على فراشي مرت أمامي أشباح فاهتززت سمعت صوتا يجئ من بعيد، كان عذباً، وكان جميلاً، فقمت، ومشيت محترسا حتى إذا اقتربت من شجرة ضخمة، ارتفعت دقات قلبي، ولشد ما كانت دهشتي عظيمة حين لاح لي من هناك شيء لم أتبينه جيداً"(5).
يبدو السارد هنا يتجنب الوصف قدر الإمكان، فعدا بعض الكلمات الواصفة- المقمرة- الهادئة- ضخمة- وهي أوصاف لم تؤثر على مسار انفتاح السرد. نجد النص مغموراً بروح الحكاية، وقد تقمص الكاتب شخصيته القصصية ليكون أكثر تحرراً في توليد الأحداث، كما أن للأفعال، وانتظامها عبر عملية تركيبية لتشكيل هذا الخطاب دوراً فعالاً بدءاً بالزمنية التي تماثل لفظة بينما وانتهاء بالأفعال الدالة على الحركة والإدهاش، "وهي أفعال كما يظهر ليست محكومة بمنطق خارجي كالذي نجده- عادة- في الخطاب التقليدي"(6) حيث ترتبط كما أشرنا بمنطق الحكي الزمني كما يظهر:
مرت ......
اهتززت .....
قمت ........
مشيت ........
ارتفعت ........
لاح ..........
وبالتالي خلصت هذه الأفعال المسار السردي من الوصف، وحررت وجهه الزمني ليلج لعبة التداخل، هذه اللعبة التي تنتج بمعية السرد عالماً زمنياً جديداً يكسر البناء الخطي للسرد الكلاسيكي الذي سيطر على البنية اللغوية للخطاب القصصي السابق، بحيث كان على الكاتب التعبير عن الهدف والفكرة فقط.
إلا أن روح الإبداعية، والتحرر من الثقل الإلزامي قد أدى بالقصاصين الجدد إلى تجريب إمكانيات اللغة السردية للوصول بأعمالهم إلى روح الأدبية، فكان أن جربوا تقنيات السرد التي تضمن للنص انفتاحيته من حيث الزمن والخطاب.
ولعل المقطع القصصي السابق "لمحمد دحو" ليقوم على ما يسمى بالانقطاعات وانتقاء المقاطع، والمشاهد، فنحن لا نحس ونحن نقرأه بذلك الترتيب الزمني التقليدي، أو بتلك النمطية الذهنية في تتبع الحدث على غرار القصة التقليدية.
"بل يفاجئنا في سرده للحدث بفوضى الترتيب"(7) وهي الرؤية نفسها التي نجدها عند خليفة قرطي في "عيناها والرصيف" يقول:
"والآن تمسكين بذاكرتي، وتحولين عينيك عن هذا الوجه المعفر بصمت الأولياء، وحكمة المغفلين، وتدسين الصدر المحترق لهفة في الغياهب، كانت رحلة، وحينما حملتك الأقدار، كان عناق الأطفال كالصفصاف، كالجراح، كوادي والآن تشقين صدري لتتنفسي فيه ما تجرعت من سنين الرماد"(8).
وهذه الخطاطة تظهر تباين المسار السردي بين القصة الجديدة والقصة الكلاسيكية.
القصة الجديدة (الحدث) القصة الكلاسيكية (الحدث
البنية السردية البنية السردية
زمن حدث عمودية السرد
حدث زمن
= انفتاح النص = انغلاق النص
من خلال هذا الشكل يمكن الوصول إلى أن القصتين، وبدرجة أقوى "عيناها والرصيف" قد تعددت فيها أشكال السرد ولم تخضع لنموذج قار، بدءاً من تعدد الضمائر التي تجعل النص متحرراً، فالقصة تنفتح على الضمير –أنا- ترحل طبلتاي إلى عالمها .. أنتظر الماء و…"(9)، حيث السارد يتقمص في فترة قصيرة البداية الاستهلالية ليتحول المسار السردي إلى المخاطب". والآن تمسكين بذاكرتي.."(11).
ولا يستمر المشهد ثابتاً حتى يتقمص السارد شخصية أبي زيد الهلالي في بقية القصة ليمارس معه تقنية السرد الرؤية المصاحبة – vision avec، وهي تقنية حديثة حيث السارد لا يفرض سلطته القهرية على بطله، أو أبطاله كما في القصة التقليدية، فهو يساويه في تشكيل الحدث، وهذه التقنية يوظفها خليفة قرطي ببراعة، حيث لا نحس بتلك النمطية التي تغيب الشخصية، وتفتح المجال لصوت السارد وحده.
ففي قصتيه "عيناها والرغيف" و"النافذة الثالثة"، نجد أن نهايتهما تلتحمان في سرد تكثيفي، يعود من خلاله دائماً إلى الحاضر، فتنتهي القصة بتداخل الأزمنة، وبتنوع السرد وهي التقنية نفسها التي نجدها عند جمال فوغالي في قصتيه "حلم الهزيع الأخير" و"اعترافات لامرأة من ضياء"(10) وكذلك عند يوسف سعداني في "عودة المهدي"(11).
ولعل الملاحظ في هذه القصص، هو أن السرد يبدأ عبر نقطة ضيقة، وغالباً مع الضمير- أنا- ثم يتنوع مع تنوع الضمائر مما يمد الحدث بانفتاحية أكبر، يعود السارد إلى نقطة البداية، وهكذا.. وهذه الخطاطة تبين ما ذهبنا إليه.
الماضي أنا (المتكلم)
العودة أنت (المخاطب)
تداخل الأزمنة السردية
وذلك لأن كل سارد يفترض بداية، وتلاحقا في الأفعال أي تغييرا واختلافا، وكل تغيير يشكل سلسلة جديدة في السرد، بحيث أن كل فعل يتبع سابقه، وغالباً ما يدخل معه في علاقة السببية(12).
ولعل تنوع البنية السردية، وتمردها على المنطق الخارجي الذ