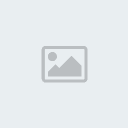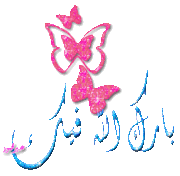إنّ النهوض بالخطاب الشعري بمحاصرة إبداعيته في خصوصيتها واستثنائيتها استقبالاً وقراءة، يمثّل حقلاً خصباً للمماثلة والاختلاف. سواء تعلّق الأمر بأبجديات الثقافة الشفاهية التي تعتمد فهم إحساس البساطة والمشابهة، وتتبنّى الجزئية في تذوّق المسموع والانفعال به والحكم عليه. أو كان الأمر أبعد تعلقاً بقراءات أكثر ارتقاءً وتحولاً وشمولية ومعرفة، تتباين فيها آراء النقّاد ورؤاهم في كيفيات عرض القضايا بالبحث والنظر.
وكان مصطلح (الطبع والصنعة) بمدلولاته المتعدّدة والمتشابكة، مكوّناً رئيساً لإبداع الكتابة الشعرية بأشكالها وتنوّعاتها، على الرغم من مرجعيته التراثية التي تشكّل فيها وعلى ضوئها، والتي كادت أن تجعله منغلقاً على تصوّرات ضيقة ومحدودة وغير قابلة للتطور والتوسّع والانتشار. في حين أنّ مناهج النقد ـ فضلاً عن المباحث التراثية ـ غير منفصلة تماماً عمّا استقرّ عليه هذا المصطلح.
فقد ارتضى الشفاهيون والنقاد تسمية (الطبع والصنعة) في تذوق الشعر ومناقشة مشكلاته الجمالية والبلاغية والدلالية. وارتبط المصطلح بشفاهية الشعر وكتابيته. إذ إنّ كلّ قضاياه انتسبت إلى الطبع والصنعة. إنّ المصطلح حقيقة عرفية ونقدية تعلّقت بالعادة (البسيط والسهل) وخرق العادة (خروج عن المألوف بانتفاء فاعلية القائم). لهذا كان الطبع هو الأصل الذي لا غنى عنه في تأليف الشعر، إنّه لا نهائي، قوامه الحركة المطلقة. وهو العلامة التي تعرف بها الأشياء وتحدّد والحالة الأولى لتثبيت الأحاسيس الفطرية الأولية. خاصّة إذا غاب فيه الجهد والوعي والاختيار. أمّا الصنعة التي هي فرع نهائي (بشري)، فإنّها مصطلح ارتبط بالإرادة الفاعلة وتمكّن الإتقان وتأسيس الشيء وبنائه. إنّه مصطلح التحكّم والإجادة والجهد والذكاء والفطنة ومحاولات الكشف عن حقائق الأمور، مع أنّه في القرآن الكريم، يعني الوحي من الخالق الموحّد والمطلق، مضافاً إليه عمل الشيء بإحكام. وهذا المصطلح تجسّده حضارة الإنسان ونوعيتها في كيفية الممارسة المنظّمة. إنّ الصنعة إنتاج دائم، بينما ينطوي (المصنوع) على عدم القدرة (مُنافٍ للطبع)، وهو كذلك المنتحل الموضوع. إن التخلّي عن المصنوع يعني طلب المطبوع.
وحصر الطبع في الأثر الزمني وبعده، يفتح المجال واسعاً لسلطان الغيبي بخرافاته وجنّه وشياطينه وآلهته. فإنّ هذا المقياس لا يضطلع بمفهوم الإبداعية. أمّا تطوّر الطبع، فإنّه يفهم منه أنّه جهد إنساني ينمو ويتشكّل. وتأتي الصنعة لتوسع من آفاقه. لذا وجب أن يتمّ اللقاء بين النشأة (الطبع) والتكوين (الصنعة)، لمحو التعارض الذي استبدّ بكثير من آراء النقد التراثي. لهذا لابدّ من تطوير هذه الهبة الإلهية غير الخرافية، التي ميّز الله تعالى بها بشره من سائر مخلوقاته. ومع ذلك، فإنّه يتحتّم الإقرار بانّ البدوي مفارق في طبعه للحضري. بيد أنّ هذا لا يمنع القول إنّ بحوث النقّاد التراثيين في مصطلح (الطبع والصنعة)، تنمّ في مجموعها عن قراءة للشعر مؤسّسة على نوعية تذوقه والإحساس به والرغبة في فهمه ومعرفته. ولو أنّ هذه المباحث، على اختلاف مناهلها، لم ينتظمها منهج يوصلها إلى الحقيقة الشعرية بشكل دقيق، لاضطرابها في تحديد أبعاد المصطلح ووظيفته. وفي قراءات المناهج النقدية الحديثة اتضحت كثيراً معالم المصطلح في علائقه بهوية الخطاب الشعري، ولاسيما في إسهامات المباحث النفسية والاجتماعية والبنيوية والأسلوبية، التي قوضت تلقائياً التصورات القديمة في تثبيت العادة، لاستنادها إلى تجارب ثرية في تشكيل رؤية القراءة والتلقي.