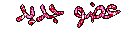مفهوم التنـاص
منذ سنوات خلت عرف النقد الأدبي دخول مصطلح جديد إلى رحاب النقد الأدبي، إنه مصطلح "التناص". وقد عمل به، وبالاشتغال عليه جماعة "تيل ـ كيل" الأدبية. وأول من استعمل مفهوم التناص هو الناقدة جوليا كريستيفا، وذلك في أبحاثها التي نشرتها سنة 1966 و1968 في المجلة المذكورة أعلاه وفي مجلة "نقد"، وقد نشرت فيما بعد في كتابيها "التحليل الدلالي" و"نص الرواية" وكذلك في التقديم الذي صدرت به كتاب باختين " شعرية دوستيوفسكي" هذا المصطلح أظهرته الناقدة للوجود بإدماجه داخل إشكالية الإنتاجية النصية، وبإدماجه مع كلمة إيديولوجيم، ورغم بعده المعرفي قد طغى استعمال التناص عليه رغم أهميته. ويرجع الفضل في ظهور التناص إلى استفادة الناقدة من ذلك الإرث النظري الذي خلفه باختين، رغم عدم استعماله لمصطلح التناص بشكل واضح في كتابه "الماركسية وفلسفة اللغة". وهذا الكتاب سمح لباختين بأن يتفحص أسرار الكلام الإنساني، حيث يشير فيه إلى أن الذات الإنسانية هي كائن حواري إلى حد بعيد وأنها تتحاور باستمرار مع الآخر حتى في لحظات الصمت على أن الكلمة التي تتلفظ بها الذات ليست ملكا خاصا بها. فالخطاب له خصوصيته مثلما أن له طابعه العام. ويمكن أن نجد صداه فيما هو اجتماعي وما هو سجالي وما هو سياسي وما هو تاريخي . فاللغة تصبح ملفوظا، وتدخل في فضاء ينفلت من قدرة اللساني. وتصبح منظمة تبعا لنظام سيميائي، أو براغراماتي أو تناصي بالضرورة من منظور كريستيفا فاللفظ له حركة تواصلية.
«إذا كان هذا المصطلح غائبا عند باختين فلأنه لا كلمة ولا فكرة "النص" ـ بوصفها ممارسة سيميائية "تصنع عبر الكلام كحتمية" مع درجات هذا النص ـ تعتبر متوافقة مع الفلسفة الجمالية عنده، في الشباب، وفي مرحلة الشيخوخة. وعلى العكس من ذلك، نجد المشكل الاستيطيقي عند باختين يطرح في اللغة، وحول العلامة»(1) ، إلا أن باختين قد تناوله بصيغة أخرى وهو يتناول الشكل الحواري، حيث كان يشير إلى أن موضوع الكلام كيفما كان، قد قيل من قبل بصورة أو بأخرى. ويؤكد بذلك على حتمية التناص، كما تطرحه جوليا كريستيفا. يرى تودروف أن باختين يعتبر هذا البعد الحواري في الكلام، ضروريا وأساسيا في جميع أنواع الخطاب. «فالكلمة أو المصطلح الذي يستعمله ليعين هذه العلاقة لكل ملفوظ بالملفوظات الأخرى، هي الحوار...» (2).
تشكل الحوارية مع باختين بهذا المعنى تلك العلاقة بين خطاب الآخر وخطاب الأنا، حيث يرى أنه لا يوجد إنسان خارج المجتمع، فولادة الإنسان البيولوجية ليست كافية لتحديد شخصيته الإنسانية بل ما يلزمها ولادته الثانية كجزء ضمن المجموعة الاجتماعية. وهذا المصطلح عند باختين يطابق مصطلح "التفاعل اللفظي"، الذي يشكل حقيقة الحوار باعتباره أهم أشكال "التفاعل اللفظي". كما أنه يرى أن التوجه الحواري هو ظاهرة مميزة لكل خطاب، يهدف إلى الالتقاء بخطاب الآخر، قصد الوصول إلى الدلالة وتحديد معنى معين.
نلاحظ أن جوليا كريستيفا قد سارت في نفس اتجاه باختين، إلا أنها استبدلت مصطلح الحوارية بالتناص. هذا المصطلح الذي عرف امتدادا واتساعا على الساحة النقدية، وما زال إلى يومنا هذا، يعتبر عند الناقدة أحد مميزات النص الأساسية التي تعمل على إبراز تلك العلاقة التواصلية بين النصوص السابقة واللاحقة. وقبل أن نعرف بهذا المصطلح، يجب الإشارة إلى أنه إذا كان باختين قد أدخل هذا المصطلح إلى نظرية الأدب بحواريته، فإنه مع جوليا كريستيفا قد سار في اتجاه موسع نظرا لاختلاف المرحلة المعرفية التي طرحته هي فيها بإضافتها له حوارا منتجا يتمثل في الماركسية والتحليل النفسي مع فرويد ولاكان.
يجب الإشارة إلى أن ظهور الشكلانيين الروس، كان محفزا لظهور مجموعة من التصورات المغايرة في حقل النظرية الأدبية. فشلوفسكي يرى «أن العمل الفني يدرك في علاقته بالأعمال الفنية الأخرى، وبالاستناد إلى مختلف الارتباطات التي تقيمها فيما بينها»(3). ومع مجيء باختين الذي سيعلن قطيعة إبستمولوجية مع الشكلانيين، سيدعو إلى الحوارية، التي يخص بها الرواية، فيما سيصمت جاكوبسون كلية عن التداخل النصي في شعريته الخاصة بالنصوص الشعرية ذات الصوت المفرد(4). فالمهتمين بالشعرية والسيميائيات الذين تناولوا هذا المصطلح المرتبط بالنص، انطلقوا من النظرية الأدبية عند شلوفسكي، أو من فلسفة اللغة عند باختين باعتبارها أولى المجهودات التي شكلـت اقتراحات نظرية هامة في تناول النص شعـريا كان أو روائيا. « فباختين هو من الأوائل الذي غيروا التقطيع الثابت للنصوص بنماذج، حيث لا توجد البنية الأدبية، وإنما حيث تتأسس في علاقة مع بنية أخرى. ولا تكون هذه الدينامية البنيوية ممكنة إلا انطلاقا من مفهمة تشكل "الكلمة الأدبية" تبعا لها، ليس نقطة (معنى ثابت)، وإنما تقاطعا لمساحات نصية يعني حوارا لمجموعة من الكتابات: للكاتب، وللمرسل (أو الشخصية)، للسياق الثقافي الحالي أو السابق»(5). وبتعبير أوضح ستكون «الحوارية هي ذلك المصطلح الذي يعين هذا الانتماء المزدوج للخطاب إلى "أنا" وإلى "الآخر". وهذا هو ما سيحققه التحليل النفسي بإحاطة علمية، هذا التصنيف للذات في علاقتها بكنز الدوال»(6). ترى جوليا كريستيفا أن عمل باختين يضعها على حافة نظرية للدلالة، التي سوف تحتاج إلى نظرية للذات لتأكيدها.
لقد عملت جوليا كريستيفا من هذا المنطلق على توسيع مجال هذا المصطلح الباختيني الأصل، كملازم للغة، بما أنه يفترض نمطا جديدا للقراءة والتأويل مرتبط بمفهوم النص. ويطرح هذا المصطلح معه مفهمة جديدة للكتابة والقراءة، في ارتباط بالتاريخ الأدبي، وبالتالي يصبح الحركة التي من خلالها يعيد النص كتابة آخر في حالة غياب. «إن أهمية مصطلح التناص لا تكمن في الكشف عن ظاهرة جديدة، بل في كونه يقترح طريقة جديدة لإدراك وتبني أشكالا من التقاطع البين أو المتضمن بين نصين»(7). وعلى غرار باختين تميز جوليا كريستيفا النص وعلى الخصوص النص الشعري، كممارسة تتحدد داخل وضعية أشمل هي وضعية النسق الشعري أو الثقافي. وعليه ترسم خطوط السفر نحو الجهات المحاصرة بتنوع الأسماء والممارسات ولا نهائية الجعرافيا والأزمنة الثقافية. فالشاعر وهو يتعرف على النص، يدرك أنه يعبر قرى وإيقاعات أخرى، قبل أن يأتي دوره ليمنح هذا السطح تلوينه الخاص. فكما تتمازج الأنغام لتشكل انسجاما موسيقيا، ودون أن ينتسب نغم معين لعازف ما، فكذلك تتداخل النصوص وأصوات الممارسين، وأصداؤهم في التجربة الفردية لكل شاعر.
ومن هذا المنظور، يبدو واضحا أن المدلول الشعري، لا يمكن أن تعتبره قائما من سنن وحيد، بل هو موقع لتقاطع مجموعة من السنن التي توجـد في علاقـة نفي الواحـد في علاقتـه بالآخر. وقد كشف دوسوسير في جناساته عن مشكل هذا التقاطع لمجموعات من الخطابات الغريبة داخل حقل اللغة الشعرية. وقد استطاعـت جولـيا كريستيفا أن تقيم انطلاقا من هذا التداخـل النصي، ومن مصطلح البراغـرام أو الجناسات عند دو سوسير، خاصية أساسية لاشتغال اللغة الشعرية وهي الجناسات التي تعني امتصاص عدد من النصوص أو من المعانـي داخل الرسالـة الشعريـة التي تتمثل كمركز لمعنى ما.
ندرك أن النص الشعري ككل، ينتج، عن حركة معقدة لإثبات نص آخر أو رفضه، حسب جوليا كريستيفا. وهذا التناص بإرجاع المدلول الشعري إلى مدلولات خطابية أخرى، هنا يتشكل القول الشعري باعتباره مجموعة صغرى من مجموعة كبرى هي فضاء النصوص . ويتشكل النص هنا كفسيفساء، يعني أن النص هو امتصاص وتحويل لنصوص أخرى. ومن هنا جاء تحديدها للنص «كجهاز عبر لساني يهدف الإخبار المباشر عن مختلف أنواع الملفوظات السابقة عليه أو المتزامنة معه»(8). ونفيد هنا أن كل نص، لا يولد مفردا، ولا يعيش وحيدا، فحياته رهينة بحيوات أخرى، وإلا يستحيل بقاؤه واستمراريته، وكذلك يرتبط وجود النص بتعالق مع نتاجات فكرية وفنية، وأقوال أخرى لمبدعين آخرين.
قدمت هذه المقاربة التناصية صياغة جديدة نظرية ـ تحليلية لمفهوم النص، تبحث في ملفوظات النصوص وعلاقاتها، ليصبح النص تحويلا. إذن مصطلح التناص هو مبدأ وصفي ومقولة نظرية عامة لتقرير حضور العالم المتبلور، في لغات ومفاهيم داخل النص، و« هو شرط لكل نص ولا يمكن أن يختزل إلى أصول النص، فهو حقل عام من الصياغات المجهولة، وهو دائما يكون في ارتباط بمفهوم النص والعكس صحيح.
« إن مصطلح التناص، يعين هذا التحويل لنسق واحد (أو عدة أنساق) للعلامات إلى آخر؛ لكن ما دام هذا المصطلح يدرك دائما في معناه الساذج، "كنقد لأصول" النص، فإننا نفضل عنه مصطلح التحويل الذي له الفضل في توضيح أن المرور من نسق دال إلى آخر، يستدعي تمفصلا نظريا جديدا للوضعية التلفظية والتقريرية»(9).
إذن، نقبل بأن كل ممارسة دالة هي حقل للتحويل لمختلف الأنساق الدالة، وأن مكان تلفظ هذه الممارسة وموضوعها ليس وحيدا وإنما هو متعدد ومتفجر قابل ليخلق نماذج جدولية. وهذا يجعلنا نتعامل مع النص كسيرورة بالانتقال من المحور الأفقي إلى المحور العمودي، والبحث عن الشفرات التي يقطعها إنتاج المعنى داخل النص باعتباره فضاء منفتحا على نصوص عدة. وهذا التفاعل بين النصوص يشكل عبورا محموما ينتج عبر عملية للهدم وإعادة البناء. ويظهر النص كهجرة للنصوص، وتطرح جوليا كريستيفا كما سبق وذكرنا مفهومي النقل والتكثيف عند فرويد، بالإضافة إلى مفهوم قابلية التصوير التي هي عناصر أساسية في عمل الحلم. ويوظف فرويد لتفسير الحلم وتحقيق هذه القابلية للتصوير، سيرورة التحويل. هذه الأخيرة هي ما تسمح للإجراء الدال من المرور من نسق من العلامات إلى آخر، بالتبادل والانتقال وبالتالي تشكل هذه القابلية للتصوير ـ كما سبق وذكرنا ـ تمفصلا نوعيا لنسق العلامات بين السيميائي والنظري. هذا المرور من نسق إلى آخر سيكون عبر وسيط غريزي مشترك بين النسقين، ليتمفصل نسق جديد.
إذن يصبح النص مجالا تحويليا، يفترض حوارا ووجود كتابات متعددة. ويطرح هنا جدلا بين النصوص ينفي الواحد الآخر أو يؤكده أو يرفضه. وهذا ما جعل جوليا كريستيفا تستعين بمفهوم السلبية والنفي عند هيغل، ليتشكل هذا الحوار كحوار منتج لدلالات متعددة ، وتحديد مفهوم السلبية وإدماجه داخل التحليل الدلالي وتبنيه، ليلتئم هذا الحوار داخل اللغة الشعرية، وتميز ثلاثة فئات من النفي:
« ـ النفي الكلي: وهو نفي متوالية أجنبية (جملة، مقطع، نص) مع قلب معنى النص المرجعي.
ـ النفي الموازي: وهو أن معنى المتواليتين هو نفسه، غير أن متوالية النص الثاني، تضيف معنى جديدا للنص المرجعي.
ـ النفي الجزئي: وفيه يقوم الشاعر بنفي جزئي من النص المرجعي»(10).
إذا كان أسلوب الحوار بين النصوص يندمج كل الاندماج بالنص الشعري إلى درجة يغدو معها ضروريا لولادة المعنى الجديد، فإنه بالنسبة للنصوص الشعرية الحداثية، وبدون مبالغة، قد أصبح قانونا جوهريا؛ تتم صياغة النصوص عبر امتصاص وعملية للهدم في شكل ارتباطات متناظرة ذات طابع خطابي.
إذن يعتمد فضاء النص عند جوليا كريستيفا على جملة من المرتكزات الأساسية أبرزها.
1 ـ المدلول الشعري الذي يحيل على مدلولات خطابية أخرى.
2 ـ الوحدات الدلالية التي تثير أنواعا من التأثير الدلالي حين توضع في سياقات
مختلفة.
3 ـ اعتبار النص امتصاصا أو تحويلا لغيره من النصوص.
4 ـ اعتبار النص ذا طبيعة تموجية ولا نهائية.
إن الأمر يتعلق عند جوليا كريستيفا بمقارنة أنواع من النصوص المختلفة. وسنحاول أن نبين كيف تتحقق داخل المدلول الشعري، تلك العلاقة صحيح / خطأ، إيجابي / سلبي، حقيقي / متخيل.
من جانب آخر ستحاول جوليا كريستيفا أن تتناول العلاقة المنطقية عادي / غير عادي، داخل النسق الدلالي للنص الشعري. وهكذا يبرز لنا فضاء جديد، تفكر من خلاله في الفاعلية الدالة، انطلاقا من هذه الخاصيات البنيوية: فضاء الكتابة الجناسية. هذا الفضاء التفاعلي الذي يحتفي بالذات في ارتباط مع فضاء الذات الهيغلية والفرويدية كما بينا ذلك سابقا.
هنا، تبدو فاعلية الرفض أو النفي، كعملية منطقية في أساس كل فاعلية رمزية، حيث يتمفصل الاشتغال الرمزي. ويبرز ذلك حين يتعلق الأمر بتصنيف للغة أو نمذجة لها. ويظهر النمط البنائي للنفي، وبالتالي نمط الاختلاف الذي يعمل ضمن الوحدات المشكلة لممارسة سيميائية. أيضا، نمط العلاقة الذي يحدد هذه الاختلافات هو ما يحدد خصوصية هذا النمط من الممارسة الدالة. ويبدو أن منطق الحكم هو ما يشكل منطق الكلام / الخطاب. «إن الأمر يتعلق بالنفي الذي يخرج من إطارات الملفوظ و/أو اللغة، ويقصد علاقة الذات بالخارج غير القابل للتوضيع: بدلا من النفي، إنه سلبية، ورفض يوجد عبر النفي اللساني والمنطقي»(11).
إذن، ستفحص جوليا كريستيفا المدلول الشعري، عبر منطق السلبية حيث سيتشكل هذا الفضاء، ويرتبط الوجود باللاوجود. وهذه المفهمة للوجود حيث يحضر الآخر، ويلعب دورا فاصلا، هي من المبادئ الهامة في النظرية الجمالية عند باختين. هذا الأخير يرى أنه من غير الممكن إدراك الكائـن خارج العلاقـات التي تربطه بالآخر. وتتميز سلبية المدلول الشعري عن
النفي كعملية داخلية للحكم. ونشير هنا إلى أن مفهوم السلبية توظفه جوليا كريستيفا مثلما هو عند هيغل، لتبين خصوصية النفي الشعري، «لينتج النص الشعري داخل حركة معقدة للتأكيد والنفي المتتالي لنص آخر»( ). وهكذا يضعنا التناص أمام كتابة ـ قراءة، تحكم منطق النص وتتحكم فيه بشكل لاواعي. وهذا المنطق التناصي لا يهدف إلى التجاوز، إنما إلى خلق انسجام داخل النص، مع تأكيده على فكرة القطيعة، كنمط للتحويل. وتطرح هنا إشكالية نموذج للغة الشعرية كفضاء لا منتهي الدلالات، وفي هذا الإطار نجد تحديد جوليا كريستيفا في كتابها "نص الرواية"، للأدب كخطاب يكشف عن نموذج للتناص، بالإضافة إلى فضاء بنيته الخاصة، فضاء نص غريب يغيره. كذلك سيسمح مصطلح التحويل الدياكروني بإضافة نموذج مولد، هو ميكانيزم التناص(12). ويبنى النص بشكل محوري باللعب على ما هو إيجابي وسلبي، وعلى نفس المحور السيميائي. يدرك المعنى كتواجد لمسلمة منطقية، محددة تاريخية، وتحويل بلاغي يعني الأدب. هذا الأخير، يعتبر هو القادر على تمثيل هذه الممارسة التي تجمع بين العلاقات اللاواعية والذاتية والاجتماعية. ونفهم التناص إذن كتفاعل نصي، ينتج من داخل نفس النص، وهو إشارة إلى الطريقة التي يقرأ بها النص التاريخ، ويندمج فيها، ويعطي الخاصية الأساسية لبنية نصية. وهذا التطبيق للأدب / النص يحرر الذات من تطابقها مع الخطاب الموصول، ويكسر تنظيمها كمرآة تعكس بنيات خارجية.
تشير جوليا كريستيفا إلى أن نمط النفي أو السلبية، وبالتالي نمط الاختلاف الذي يعمل ضمن الوحدات المشكلة لممارسة ما، وكذلك نمط العلاقة الذي يمفصل هذا الاختلاف، هو ما يحدد خصوصية نمط كل ممارسة سيميائية. فالمدلول الشعري، قد يحيل على مرجع ما أو لا يحيل فهو كائن ولا كائن، لأننا لا ندرك المدلول الشعري كإثبات. وهذا نعتبره شعرية، ولهذا نلاحظ أن سلبية المدلول الشعري تختلف عن النفي كعملية داخلية للحكم. فالشعر لا ينفي الحكم، أي ما يمكن أن يكون منطق الكلام، نفيا للنفي الممكن، أي نفيا ثانيا، إنما يقوم الشعر بقول التزامن الزمني والمكاني، للممكن واللاممكن وللواقع والمتخيل. وهذا يعني أن اللغة الشعرية توظف السلبية لأجل أن تحقق ذلك التوازن بين الممكن واللاممكن الذي يتحقق في الشعر.
إذن، انطلاقا من هذا المستوى من التحليل، ستعمل جوليا كريستيفا على تحليل موضوع الدلالة الشعرية كإنتاج لتنسيق نحوي للوحدات المعجمية باعتبارها وحدات دلالية أو تفاعلا من الكلمات، وكذلك كإنتاج لعملية مركبة ومتعددة الجوانب.
هذا التصور للغة الشعرية سيخصص من طابعها، بحيث إن بعض القوانين المنطقية التي تصلح للغة غير الشعرية، لا تجد مكانا في النص الشعري، كقانون التكرار. هذا القانون يكتسي طابعا آخر داخل اللغة الشعرية، فتكرار وحدة دلالية فيها لا يبقيها بمعناها الأولي، إنما تكتسب معنى آخر. ويمكن أن تشكل أثرا لمعنى شعري خالص. وبالتالي، يدرك النص الشعري نفسه كإنتاج للمعنى، ويلغي فكرة كونه وصفا، ويفترض أن اللغة الشعرية هي كلام، وهي كذلك موضوع لمنطق قائم على: 0 ـ 1 ونفي لذلك الكلام. وبهذا تنفلت من المنطق السابق الذي يخلصها من منطق التوزيعية، باعتبار عدم صلاحيته في اللغة الشعرية.
تميل جوليا كريستيفا في غياب أنماط منطقية خاصة بشكلنة اللغة الشعرية، إلى التخلي عن قانون التوزيعية، وتتبنى بنية ديدكايند DedeKind، المشتملة على المكملات الحق Ortho complements «إن هذا الحل يبدو لنا ملائما في شكلنة اللغة الشعرية، ما دامت الذات العارفة تفهم اللغة الشعرية دائما وحتما في إطار الكلام الذي ينتج هذه الذات، ولغتها الشعرية داخله وبالعلاقة مع منطق 0 ـ 1، الذي يفترضه ذلك الكلام. هكذا تبدو بنية المكملات الحق للغة الشعرية، وكأنها تصور هذه العلاقة بين المنطقي واللامنطقي، بين الواقعي واللاواقعي بين الكينونة واللاكينونة، بين الكلام واللاكلام، تلك العلاقة التي تسم الاشتغال الخصوصي للغة الشعرية الذي سيميناه كتابة جناسية»(13).
هذا التوضيح النظري البسيط، يحتاج إلى حقل موسع لنبين إمكاناته، وما يخفيه عند جوليا كريستيفا من بعد فلسفي وجمالي، وقد اكتفينا بإعطاء مفهوم مختزل للتناص ـ يكشف عن توجه جديد للكتابة، إذا أخذنا بعين الاعتبار النص وميكانيزمات تكونه ونشأته واتساعه. ويلاحظ أن هذا المصطلح قد خلق تحولا كبيرا في تاريخ الشعريات وأسس تاريخ الأدب وتاريخ الفكر أيضا، وخير دليل ما يقصـده ميشيل فوكـو في حفـريات المعرفة حيث يقول : « فحـدود كتـاب من الكتب ليست أبدا واضحة بما فيه الكفاية، وغير متميزة بدقة، فخلف العنوان والأسطر الأولى والكلمات الأخيرة، وخلف بنيته الداخلية وشكله الذي يضفي عليه نوعا من الاستقلالية والتميز، ثمة منظومة من الإحالات إلى كتب ونصوص وجمل أخرى»(14).
إذن، يبقى التناص رهينا بطبيعة قراءة المتلقي. فالشاعر يستمد أفكاره ومخزون الذاكرة، ويستقي القارئ مرجعيته من ذاكرته ومن معارفه المكتسبة. لكن إذا كانت جوليا كرسيتيفا تحاول أن تمركزه في عمق الفلسفة، فهل يعني ذلك أن كل عمل أدبي سواء كان شعرا أو نثرا هو ناتج عن عملية للنفي؟ وهل هذا النفي من الممكن أن يطرح علينا فكرة الإلغاء والبحث عن معاني ودلالات لا متناهية؟ ومن جانب آخر، ألا يمكن أن يسقطنا التناص في يوم من الأيام في تكرار مبتد ل للنصوص؟
*******
المراجــــع
1- في أصول الخطاب النقدي الجديد: ترجمة وتقديم أحمد المديني، مطبعة عيون، طبعة الثانية 1989، ص. 103.
2- T. Todorov, Principe Dialogique, Seuil 1981,p. 95.
3- Théorie des formalistes Russes, Coll TelQuel, Seuil Paris, 1965
4- R. Jakobson, Russie Folie poèsie, Coll poétique, Seuil Paris 1986.
5- Julia Kristeva, Semanalyse, , p. 83.
6 - BAKHTINE, Poétique de Dostoïvski, , p. 13.
7 - Nathaly Pigay-Gros, Introduction à l’intertextualité, Ed. Dunop. Paris 1996. p 8
8- Julia Kristeva, Sémanalyse, , p. 52.
9- Julia Kristeva, La Révolution du langage poétique, p.60.
10- Julia Kristeva, sémanalyse, p. 194-195.
11 - Julia Kristeva, La Révolution du langage poétique, p.115.
12 - Julia Kristeva, Sémanalyse, p. 196.
13- Julia Kristeva, Le texte du Roman, , p. 69
14- Julia Kristeva, Sémanalyse, p. 204.